خاص: قراءة – سماح عادل
نواصل القراءة في كتاب (علم النفس في القرن العشرین.. الجزء الأول) للكاتب “د. بدر الدين عامود”، والذي يعد مرجعا هاما في فهم مصطلح “علم النفس”.
في القسم الثاني يؤكد الكتاب على أنه ليس من باب الصدفة أن يكون عام ١٨٧٩ عام تأسيس مخبر فوندت، والأعوام التي تلته حتى مطلع القرن الحالي مرحلة انتشار الفكر الذي كان وراء هذا الحدث ومنه ظهور عشرات المخابر في العديد من بلدان العالم المتقدم، وإنما كان ذلك نتيجة حتمية ومباشرة للتطور العلمي والصناعي الذي شهدته أوربا والولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة الزمنية.

فقد وجد العلماء والمهتمون بالصناعة والمربون أنفسهم أمام ضرورة العناية بالإنسان والكشف عن قدراته واستعداداته والتعرف على قوانين نموه النفسي بهدف الارتقاء بالجوانب التي تضمن الحد اللازم من تكيفه مع نشاطه، وبالتالي زيادة مردودية هذا النشاط لصالح رأس المال.
فالطريقة التجريبية وما تقتضيه من أجهزة وتقنيات، وطريقة الملاحظة العلمية والوسائل الإحصائية والرياضية كانت سبيل العلماء والباحثين في الطب والفيزيولوجيا والعلوم الطبيعية والاجتماعية وسواها للحصول على المعطيات والمعلومات المتعلقة بمادة دراستهم وتحليلها وتفسيرها. ولقد دأب رواد علم النفس الأولون على الإفادة من ذلك كله، فكيفوا تلك الطرائق تبعاً لطبيعة الظاهرة النفسية وموقفهم منها، وصمموا الأدوات والأجهزة لدراستها، واتبعوا الوسائل العلمية والرياضية في معالجة ما كانوا يتوصلون إليه من معطيات حولها. ولم يقصروا عملهم هذا على موضوعات دون سواها، وإنما شملوا به جميع الجوانب النفسية بدءً من الإحساسات والإدراكات وانتهاء بالتفكير والانفعال عند الإنسان
والحيوان في شتى الأعمار والمراحل.
وبفضل الجهود التي بذلوها توضحت آنذاك حدود ميادين مختلفة لعلم النفس وظهر الكثير من فروعه، كعلم النفس التجريبي وعلم النفس النمائي والتربوي وعلم النفس المقارن وعلم النفس الحيواني، وعلم نفس العمل وعلم النفس المرضي وعلم النفس الفيزيولوجي.. الخ.
علم النفس التجريبي..
فوندت أثار لدى تلاميذه النزعة التجريبية. وهذا ما تجسد بوضوح في إقامتهم المخابر النفسية في أوطانهم بعد عودتهم إليها. فقد عرفت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوربية حتى نهاية القرن التاسع عشر ظهور عشرات المخابر النفسية. وتعكس هذه الظاهرة بحد ذاتها الميل القوي الذي أخذ يبديه الناس آنذاك نحو النشاط النفسي وتجلياته. كما أنها تعكس أمراً آخر أكثر أهمية على صعيد التقدم العلمي، يتمثل في نظرة المشتغلين في ميدان علم النفس إلى الظاهرة النفسية نظرة موضوعية باعتبارها تحدث في الزمان والمكان.
ولقد جاءت هذه النظرة لتحل محل النظرة القديمة التي ترى أن من غير الممكن إخضاع الظاهرة النفسية للدراسة بوصفها شيئاً يختلف عن بقية الظواهر اختلافاً جوهرياً. وربما رسخت النظرة الجديدة إلى النفس الاعتقاد بإمكانية قيام علم موضوعي يقف على قدم المساواة مع علوم الطبيعة، وشجعت أصحابها على إتباع الطرائق واستخدام الأدوات التي تستخدم في تلك العلوم.
هذه النظرة حملت أصحابها إلى استخدام التجربة في نشاطهم العلمي نظراً لما توفره للباحث من إمكانية ملاحظة الظاهرة السلوكية أكثر من مرة ضمن شروط معينة، ثابتة أو متغيرة، وفهم الأسباب والعوامل التي تقود إليها، ومعرفة النتائج التي تترتب عن حدوثها. وأصبحت المخابر النفسية مركز نشاط المهتمين بالعلم الجديد في العديد من بلدان العالم، ولا سيما في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيطاليا وانكلترا والدول الاسكندنافية.
ولقد تركزت أعمال العلماء والباحثين في تلك المخابر حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي سيكوفيزيولوجيا الإدراك والسيكوفيزياء والقياس النفسي. واستحوذ المحور الأول (سيكوفيزيولوجيا الإدراك) على جلّ اهتمام أولئك العلماء والباحثين، وحظي بنصيب وافر من أعمالهم. ولعله من اليسير أن يتلمس المرء أسباب ذلك. فمن خلال دراسة الإحساس والإدراك وقف العلماء قبل أن يصبح علم النفس علماً قائماً بذاته على تخوم الظاهرة النفسية، وحاولوا استجلاء طبيعتها وقوانين تكونها وتطورها بوسائل موضوعية، وأحياناً بلغة علومهم. وبذا مهدوا السبيل أمام علماء النفس لدراستها بنفس الوسائل، ولكن بلغة علمهم الناشئ.
ثم إن إفادتهم من التقنيات المستعملة في العلوم القريبة من علم النفس كالفيزيولوجيا والتشريح.. الخ وتوظيفها في دراسة موضوعات تلك المحاور رسخا لديهم الإيمان بجدوى عملهم، وموضوعية النتائج التي كانوا يتوصلون إليها.
ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الدراسات التي تناولت الوظائف الحسية بعيد استقلال علم النفس كانت استمراراً للدراسات التي أجريت قبله. فقد تتبع العلماء في مخبر فوندت، كما في غيره من المخابر، الظواهر الحسية المختلفة التي عني بدراستها كل من هيلمهولتز وموللر ودونديرس، حيث تولى كريشمان وتيتشز في ثمانينيات القرن التاسع عشر دراسة الإبصار المحيطي والمزدوج.
بينما تولى، في الوقت ذاته غ. أوبيرت وزميله أ. فولكمان دراسة ظاهرة التكيف البصري. وفي عام ١٨٩٤ تمكن فون كريس من عرض تصور كامل عن الأجسام المخروطية والأجسام الأسطوانية التي تدخل في بنية العين ودورها في عملية الإبصار. وهو، بهذا، يكمل اكتشاف شولتز لهذه الأجسام عام ١٨٦٦ الذي اعتمد على جملة من الوقائع التي كشف عنها تشريحه للعين عند الإنسان والحيوانات. وبفضل ذلك تبين له أن العين عند الحيوانات الليلية لا تملك إلا أجساماً أسطوانية، في حين أن العين عند الحيوانات الأخرى والإنسان مزودة، إضافة إلى ذلك، بأجسام مخروطية. وقاده ذلك إلى نتيجة مؤداها أن وظيفة الأجسام الأسطوانية هي الرؤية في ظروف العتمة والظلام. وأن الأجسام المخروطية تتولى مهمة الإبصار في ظروف الإضاءة. غير أن كريس لم يحدد الكيفية التي تتم بها رؤية الألوان، وهو ما كرس له ايوالد هيرينغ شطراً هاماً من نشاطه العلمي.
انطلق هيرينغ من الاعتقاد بأن شبكية العين تملك القدرة على رؤية المكان منذ البداية دون أن تخضع للتجربة والتدريب. ويرى أن كل نقطة فيها تحتوي على ثلاث إشارات موضعية تسمح بإدراك الأبعاد الثلاثة (الطول والعمق والارتفاع) بصرف النظر عن حركة العين. وواضح أن هذا الاعتقاد يخالف ما استخلصه هيلمهولتز من أن الرؤية هي نتاج نشاط العين.
والنقطة الثانية التي عالجها هيرينغ واختلف حولها مع هيلمهولتز تتعلق برؤية الألوان فقد افترض هيلمهولتز(ومن قبله يونغ)، وجود ثلاثة ألياف في كل عنصر من العناصر المختصة برؤية الألوان، وأن هذه الألياف يختص كل منها برؤية الألوان الثلاثة: الأحمر والأخضر والبنفسجي. وتتم رؤية الألوان الأخرى ومشتقاتها نتيجة إثارة هذه الألياف مجتمعة من قبل الأشعة المناسبة. ثم جاء هيرينغ ليقول بوجود عمليتي الهدم والبناء لبعض الأسس الكيميائية التي تثير الإحساس بالألوان الستة المزدوجة: الأبيض- الأسود، الأحمر- الأخضر، الأصفر- الأزرق كأساسٍ لرؤية الألوان. ففي عملية الهدم يظهر أحد الإحساسات، وفي عملية البناء يظهر إحساس آخر مناقض له. ويجد أن الألوان الأخرى تتم رؤيتها بفعل التجميع المتنوع للعمليات العصبية.
لقد تناولت النظريتان جانباً من الظاهرة المدروسة التي ظلت لأعوام طويلة موضوع اهتمام المشتغلين في هذا الميدان. وقاد ذلك إلى نشوء نظريات متعددة لم تتمكن من الصمود طويلاً أمام المعطيات التي مكنت من الحصول عليها الأجهزة الحديثة وما واكبها من تحسن في طرائق بحث العمليات البيوفيزيوكيميائية للمحلل البصري.
وبينما كان هؤلاء العلماء يواصلون بحوثهم في مجال الإحساس البصري، كان هناك علماء آخرون يبحثون في مجالات أخرى للإحساس، كالسمع واللمس وغيرهما. ففي عام ١٨٧٥ نشر ماخ مقالاً بعنوان “أساسيات في دراسة الإحساس بالحركة” عرض فيه نتائج سلسلة من التجارب التي خصصها لدراسة أثر وضعية الرأس في الإحساس بالمكان والصور اللاحقة الناجمة عن التغيرات التي تطرأ على تلك الوضعية. وفي الوقت ذاته كان كرمبرون وبروير يدرسان، كل لوحده، نفس الظاهرة سعياً وراء تقديم تفسير للعلاقة بين الأذن الداخلية والإحساس بالتوازن التي كشف عنها فلورنز من قبل. وتمكن الثلاثة من معرفة آليات عملية حفظ توازن الجسم البشري واختلاله. فقد وجدوا أن السائل الموجود في القنوات الهلالية هو المسؤول عن تلك العملية. فتحريك الرأس يؤدي إلى تحرك ذلك السائل، وهذا بدوره يؤثر في وضع شعيرات نهاية القنوات الهلالية مما يثير الأعصاب التي تنقل ذلك إلى المنطقة المختصة في الدماغ.
وخلال هذه الفترة كان علماء آخرون ينهضون بدراسة الإحساسات الأخرى ومن أشهرهم غولدشايدر وفري وبليكس ودونالدسون. فقد أماط هؤلاء اللثام عن تفاوت الإحساس الجلدي من مكان إلى آخر من الجسم وتنوع هذا الإحساس تبعاً لبنية الجلد. وكشفوا عن وجود أربعة أنواع من الإحساسات: الإحساس بالضغط، والإحساس بالألم، والإحساس بالحرارة، والإحساس بالبرودة. ولقد فتح هذا الاكتشاف الباب أمام العلماء لتطوير المعارف حول هذا الموضوع. يضاف إلى هذا الرصيد العلمي بحث تسوارد ماكر حول الإحساس الشمي والأعمال التي خصصها كيزوف لدراسة حاسة الذوق.
ومن جهة أخرى بقي زمن الرجع واحداً من الموضوعات التي استرعت- اهتمام السيكولوجيين في تلك المرحلة. فقد خلص الألماني لودفيغ لانج بعد سلسلة من التجارب إلى أن زمن الرجع يكون أطول في الاستجابات الحسية منه في الاستجابات العضلية. وعلل ذلك بأن الانتباه في الأولى يكون موجهاً نحو المثير، وفي الثانية يكون موجهاً نحو الحركة المزمع القيام بها. وتعكس هذه النتيجة اهتمام لانج بالدور الأساسي الذي يلعبه الانتباه في نشاط الفرد. وهو ما سعى العديد من العلماء لمعرفته فيما بعد. فقد كان زمن الرجع والانتباه المحور الرئيسي الذي أولاه كاتل عناية خاصة في الطور الأول من حياته العلمية.
ولدراسة هذا الموضوع صمم كاتل جهازاً لقياس الزمن الذي يستغرقه الفرد في الإدراك وتسمية الأشكال والصور والكلمات. ووجد أن حجم الانتباه عند البشر يصل في المتوسط إلى خمسة موضوعات. وظل كاتل يواصل بحوثه في الإدراك وزمن الرجع واعتبره، في وقت لاحق، سمة من السمات التي تميز الفرد عن غيره.
إن الوضعية التجريبية التي شرع علماء النفس نشاطهم من خلالها ذات أصول فيزيولوجية. فهي أعدت لدراسة الوقائع النفسية البسيطة، كالإدراك الحسي وسرعة الاستجابة التي تخضع للملاحظة الخارجية بقليل من الصعوبة. وبالطريقة ذاتها حاول فوندت وتلاميذه بحث الوظائف النفسية المعقدة. فبالنسبة لهم أصبحت رؤية الكلمة أو سماعها والاستجابة الظاهرية التي تستدعيها الموضوع الذي يجب أن يتناوله النشاط التجريبي. وهذا معناه إسقاط العمليات النفسية التي تحدث بين إدراك الكلمة والاستجابة عليها من حسابهم بدعوى عدم جدوى دراستها بالطريقة التجريبية.
وقد تصدى لهذا الزعم عالم النفس الألماني هيرمان ابنغهاوس حيث أخضع إحدى الوظائف النفسية المعقدة، وهي التذكر، للدراسة التجريبية، مدشناً بذلك عهداً جديداً في تاريخ علم النفس التجريبي. ومهما تكن طبيعة الملاحظات والانتقادات التي وجهت إلى ابنغهاوس فإن دوره الفعال في تطور المنهج التجريبي في علم النفس لا يرقى إليه شك. وهذا ما يشهد به “اختبار التكميل” لدراسة القدرات العقلية الذي وضعه بعد اختبار المقاطع عديمة المعنى لدراسة التذكر. ولقد حقق “اختبار التكميل” نجاحاً كبيراً ولقي انتشاراً واسعاً، وأصبح مصدراً للعديد من الاختبارات التي وضعها علماء النفس فيما بعد لقياس الذكاء. كما أن طريقته في دراسة التذكر فرضت نفسها كنموذج عني الباحثون عقوداً بمحاكاته وتحسينه.
ومن بين أولئك الباحثين ميوللر. في جامعة غوتينغن وتتلمذ جورج الياس ميوللر على يد لوتزه. وفي عام ١٨٨١ خلفه في كرسي الأستاذية، وصار مشرفاً على مخبر البحوث السيكولوجية في نفس الجامعة. وهو المخبر الذي كان يحتل المركز الثاني بعد مخبر فوندت. وبفضل دأب ميوللر ومواظبته على البحث وحرصه على المكانة التي يحتلها هذا المخبر استطاع أن يستقطب عدداً من الباحثين النشيطين، أمثال شومان ومارتن وبيلزكر وسبيرمان ويانيش وجامبل وغيرهم.
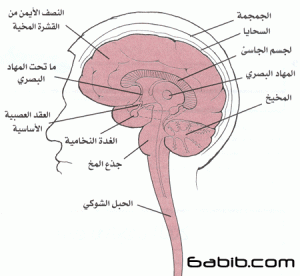
كان ميوللر ذا نزعة تجريبية وميل إلى العمل المخبري أكثر منه إلى الجانب النظري، مما جعل شخصيته العلمية قريبة من شخصية ابنغهاوس. وقد انصب نشاطه بصورة أساسية نحو معالجة مسائل السيكوفيزياء والتذكر. وله في هذين المجالين عدة مؤلفات وبحوث. وهو صاحب أحد أهم المراجع في سيكوفيزياء تلك الفترة، الذي صدر عام ١٨٧٨ تحت عنوان “أساس السيكوفيزياء”. أما في مجال التذكر فقد أدخل مع مساعديه تقنيات حديثة على طريقة ابنغهاوس، وتوصلوا عبر سلسلة من التجارب إلى وجود عوامل أخرى غير التي ذكرها ابنغهاوس، تؤثر في عملية التذكر. فتوفر الدافع الإيجابي لدى الفرد إزاء الموضوع يسرع من وتائر حفظه له ويطيل في أمد احتفاظه به وييسر استرجاعه له. وهذه النتيجة تتجاوز التفسير الآلي للعمليات العقلية الذي يميز النظرية الارتباطية. كما أن قراءة المادة كلها دفعة واحدة من أجل حفظها أفضل من تجزئتها وقراءة كل جزء لوحده. ومما لا شك فيه هو أن جميع هذه النتائج تصب في التيار المتنامي الذي يجسد النزعة نحو ربط النظرية بالتطبيق والبحث العلمي بالحياة.

