خاص: إعداد- سماح عادل
“فوزي كريم” شاعر، ناقد، روائي، فنان تشكيلي، باحث موسيقي عراقي، ولد في بغداد عام 1945، أكمل دراسته الجامعية فيها ثم هاجر إلى بيروت عام 1969. عاد إلى بغداد عام 1972، ثم غادرها ثانية عام 1978 إلى لندن.
مجموعته الأولى كانت بعنوان “حيث تبدأ الأشياء” 1968، وضع القصائد التي كتبها في بيروت في مجموعة “أرفع يدي احتجاجاً”، وصدرت عام1973. ترك كتباً أخرى أصدرها في بغداد: “من الغربة حتى وعي الغربة” 1972، “أدمون صبري” 1975، و”جنون من حجر” 1977، ثم هاجر إلى منفاه الجديد، لندن، آخر عام 1978. في سنوات هذا المنفى الطويلة تعمق في دراسة الموسيقى والكتابة في الشأن الموسيقي كما مارس فن الرسم، وضع كتابه “الفضائل الموسيقية” في أجزاء أربعة: عن “الموسيقى والشعر” 2002، و”الموسيقى والرسم”، “الموسيقى والفلسفة” و”الموسيقى والتصوف”، قيد الإعداد للنشر.
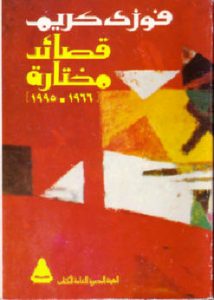
أما في الشعر فقد أصدر وهو في لندن: “عثرات الطائر” 1983، “مكائد آدم” 1991، “لا نرث الأرض” 1988، “قارات الأوبئة” 1995، “قصائد مختارة” 1995، “قصائد من جزيرة مهجورة” نشرت ضمن الأعمال الشعرية2000 التي صدرت في جزأين عام 2001، “السنوات اللقيطة” 2003، “آخر الغجر” 2005، “ليلُ أبي العلاء”. وفي النثر النقدي أصدر، قصص “مدينة النحاس” 1995، كتاب ” ثياب الإمبراطور: الشعر ومرايا الحداثة الخادعة” 2000، “العودة إلى گاردينيا” 2004، كتاب “يوميات نهاية الكابوس” 2004، كتاب “تهافت الستينيين: أهواء المثقف ومخاطر الفعل السياسي” 2006. وفي مجال النقد أصدر مجلته الفصلية “اللحظة الشعرية”.
بغدادي..
في حوار أجرته معه “اعتقال الطائي” يقول “فوزي كريم” عن نشأته: “أنا بغدادي النشأة. “الصاية” و”الچراوية” و”اليمني” عناصر ثابتة في زي أبي. ولكن محلتنا البغدادية كانت تستكين في طرف معزول نسبياً عن أحياء قلب بغداد التاريخية. “العباسية” جزء صغير من محلة “كرادة مريم”، قد لا تتجاوز بيوتها المئة إلا بقليل. لا تخلوا من طبيعة شبه ريفية: النخيل، وزراعة محلية للخضار، وصيد الأسماك. إلا أن معظم شبانها طلبة مدينيون وموظفو دولة. أبي كان يملك مركباً بخارياً مع حاملة نقل قبل ولادتي، ثم عاملاً في إدارة هذا المركب في سنوات بناء جسر الملكة عالية (جسر الجمهورية لاحقاً) في طفولتي، ثم بائع فاكهة وخضار في محلة العباسية، في سنوات صباي ومراهقتي. قبل سنوات استعدت هيئته في لوحة بورتريت زيتية ملحقة بهذا الحوار. أذكر أن الكتاب كان يحتل مكاناً في صباي، كنت أحرص على اقتناء كتب التراث وحدها، أقرأ واحتفي بعثراتي على أسطرها، وبعدم إدراكي لمراميها. كنت أحتفي بالصوت الموسيقي، الذي يصدر عن شفتي من بوحها ووحيها. وكانت محاكاتي لهذا الصوت المبهم في درس الإنشاء مصدر تندر من قبل طلبة الصف، في المدرسة، ومصدر معاتبة حانية من قبل مدرس العربية.. لم أكن عفريت أبناء جيلي. كنت على العكس موضع ثقة، وعلى شيء من السكينة. الكتاب الذي صرت أُقرن به كان أشبة بحاجز بيني وبين الآخرين!”.
وعن كتابة الشعر وبداية كتابته يواصل: “لا أذكر. المرحلة المبكرة تكاد تكون غائمة بفعل اختلاط المسعى الأدبي، الشعري، بالمسعى الفني: نحت، رسم، موسيقى. كنت شديد الولع بالتراث، كما قلت. ثم صرت أطلع على القصيدة الحديثة، التي تترك بياضاً آسراً في الصفحة لم تكن تحققه القصيدة العمودية. البياض يلغي الشكل الهندسي الذي يُقبل على العين بهيئة بلوكات حادة. القصيدة الحديثة بتفاوت أبياتها تمنح البياض فرصة لمزيد من التداخل، التساوق، والتعارض الشكلي. حين صرت أقلد القصيدة الحديثة كنت أباشر اللعب مع البياض. لم أكن أفهم الحرية الشعرية الجديدة إلا عبر الحرية البصرية. ثم أني صرت أتعامل مع الكلمة وصوتها، ولأول مرة، باعتبارها ذات قيمة في ذاتها. مستقلة مثل كوكب. كان هذا يتم بصورة جدْ بدائية بالتأكيد. حين جاء السياب، وكان أول الوافدين على صباي الشعري، حقق صلة الوصل السحرية بين الكلمة الشعرية وأختها، وبينها وبين خبرة كياني الداخلية. أكثر من مجموعة شعرية كتبت، بالشكل العمودي والشكل الجديد، قبل أن أجمع قصائد “حيث تبدأ الأشياء” وأنشرها عام 1968″.
وعن لبنان وسفره إليها يضيف: “بيروت، كانت تبدو لنا النافذة الوحيدة المضاءة، ولكن عن بعد. هناك تصدر مجلة الآداب، مجلة شعر، ثم مجلة مواقف الأدونيسية، نافذتنا على أدبنا العراقي والعربي والعالمي. وهناك الملاذ العربي الوحيد للهارب من قمع النظام العربي، وقمع الرقابة الفكرية العربية. وهناك كل ملامح الثورة الفلسطينية في مرحلة فتوتها. وهناك انتشت أسماؤنا كشعراء وكتاب، وتوزعت إلي العالم العربي. ومن هناك كانت تصلنا رسائل إعجاب حارة من شعراء وكتاب، كانت أسماؤهم ترتبط برياح الجديد والطليعي المنعشة. كنت قد عُينت مدرساً بعد تخرجي من كلية الآداب. وبالرغم من أن مذاق التدريس كان حلو الطعم، بعد مرحلة تلمذة طويلة، إلا أن مرارة حادة بدت تتسرب فيه، وتفسده. مرارة اقتحامات سلطة البعث واتحاده الوطني. وبالرغم من أني لم أُحسب على طرف سياسي، واكتفيت بصفة الشاعر الذي لا انتماء له، إلا أن ثانوية المحمودية لم تخل أسبوعاً من رجل أمن يقتحم الإدارة، محققاً بشأني. كنت أيامها قد أصدرت ديواني الأول “حيث تبدأ الأشياء”. وبهذا صرت موضع نظر من قبل مرحلة لم تترك حيزاً لكيان إنساني لا منتمٍ. بدا الأمر لي حينها مريعاً. وبدوت نبتة عارية من أية حماية في أرض بوار. كانت هجرتي محض فردية. وما كانت لي صلة تُذكر بأي فاعلية سياسية فلسطينية. وربما لهذا السبب بقيت طوال مرحلة المنفى البيروتي دون عمل محدد، غير الإسهامات النقدية والشعرية في مجلات: الآداب، شعر، مواقف، شؤون فلسطينية، الهدف، ملحق النهار (باسم مستعار هو نبيل توفيق).. في بيروت كتبت قصائد ظهرت في مجموعة “أرفع يدي احتجاجاً”. هذا الاحتجاج الذي ما كان له أن يتحقق لو كنت بقيت في بغداد. كان هذا الاحتجاج ينطلق من موقف أخلاقي ضد الشر، وجمالي ضد القبح، وميتا فيزيقي ضد القدر الأعمى. ولقد منحتني الحياة البيروتية الإحساس بمشروعية موقفي، بالرغم من أني كنت دائم الشك بقدرة، أو رغبة، مثقف المرحلة (المنتمي والملتزم) باستيعاب مشروعية هذا الموقف! ولقد أضفى هذا لوناً حاسماً على مشاعر اليتم والتشرد”.
جيل الستينات..
وعن الجيل الأدبي الذي ينتمي إليه يؤكد: “أنا ستيني بالتأكيد. على أنني من أصغر الستينيين عمراً. السبعينيون جاءوا في مرحلة مختلفة، جديدة، ومحددة. مرحلة حكم الحزب الواحد. ومرحلة المعارضة العقائدية الواحدة. أمر لم يكن لنا به عهد. نشأنا داخل مناخ تسويغ الحرية النسبية، المشوبة بالفوضى. هم نشأوا في مناخ تسويغ الرقابة، واعتقال العقل داخل العقيدة. تحدياتنا كانت لا تخلوا من عبث ضاحك. تحدياتهم لا عهد لها بالعبث، بل بالواجب الذي لا رغبة لهم فيه. الثقافة ازدهرت في مرحلتنا، ثم تواصل ازدهارها في سنوات مرحلتهم الأولى، إلي أن تمكن حزب السلطة الواحد من التحكم بمصير الأفكار والأفراد. حينها ذبلت المرحلة، وتحولت مع الأيام إلي رماد. في مرحلتنا ازدهرت أشكال التعبير الشعري، في شتى التوجهات، التي تعتمد الأصالة، أو النزعة الطليعية. وليس غريباً أن تجد كل الأشكال لدى شاعر واحد: قصيدة البحور الموروثة، قصيدة التفعيلة، القصيدة المدورة، القصيدة البصرية، قصيدة النثر…الخ. في مرحلتهم انسحبت القصيدة، بصورة ما، إلي شكل واحد، هو شكل قصيدة النثر مغلقة في الغالب. ولم يبدُ الأمر وليد إرادة طليقة، بل وليد نزعة هرب إلي شكل قادر أن يحيط الشاعر وإرادته، وحريته، وتطلعاته داخل عبوة مغلقة، ناسفة ولكن دون توقيت. المواقف النقدية النظرية تبعت الخطوات ذاتها. السبعينيون جيل أكثر تراجيدية من جيلنا بكثير.. الجيل الستيني حقق صراعا مثمراً بين عناصره المتعارضة: باتجاه المواصلة التاريخية لتطور القصيدة، واتجاه التزام القفزات. وكل من الاتجاهين كثير التنوع، وعميقة. إن صوتاً فاعلاً في الشعر والنثر لفاضل العزاوي، باتجاه الإيمان بالفكرة وحرية طفر المراحل، كان واضح الحضور في استثارة التوجه النقيض. على أن شاعراً وقاصاً مثل سركون بولص لم يكن كذلك، ولا في الطرف النقيض، بل في الطرف الذي لا يمنح ثقلاً لقداسة الأفكار، ويمنح العالمي البعيد سيماء المحلي الكامن في الكيان الداخلي. في حين يبدو طرف ثالث مثل حسب الشيخ جعفر في منأى، وباتجاه الاحتراب الداخلي وحده. شعراء، قد يكون المنفى بهواً مُضاءً لأسماء عدد منهم: فاضل العزاوي، مؤيد الراوي، سركون بولص، علي جعفر العلاق،عبد الكريم گاصد، فوزي كريم… على أن آخرين طمر أسماءهم البهو المعتم في سنوات الدكتاتورية داخل العراق”.
عويل كلمات..
وفي حوار آخر أجراه معه “د.حسن ناظم” نشر في كتاب الدكتور حسن ناظم “أنسنة الشعر مدخل إلى حداثة أخرى: فوزي كريم نموذجاً”. صدر 2006 يقول ” فوزي كريم” عن كونه شاعرا وناقدا في نفس الوقت: “حديث رجل الطبيعة عن الشجرة يختلف عن حديث الشاعر. القصيدة كالشجرة، ويمكن لزاويتي النظر داخل الشاعر (زاوية القارئ الناقد وزاوية الشاعر) أن تكونا بذات الفاعلية. وشاعر مثلي يحلو له أن ينتفع من هذه الفاعلية ويستثمرها. الناقد في داخلي لا يجد غرابة في الكيان اللغوي والوجداني والعقلي الذي يسمى الشعر، أو القصيدة. في حين لا يكف الشاعر في داخلي عن التساؤل والتشكك والحيرة أمام هذا الذي يسمى شعراً، أو قصيدة. أحيان كثيرة أجد زاوية النظر الشعرية في الشعر والقصيدة غاية في الصواب، رغم أنها غائمة بفعل عمقها. ويحلو لي هذا. الناقد بي لا يخلو من أنفاس الشاعر في النظر الفاحص للشعر ومهمته. ولكن الشاعر بي أكثر خلوة بالنفس، وبالتالي أكثر صفاءً. الناقد يجتهد في تعداد ما يلزم النص اللغوي كي يكون شعرا. يجتهد حتى في تعداد الاحتمالات. ولكن الشاعر يحس أن ثمة عنصراً غائماً من العناصر التي لا تشير إليها السبابة. عنصر لا يلتقطه الإدراك. وهو عنصر كفيل بإثارة كل مشاعر الشك واللايقين حتى في حقيقة الشعر: هل القصيدة جوهر لغوي، أم هي عويل كلمات توقاً للالتحام من جديد بالأشياء التي لم تكن الكلمات إلا رموزاً لها؟ وإذا لم تكن القصيدة الشريرة بالضرورة قصيدة رديئة، فلم يحتاج الإنسان الشعر؟ وماذا يقصد ميووش بقوله إن الشعر مدينة موحشة؟ ولم قلت في قصيدة “يوميات الهرب من الأيام” هذا المقطع الغنائي المحير بالنسبة لي: (الشعر أباطيلْ/ إن لمْ يسترْ عريانا/ قضيتُ العمرَ به مُزدانا/ والناسُ عرايا حولي) البيتان الأولان يوحيان بالانطواء على موقف أخلاقي. الآخران يوحيان بالاعتراف بالخطيئة. المقطع ينطوي على مفارقة، ولكن هذه المفارقة مقصودة بوعي كما هو ظاهر. وكأنني بلذاذة العارف أردت أن أبدو أمام النفس مورَّطاً. هل الشاعر ينتمي إلى حيرة في موقع البين بين: بين موقف الشعر الأخلاقي، وبين خروج الشاعر عن هذا الموقف؟ وهل هذا ممكن أصلاً؟ أم أن الأمر يكمن في لعبة الشعر، أو لعبة عالم الوعي الشعري الداخلي الذي لا يخضع إلا لمنطقه وحده؟ تأمل الشعر والمهمة الشعرية في قصائدي تتيح لي فرصة الخوض النشوان في كل هذا. أضف إلى ذلك أن قراءتي لشعراء عرب آخرين من أجيال مختلفة تدفعني مزيدا من الدفع إلى تأمل الشعر، ماهيته ومهمته. هل بالإمكان أن تخرج من الرداءة (ولم أقل الشر!) قصيدة (ولم أقل قصيدة جيدة!)؟ وحدُّ الرداءة لا لبس فيه، في حين حدُّ الشر قد يكون ملتبسا”.
نصوص لفوزي كريم ..
وقد بلغتْ بي الثلاثون ستين عاما!
وأحسب أني،
بعمر الثلاثين، أقطعُ شوطاً إلى ما أريدُ.
ولا يفهم الناسُ أمري، فيحتبسون.
وأنسج حباً
كعاصفة الثلج لامرأةٍ تنسج الشعرَ كالقشعريرة.
أقول لأمي التي ولدتني بفعلِ التلاقحِ:
إني وريثُ أبٍ منك لم يفترشْكِ!
فتعجبُ مما جنت يدُها. غير أني
أراها على غير ما يرتضي إخوتي:
سلماً لبلوغِ الغيابْ.
لأني أعلّلُ شعري بما ليس فيه،
وقارئَ شعري بما يرتئيه،
إذا هو أمسك عن شاغل، واكتفى.
ولكنني والثلاثينَ قوسٌ ونشّابُه لم يصبْ هدفا.
دخلتُ احترابَ تواريخِهم: هتفوا باسمهم،
وارتضوا لعدوهم سمةَ الخاسرين!
كأني حسمتُ احترابي مع النفس!
هذا أواني،
وقد بلغتْ بي الثلاثون ستينَ عاما!
كما يتقاطرُ رملُ الثواني!
سأعشق امرأةً أتوهمها تنسجُ الشعرَ كالقشعريرة،
وأرتادها كجزيرة،
وأفنى هُياما.
يطوف بي الشعرُ خارج مرماكمُ، يا سُعاةُ.
أنا، واحترابي مع النفسِ. لا ما تعافُ الحياةُ.
……

وطن الأسرار
كانَ الشارعُ مدْهوناً
بمياه الفرحِ، وبالدهْشَةِ والحبْ.
والشارعُ، كان عجيباً، بالدمْعِ السّاقطِ
من حبّاتِ القلبْ.
ورأيْنا الشارعَ كالعذراءِ، رأيناهُ بريئا
ولأنَّ دُخانَ السّنةِ الأخرى يتَسرّبُ من شُبّاكِ
الحُلمِ بطيئا،
كُنّا نتأهّبُ للسّحرِ المخبوءِ وراءَ السّاعَة،
وصَريرِ عقَارِبِها، كنّا
كالطيرِ المُثْقلِ بالأفْراحْ،
كالطيرِ المخبولِ، يَشطُّ، يشقُّ مَضيقاً
بينَ جَناحٍ وجَنَاحْ.
…لكنّي وحدي
كنتُ أري وجهَ الثعبانْ،
يتلصّصُ بين وريْقاتِ الكتبِ المُلْقاةِ بخوفٍ؛
…وحدي
يتكشّفُ وجهَ المحظورِ،
ووَجهَ العاثِرِ في طُرقُاتِ النورْ.
لا يجهلُ أن المُقبلَ والعابرَ غصنٌ،
والجسدَ النائمَ في دفء لذاذتِهِ غصنٌ،
والأرضَ وصبوتَها غصنٌ
منْ أغصانِ الموت.
(في الطريقِ إلى الفِراشِ المُفلس،
لحظَ المهاجرُ قطّتينْ؛
هرّا وقطةً، إلي الفراشِ المفلس
يُداعبانِ ظِلّهما المُلغى،
ويَتنفسان بكآبة.
…
كم هو شقيُّ هذا العالم
كم هو شقي…)
ومشينا الساعةَ، نترقّبُ فرحَ السّاعة،
نترقبُ طفلَتنا المحظورةَ،
كيفَ يمسُّ العاشِقُ فرحتَه!
ويُلملِمُ طوفانَ نوارسِهِ المسفوحَة!
كيفَ يُلامسُ نهراً من زيتونٍ، نهرا من شُرفاتِ
الروحِ، ومن أبوابٍ مفْتوحَة!
ومشيْنا وطنَ الأسرارِ، وفوقَ قِبابِ الإشراقْ؛
وتحدْثنا في الريحِ عن الريح
وتحدثنا في النوم عن النوم،
ولهوْنا بأصابع غَفْلتِنا عن سَورةِ ماءٍ تنمو حول الأعناقْ.
ما كنّا شيئاً:
نُسبلُ أيدينا للمدنِ المهزومةِ،
نتَتبعُ أثرَ العاثرِ في ظِلِّه،
ما كنا شيئاً، لكنّا
كنا كالشيء العائمِ في طرقاتِ الأعماقْ.
وسَرينا، وسَرينا في أحراشِ الظُّلمةِ
في شهوتِها الحجريّة،
وبلونْا كل أزقّتِها الملغومةِ بالأكْفانْ
وسَرينا كالمهْزومينَ من الفُرسانِ، سرينا
نتعثّرُ في وهم براءتنا المنسيّة.
…ما بينَ صلاةِ الواحدِ ونواحِ الآخرِ ثُعبانْ
يتلصص بينَ وريْقاتِ الكُتبِ الملقاةِ بخوفٍ.
…لكنّي وحدي
كنتُ الضاحكَ، أغسلُ أسناني بمياهِ الأشواقْ
وأشمُّ ندىً بجناحي
فأدورُ، أدورُ، أحلّقُ، أتوجّعُ، أُصغي
وأحطُّ على قمرِ الليمونِ،
على ورَقٍ مغسولٍ بالأمطار.
بينَ الأطفالِ أُغادرُ نفسي، أمشي
في الطرفِ الحائرِ، أتوزَّع في الحبِّ
أشفُّ من الدمعِ، أصفِّقُ…
(في الطريقِ إلي الفِراش
تتسرّبُ الظلالُ كدعابةٍ بيْضاء.
في الطريقِ إلي الفراشِ المفلس
هرٌ وقطةٌ ينامانِ معاً في الكآبة
حيثُ تنْدثرُ آخرُ خُطواتي.)
بغداد 1970/1/1
…..
وصديقي كانْ
لا يقرأ إلا نثراً صوفيّا
ويقول الدنيا
أزهدُ عندي من عفطةِ عنْز .
وصديقي يفتنه الحانُ، ويفتنه ندمانُ الكاسْ
فنديمُ الخمرةِ مفتاحٌ تتسّعُ به الرؤيا .
لكنّ الدنيا شحذتْ أكثرَ من سيف:
فالآخرُ سيف
والكلمةُ سيف
والوطنُ تعالى سيفاً فوقَ رقابِ الناسْ
وتعالي القائدُ سيّافاً!
فانسحبَ صديقي للعزلة
لا يأمنُ ظلاً حولَ الخمرةِ إلا ظلّه!
لكنْ في أحدِ الأيام ـ وكان الليلُ عراقيّا ـ
دسّت زوجتُه تحت فراش النوم جهازَ التسجيل
وتعرّت ثم دعته لشتمِ الدولة.
وصديقي اليومْ
في معتَقَلٍ
يتدّثرُ بالعلمِ الوطني،
ويعانقُ صورَ القائدِ فوقَ سريرِ النومْ.
91/7/13
……
منحوتة باردة
لأن الغصونَ التي تتوارثُ جدرانَ بيتي
مدى العامِ ليست وريقة،
وأن الجذورَ العميقة
تغذّي مفاصلَها بالسمادْ،
وتمنحُ قشرتَها كلَّ هذا السوادْ!
لأني طليقٌ،
ولا يقتضي الشعرُ مني كلاماً ولا ورقاً أو مدادْ.
لأني وراءَ الكلامِ المعادِ أرى آخراً لا يُعادْ.
لأنَ الحواسَّ تبادلني وهمَها المسْكرا.
لأن ثيابي ملاذُ العواصف،
وأني بغير سنادٍ ولا قاعدة،
كمنحوتةٍ باردة
معلقةٍ في الفراغ!
1993/11/16
وفاته..
توفي “فوزي كريم” في العاصمة البريطانية لندن، 16 مايو 2019، عن عمر ناهز الرابعة والسبعين عاما

