خاص : كتب – محمد البسفي :
شهاد وفاة لـ”النيوليبرالية” .. أم تغيير مواقع ؟
في ظل غمرة كاسحة من النشوة عمت البورجوازية العالمية، والغرب خاصة، إثر تفكك الاتحاد السوفياتي وإنهيار جدار برلين، بدايات العقد التاسع من القرن العشرين، في رمزية تم تسويقها بشكل هستيري لاستعادة أوروبا الشرقية إلى الحاضنة الرأسمالية الغربية، تبلورت فرضية قائلة: “الآن بعد أن فشلت الاشتراكية (في شخص الاتحاد السوفياتي)، فإن النظام الاجتماعي والاقتصادي الوحيد الممكن هو الرأسمالية، أو (اقتصاد السوق الحرة)”، أراد إحكامها المنظر الأميركي، الياباني الأصل، “يوشيه يرو فرنسيس فوكو ياما”، في نظريته التي نالت من الشهرة أقل ما نالته من سوء السمعة حول نهاية التاريخ والإيديولوجيات.. “تنبأ المدافعون عن الرأسمالية بأن فوز الليبرالية سيفتح الباب أمام مستقبل مضمون من السلام والإزدهار. تحدث الاقتصاديون عن توزيع الثروة بسلام. فالآن وقد انتهت الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، ستكون الحكومات الرأسمالية قادرة على إنفاق مبالغ طائلة من المال لبناء المدارس والمستشفيات والمنازل وكل الأشياء الأخرى التي هي الشرط الأساس للوجود الحضاري. الصحاري ستُزْهِر والإنتاج سيرتفع والجنس البشري سيعيش بسعادة إلى الأبد. آمين”. على حد التعليق الساخر لـ”آلان وودز” (1).
أراد “فوكو ياما” تدشين نظريته في كتاب: (نهاية التاريخ والإنسان الأخير)، واستهله ببيان دعائي يؤكد: “إن ما نشهده … هو نهاية التطور الإيديولوجي للجنس البشري؛ وعولمة الديمقراطية الليبرالية الغربية باعتبارها الشكل النهائي للحكومة البشرية”.
نظريًا؛ يرى أستاذ الفلسفة المصري، “د. محمد دوير”، أن: “من المؤكد تاريخيًا أن الإيديولوجيا كانت من المفاهيم التي طورها أتباع ماركس، أفضل من قام بتوظيف دلالاتها المعرفية من بين مدارس الفكر الفلسفي في أوروبا. وذلك أن الفكر الماركسي استطاع أن يقف في مواجهة الفكر البورجوازي والتصورات الليبرالية التي جاهدت من أجل حصار الماركسية بمقولات عامة ومطلقة كالمساواة والعدالة والحرية والتقدم والحقوق، فلم يكن أمام الماركسيين سوى مواجهة هذا الفكر الليبرالي بنظرية إيديولوجية بديلة تواجه التحول الرأسمالي الذي طرح نفسه كحل أخير للبشرية، أي كيوتوبيا وإيديولوجيا في آن واحد. وهذا ما أكد عليه أيضًا عبدالإله بلقزيز بقوله: لا يمكن النظر إلى أطروحة نهاية الإيديولوجيا ونهاية التاريخ إلا كدعوى إيديولوجية جديدة” (2).
ولكن؛ فوجيء القاريء الليبرالي المنتشي بخدر مقولات “فوكو ياما”، بمقال تحليلي مطول للأخير نشرته مجلة (the New Statesman)، يوم 17 تشرين أول/أكتوبر 2018، يعزف “فوكو ياما” فيه لحن التراجع والانقلاب، قائلًا: “ما قلته آنذاك، (1992)، هو أن إحدى المشاكل المتعلقة بالديمقراطية الحديثة هي أنها توفر السلام والإزدهار، لكن الناس يريدون أكثر من ذلك … فالديمقراطيات الليبرالية لا تُحاول حتى أن تحدد ماهية الحياة الجيدة، لقد تركت تلك المهمة للأفراد، الذين يشعرون بالغربة، بدون هدف، وهذا هو السبب في أن انضمامهم إلى تلك المجموعات الهوياتية يمنحهم بعض الشعور بالإنتماء”.
“فوكو ياما”، كان من أبرز المسؤولين الرسميين في إدارتي “ريغان” و”بوش”، ومقربًا من حركة المحافظين الجُدد، لذا كان من كبار الداعمين لغزو العراق وغيرها من سياسات “نسور” البيت الأبيض حراس الرأسمالية والنيوليبرالية المتعصبين في تلك الحقبة، لم تأتي مراجعاته الأخيرة سقوطًا مباغتًا عنيفًا بل جاءت بالتدريج، حينما بدأ بعد عام 2003 ينتقد بعض الأفكار النيوليبرالية كالمطالبة بإلغاء القيود على القطاع المالي، التي كانت مسؤولة جزئيًا عن الإنهيار الاقتصادي الكارثي في عام 2008. كما أنه منتقد لـ”اليورو”، (كعُملة موحدة لتكتل ضخم مثل الاتحاد الأوروبي)، أو على الأقل: “لطريقة خلقه الخاطئة”. معلنًا: “هذه كلها سياسات وضعتها النخبة؛ والتي تحولت إلى كارثة جسيمة، إن الإنزعاج الذي يشعر به الناس العاديون له ما يبرره”.
يُفسر “فوكو ياما”، في مقال مجلة (the New Statesman)، عودة اليسار الاشتراكي إلى الواجهة في بريطانيا وأميركا مرة أخرى، بأن: “كل هذا يتوقف على ما تعنيه بالاشتراكية. لا أعتقد أن الملكية العامة لوسائل الإنتاج ستنجح – باستثناء المجالات التي تكون فيها مطلوبة بوضوح، مثل المرافق العامة … أما إذا كنت تقصد برامج إعادة التوزيع التي تحاول تصحيح هذا الخلل الكبير الموجود في كل من الدخل والثروة، فنعم أنا لست فقط أعتقد أنها يمكن أن تعود، بل يجب أن تعود. إن هذه الفترة الممتدة، التي بدأت مع ريغان وتاتشر، والتي ترسخت فيها مجموعة معينة من الأفكار حول فوائد الأسواق غير المنظمة، كان لها تأثير كارثي من نواح كثيرة”.
موضحًا: “لقد أدت في مجال المساواة الاجتماعية إلى إضعاف النقابات العمالية، وإضعاف القدرة التفاوضية للعمال العاديين وصعود فئة طبقة أوليغارشية في كل مكان تقريبًا والتي تمتلك سلطة سياسية مفرطة. أما فيما يتعلق بدور القطاع المالي، فإذا كان هناك أي شيء تعلمناه من الأزمة المالية، فهو أنه علينا تنظيم القطاع بشكل كبير لأنه سيتسبب في جعل الآخرين يدفعون الثمن”.
يُعلق “آلان وودز”: يدافع فوكو ياما عن تأميم المرافق العامة لأن ذلك “مطلوب بوضوح”. ونحن نتفق معه كليًا. لكن لماذا ليس ذلك مطلوبًا بالنسبة للبنوك، على سبيل المثال، والتي أثبتت عجزًا كاملًا عن إدارة ومراقبة كميات هائلة من أموال الناس بطريقة مسؤولة ؟
كانت المضاربات الإجرامية والفساد وعدم كفاءة البنوك هي الأسباب المباشرة للأزمة المالية لعام 2008، والتي ما نزال نعيش تبعاتها. وفي النهاية صار هؤلاء المدافعون المتحمسون عن اقتصاد السوق الحر، الذين عارضوا أي اقتراح لتدخل الدولة في الاقتصاد، يحتاجون من الدولة إنقاذهم عن طريق ضخ كميات هائلة من المال العام في صناديقهم.
متابعًا: “وبدلًا من إرسالهم إلى السجن، الذي يستحقونه بشكل كامل، تمت مكافأتهم على عدم كفاءتهم بمبالغ هائلة من الميزانية العامة. هذا هو السبب في أننا نواجه اليوم عجزًا عموميًا هائلًا، والذي يقال لنا إنه يجب أن ندفع لتقليصه. الفقراء يدعمون الأغنياء، في ما يُشبه حكاية روبن هود، لكن بشكل معكوس. وفي الوقت نفسه يتم إعلامنا بأنه لا توجد أموال لدفع تكاليف تلك الأشياء غير الضرورية؛ مثل المدارس والمستشفيات ورعاية المسنين والمعاشات التقاعدية والتعليم والطرق والمرافق الصحية، والتي هيكلها في حالة مزرية في بريطانيا وغيرها من بلدان العالم الغنية” (3).
وربما أوضح دليل على صحة ما قاله “وودز”، في العام 2018؛ ذلك الواقع الصادم للنيوليبرالية والرأسمالية العالمية الذي أفرز لها زلزال (كوفيد-19)، بعد أقل من سنتين، رغم اختلاف التحليلات والنظريات حول دوافعه وتبعاته الاقتصادية/الاجتماعية، إلا وأنه نجح في تعرية تلك المنظومة الرأسمالية الهشة وأسقط عنها كافة الأقنعة بداية من تردي البنية ومنظومة الرعاية الصحية إلى سقوط رطانة الحقوق الإنسانية في العلاج والسلام والرفاه التي طالما يثرثر بها الغرب..
“جان دومينيك ميشال”، عالم اجتماع وإنثروبولوجيا صحيّة، وخبير صحّةٍ عامة مقيم في سويسرا، أنكبّ منذ أكثر من ثلاثين عامًا على دراسة أنظمة الرعاية الصحيّة وتطبيقها، انتقد في مقاله العلمي الإجراءات الإحترازية ورد فعل أغلب دول العالم المتقدم الغير علمي حيال الجائحة الوبائية؛ قائلًا: “نحن عالقون بين فكَّي كمّاشة، تتجلّى في الضرر الكبير الذي يتسبّب به الفيروس للسواد الأعظم من الناس وخطورته الشديدة في حالاتٍ معيّنة. ما تمّ اعتماده على أرض الواقع من تدابير، بعيدٌ كل البُعد عن الممارسة المثالية: إذ أن عدم التقصّي عن المرض كما يجب، والإبقاء على السكان في حالة حجر لوقف انتشار الفيروس، يُعد الإستراتيجية الأكثر هشاشةً في مواجهة أي وباء، لا بل الاحتمال الأخير ـ وربما الأضعف ـ عندما تعجز كل الوسائل الأخرى عن السيطرة الفعّالة على الوباء، إذ أننا لا نقوم إلا بإبطاء انتشاره والحد من آثاره الإرتدادية وحسب”.
مُجيبًا على سؤال طرحه عن الأسباب وراء هذا الوضع السيء: “الجواب ببساطة هو أننا فشلنا في إيجاد الإجابات الصحيحة في الوقت المناسب. ويتجلّى مدى غرقنا في هذه الأزمة، من خلال إفتقارنا للعدد اللازم من اختبارات التقصّي عن الإصابة بفيروس (كورونا)، ففي الوقت الذي جعلت فيه بلدان: ككوريا وهونغ كونغ وتايوان وسنغافورة والصين؛ من اختبارات تقصّي المرض أولويةً قصوى، تجد غالبية البلدان واقفةً موقف المتفرّج، عاجزة بسلبيتها عن ترتيب أبسط الأولويات التقنية”.. “استفادت الدول الآسيوية، المذكورة آنفًا، من الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص لرسم مسارات الانتقال الممكنة لدى كلّ حالة تثبت إيجابيتها، فبالاستعانة بالهواتف الذكية، يمكن إجراء جرد لتنقلات هذه الحالات والأشخاص الذين تواصلوا معهم في الـ 48 ساعة التي سبقت ظهور الأعراض”.
موضحًا: “تُجدر الإشارة إلى التناقص الكبير في قدرة المشافي، خلال العقد الماضي، على استقبال الحالات، لدرجةٍ وجدنا أنفسنا فيها في حالة نقص في عدد أسرة العناية المركزة ومعدات الإنعاش، ناهيك عن كمية من المعدات الطبية الأساسية كالمعقّمات الكحولية والكمامات الواقية تكفي كامل طاقم الرعاية الطبية. وتشير الإحصاءات إلى أنّ البلدان الأكثر تضرّرًا اليوم، هي تلك التي خفّضت في السنوات الأخيرة مستوى استيعاب وحدات العناية المركزة لديها … لا يختلف الفيروس بين بلد وآخر، ما يختلف ببساطة هو خصائص الاستجابة الصحية له، وهو ما يصنع كل الفرق بين آلاف الوفيات في بعض البلدان، وحالات معدودة في بعضها الآخر. لا شك في أن لاستعمال الاستعارات العسكرية والحربية في توصيف ما نتعرّض له اليوم، بريقًا خاصًا، لكن لا بدّ من الإعتراف بالنقص المأساوي في استعدادنا لمواجهة هذا العدو” (4).
الإمبريالية .. والهاوية السحيقة
طبقًا لبيانات حديثة أصدرها “البنك الدولي”؛ تمتلك ألمانيا 8.3 سرير مستشفى لكل ألف من السكان؛ وفي فرنسا يوجد بها 6.5 سرير لكل ألف؛ أما في إيطاليا فكان هناك 10.6 سرير لكل ألف في عام 1975؛ انخفضت في عام 2018 إلى 2.6 سرير لكل ألف، وفي بريطانيا كان هناك 10.7 سرير لكل ألف شخص في عام 1960 وصلت في عام 2018 إلى 2.8 سرير لكل ألف من السكان، وفي مصر كان هناك 1.6 سرير لكل ألف في عام 2014؛ انخفضت الآن إلى 0.96 سرير لكل ألف. تلك الأرقام الفاضحة لتردي أوضاع المنظومة الصحية العالمية، ضمن ما كشفته الجائحة الفيروسية من عوار وعورات السياسات النيوليبرالية من أزمات متلاحقة، يُعتبر أبنًا شرعيًا للإمبريالية الرأسمالية العالمية الحديثة وأحد ميكانيزمات النهب ما بعد التقليدي لدول الأطراف أو دول العالم الثالث، أي النهب بصيغته التالية للاحتلال العسكري المباشر، والذي يعتمد ضمن ما يعتمد على أربعة آليات للتبادل غير المتكافيء من أبرزها هجرة العقول العلمية وأصحاب الكفاءة بحسب دراسة “عيسى المهنا”، معهد تخطيط الدولة دمشق 2004، والتي حققت إحصائيات: “وجود أكثر من 450 ألف عربي من حاملي الشهادات والمؤهلات العليا في أوروبا وأميركا وكندا، ممن تم تأهيلهم على حساب شعوب البلدان العربية، وتُقدر إحصاءات جامعة الدول العربية قيمة الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هجرة تلك العقول بحوالي 200 مليار دولار”.
وإن كان تدني الإنفاق على البحث العلمي هو المرادف الموضوعي لهجرة العقول، فيسوق “مجدي عبدالهادي”، تقديرات حول عدم تجاوز الإنفاق على البحث العلمي “نسبة 0.5% من الناتج القومي الإجمالي لأيّ من الدول العربية، مقارنة بنحو 3.5% لألمانيا و2.9% لأميركا و3% لليابان و4.7% لإسرائيل، مع انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي إلى 3% فقط، مُقارنة بما يصل أحيانًا لنسب 60 و70% في الدول المتقدمة؛ ما تجلّى أثره في انخفاض الإنتاجية البحثية، بحيث بلغت متوسط 0.2 بحث فقط للباحث العربي مقابل متوسط 1.5 بحث للباحث في الدول المذكورة”.
مؤكدًا على أن نصيب الفرد في البحث العلمي في الدول العربية قد بلغ 14.7 دولارًا، ما يقل عن متوسط الدول النامية البالغ 58.5 دولارًا، والمتوسط العالمي البالغ 170 دولارًا، ويقل بكثير جدًا عن الدول المتقدمة البالغ 710 دولارًا، وإسرائيل البالغ 1272.8 دولارًا.
لافتًا الباحث الاقتصادي المصري إلى ما تتميز به السلعة البحثية وسوقها من سمات خاصة، واصفًا إياها بأنها سلعة “كفاية” لا سلعة “عين”: “أي أقرب لسلعة عامة لا سلعة استهلاك فردي، ما يتجلى خصوصًا في أن منافعها غير شخصية؛ ما يعطي لسوقها سمات خاصة تنتهي لقلة مستهلكيه ومحدوديتهم كمّيًا وكيفيًا، فضلاً عن اقتصارهم على المؤسسات نوعيًا، وهو الطابع الذي يزداد كلما قلت التطبيقات المباشرة للمنتج البحثي؛ لهذا يصعب حتى من وجهة نظر المجتمع الإعتماد بشكل كامل على السوق الحرة في تمويل ما يحتاجه من بحث علمي؛ إذ (عندما يتخذ الأفراد القرارات بشأن كمية التعليم التي يريدون الحصول عليها أو كمية البحوث والتطوير التي يبتغونها، فإنهم يوازنون بين التكاليف الحدية والمنافع الحدية الخاصة بهم؛ وبذلك فإنهم لا يعون المنافع الخارجية/الاجتماعية لها)؛ فلا يخصّصون له ما يكفي من موارد”.. “ولهذا غالبًا ما ترتبط المؤسسات البحثية بالشركات والحكومات، لكون الأخيرة مستهلكي منتجاتها وخدماتها الأساسيين، ما يجعله سوق احتكار مشترين في الواقع (أي سوق يحظى فيه المشترون بأفضلية على البائعين)، ما يضعف الموقف التفاوضي والقدرة التسويقية والتمويلية للمؤسسات البحثية، كما يقيّد نطاق اختياراتها ويعقّد مشكلة تمويلها الذاتي إذا ما أرادت الحفاظ على استقلاليتها، الضرورية لجودة منتجها ذاته” (5).
حرب العولمة والعولمة المضادة
وبالعودة إلى “فوكو ياما”؛ نجده معجبًا في مقاله المنشور عام 2018، بـ”النموذج الصيني” ويعتقد فيه بديلًا وحيدًا معقولًا للديموقراطية الليبرالية، كنموذج لرأسمالية الدولة: “يقول الصينيون صراحة بأن نظامهم متفوق لأنهم يستطيعون ضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي على المدى البعيد بطريقة لا يمكن للديمقراطية تحقيقها … فإذا ما مرت 30 سنة أخرى وصاروا أكبر من الولايات المتحدة، وصار الصينيون أكثر ثراء واستمرت البلاد متماسكة، فإني سأقول إن لديهم حجة حقيقية”.
لكن يرى “آلان وودز” أن، فوكو ياما، قد أظهر إرتباكًا واضحًا في هذا الإعتقاد والتفاؤل بالنموذج الصيني، فقد كان (فوكو ياما): “تجريبيًا إنطباعيًا قبل 26 عامًا، عندما كانت لديه أوهام في اقتصاد السوق؛ لأنه كان يبدو وكأنه يتقدم باستمرار. وما يزال تجريبيًا إنطباعيًا حتى اليوم، باستثناء أن إعجابه بالصين قد إزداد بنفس الدرجة التي تراجع بها إعجابه بالرأسمالية الغربية (الليبرالية)” (6).
ويشعر فوكو ياما بالقلق من احتمال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة والصين، حيث قال: “أعتقد أنه سيكون في منتهى الحماقة استبعاد ذلك الاحتمال، يمكنني التفكير في الكثير من السيناريوهات التي يمكن أن تبدأ بها مثل تلك الحرب. لا أعتقد أنها ستكون هجومًا متعمدًا من قِبل دولة على أخرى – مثل غزو ألمانيا لبولندا في عام 1939 – بل من المُرجح أكثر أن تندلع على خلفية صراع محلي حول تايوان أو حول كوريا الشمالية، وربما نتيجة للتوتر المتزايد في بحر الصين الجنوبي”.
وبرغم عدم تأييد “وودز” هذا الطرح، وإعتقاده في عدم وجود خطر نشوب حرب “أميركية-صينية”، رغم كافة التناقضات السياسية والإستراتيجية الآنية، متنبئًا بإشتعال “حروب صغيرة طوال الوقت مثل تلك الحروب التي نراها في العراق وسوريا”. تأتي جائحة (كوفيد-19) في الربع الأول من العام 2020، وتظهر آراء وتنظيرات عديدة تدور حول هذا التفوق البارز لـ”النموذج الصيني” وتبعاته من احتمالية التصاعد الدرامي لوتيرة الصراع “الأميركي-الصيني” لدرجة التدخل العسكري بينهما؛ وكذا تراجع الهيمنة الأميركية ومدى فرص عودة الولايات المتحدة لحالة عزلتها الأولى، زمن ما قبل العالمية الأولى، ونهاية ما يُطلق عليه بـ”العصر الأميركي”، في حين أصر بعض الاقتصاديون والمحللون التقدميون على أن تكون تكهناتهم أكثر واقعية وتركيزها على ملاحظة الخطوات البطيئة لـ”حرب العولمة والعولمة المضادة” داخل منظومة رأسمالية عالمية واحدة..
وربما التفوق النسبي للصين في امتصاص ضربة الجائحة الوبائية طبيًا – واستفادتها أيضًا اقتصاديًا حتى الآن – في مقابل الضعف الذي تلبس أميركا أمام وباء “كورونا” المُستجد لدرجة تصدرها لقائمة أعداد الموتى والمصابين به عالميًا؛ وما تبع ذلك من تصريحات وإجراءات عصبية إتخذتها إدارتها مستهدفة الصين، لدرجة قيام واشنطن بتجميد حصتها المالية في تمويل “منظمة الصحة العالمية” بسبب محاباتها للإجراءات والإحصائيات الصينية وإعتمادها في إدارة الأزمة عالميًا.. ربما كل هذا يعزز من منطقية نبؤة “فوكو ياما”، عام 2018، ويرصد الكاتب المصري، “إبراهيم نوار”، بأنه: في سياق حملة الهجوم الأميركي على الصين … تعُتبر إمتدادًا لمدرسة الحرب الباردة السابقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. وتسعى الولايات المتحدة من خلال استخدام أسلحة الحرب الباردة المعروفة، وإبتكار أسلحة جديدة، إلى تخريب الصين من الداخل، وتكوين رأي عام يُحاصر الصين عالميًا. وفي سياق هذه الحرب الباردة، تقوم الولايات المتحدة بزيادة مجهودها العسكري في “المحيط الهادي”، وتحريك الكثير من قطع الأسطول السابع إلى بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي و”مضيق تايوان” و”مضيق ملقا”، إضافة إلى تكثيف الطلعات الجوية، ونشر صواريخ “باليستية” متوسطة المدى في بلاد تحيط بالصين مثل، أستراليا وكوريا الجنوبية. (7)
وبينما يرى الكاتب والمؤرخ الأميركي، “مايك ديفيس”، أن انتشار الفيروس لم يكن مثيرًا للدهشة؛ حيث أن فكرة انتشار وباء وشيك كانت تهيمن على أذهان علماء الأوبئة منذ تفشي مرض “سارس” في عام 2003، مؤكدًا على أنه بعد ظهور “إنفلونزا الطيور” في عام 2005، نشرت الإدارة الأميركية “إستراتيجية وطنية طموحة لمواجهة جائحة الإنفلونزا”، تستند إلى اكتشاف أن جميع المستويات من نظام الصحة العامة الأميركي غير مستعدة تمامًا لأي تفشي فيروسي واسع النطاق. بعد الذعر من “إنفلونزا الخنازير” في 2009، جرى تحديث الإستراتيجية. وفي 2017، قبل أسبوع من تنصيب “ترامب”، أجرى مسؤولو إدارة “أوباما”، بالتعاون مع مسؤولي إدارة “ترامب” الجدد، محاكاة واسعة النطاق لاختبار استجابة الوكالات الفيدرالية والمستشفيات في مواجهة جائحة قد تنشأ في ثلاثة سيناريوهات مختلفة، من “إنفلونزا الخنازير” أو فيروس “إيبولا” أو فيروس “زيكا”. أخفق النظام، بالطبع، في منع تفشي المرض أو في تبطيط المنحنيات في الوقت المناسب. تُمثل جزءً من المشكلة في الكشف عن الفيروسات والتنسيق. وتُمثل الجزء الآخر في عدم كفاية المخزون وعدم كفاءة سلاسل التوريد، التي تُعاني من اختناقات واضحة، مثل الإعتماد على عدد قليل من المصانع الخارجية لإنتاج معدات الحماية الحيوية. علاوة على ذلك، هناك إخفاق في الاستفادة من التقدم الثوري في التصميم البيولوجي على مدى العقد الماضي من أجل تخزين ترسانة من الأدوية المضادة للفيروسات واللقاحات الجديدة. (8)
ويوضح “ديفيس” العلاقة الطردية بين العولمة الرأسمالية وحماية البيئة وخلق صحة عامة سليمة للإنسان، بأن العولمة الاقتصادية؛ وهي الحركة الحرة المُتسارعة للتمويل والاستثمار داخل سوق عالمية واحدة تعجز فيها القوى العاملة نسبيًا عن الحركة وتُحرم من القدرة التقليدية على المساومة، تختلف عن الترابط الاقتصادي الذي تُنظمه الحماية العالمية لحقوق العمال وصغار المنتجين. “بدلًا من ذلك، نرى نظامًا عالميًا تراكميًا، يكسر الحدود التقليدية بين الأمراض الحيوانية والبشر في كل مكان، ويزيد من قوة احتكار العقاقير الطبية، ويضاعف من حجم النفايات المسببة للسرطان، ويدعم سيطرة الأقلية الرأسمالية، ويقوض الحكومات التقدمية الملتزمة بالصحة العامة، ويُدمر المجتمعات التقليدية (الصناعية وما قبل الصناعية على حد سواء)، ويجعل من المحيطات مكبًا للنفايات. (حلول السوق) حافظت على الظروف الحياتية الديكنزية البشعة، واستمرار الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي محدودًا عالميًا على نحو مُخجل”.
هذا وقد أجمل البروفسور الإيطالي، “ستيفانو مونتاناري”، وجهة نظره المتشككة في الحملات الإعلامية والدعائية والإجراءات الإحترازية التي انتهجتها أغلب الدول حيال جائحة الفيروس التاجي، والتي يراها تضخيمًا وتهويلًا دعائيًا له مأرب أخرى تتمحور حول الاستفادة الاقتصادية لصالح أطراف على حساب أطراف أخرى في اللعبة الرأسمالية العالمية الكبرى. موضحًا أن كل شيء الآن مُغلق، باستثناء “البورصة”، ويمكن لأصحاب الملايين شراء المؤسسات بأمها وأبيها بأسعار منخفضة للغاية. وعندما سيتم إعطاء الإشارة لإنهاء “العملية”، سيتحولون فجأة إلى أصحاب ثروات ضخمة. سيُصبح أصحاب الملايين من أصحاب المليارات، وسيُصبح الأغنياء أكثر غنى، وستُصبح الطبقة الوسطى فقيرة.
وختم “مونتاناري” كلامه قائلًا: “أعتقد أن كل شيء تم ترتيبه لأجل ذلك. ومن أجل ربح المليارات مستقبلاً من بيع اللقاح الذي يزعمون أنه سيكون لقاحًا عجيبًا. سيكون لقاحًا مخصصًا ليُشفي من فيروس متغير، فيروس لا يمكن أن تكون هناك مناعة حياله، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك لقاح…”. (9)
أما البروفسور الروسي، “فالنتين كاتاسونوف”، أستاذ الاقتصاد بجامعة العلاقات الدولية بموسكو، فقد حرص على بناء رؤية شاملة حول أزمة الرأسمالية العالمية الحالية والمترجمة في عدة ظواهر تراكمية منذ انفجارها عام 2008؛ كان أبرزها مؤخرًا الصراع “الأميركي-الصيني” والجائحة الوبائية (كوفيد-19)، تلك الأجواء الآنية التي يراها “كاتاسونوف” مشابهة لحد التطابق لأجواء سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية وتحديدًا للحظات تفجر الأزمة الرأسمالية نهايات العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن الماضي والمعرفة بـ”الكساد الكبير”، وبالتالي يستخلص البروفسور الروسي من تحليله أن الجائحة الفيروسية جائت كبديل موضوعي عن نشوب حرب عالمية جديدة.. ففي شهر تشرين أول/أكتوبر من عام 1929؛ اجتاحت موجة من الذعر الجنوني “بورصة نيويورك” كانت الشرارة لإشتعال أزمة الاقتصاد الأميركي ما لبثت أن تجاوزت حدود الولايات المتحدة، فبدأ في العام 1930 تراجع الاقتصاد العالمي والتدهور الاقتصادي الذي استمر إلى عام 1932، وفي عام 1933 بدأ “الكساد الكبير”.. وبناءً على نظرية الدورة الرأسمالية عادة ما يُشار إلى أربعة مراحل هي: “الركود؛ الكساد؛ الإنتعاش؛ والذروة”، والأخيرة هي أعلى نقطة في نهوض الاقتصاد. إنها الأزمات الدورية في ظل الرأسمالية.. آنذاك كان الجميع ينتظرون أن ينتهي التدهور وأن يبدأ إنتعاش الاقتصاد بمرور الوقت، ولكن لم يأتي الإنتعاش.. بذلت كل الجهود الممكنة بغية إنتعاش الاقتصاد بما في ذلك اللجوء إلى أفكار الاقتصادي الإنكليزي، “جون كينز”، في تدخل الدولة الحديدي في القطاع الاقتصادي، وبرنامج “روزفلت” الذي أعلن في الولايات المتحدة تحت عنوان (New Deal-النهج الجديد)، الذي خفف نسبيًا من وطئة الركود، ولكنه لم ينتشل الاقتصاد الأميركي من الوضع الذي كان فيه، ولم تتحول مرحلة “الركود” إلى “إنتعاش” يتبعه نهوض، حينها أصبحت الحرب، الحرب العالمية الثانية، التي باتت السبيل الوحيد للخروج من ذلك الوضع. يؤكد “كاتاسونوف” بأن: “وضعًا مثل هذا تقريبًا؛ بل وأسوأ منه ينشأ في العالم اليوم، لأن أزمة 2007/2008 انتهت، ولكن الركود مازال مستمرًا حتى الآن.. حتى عام 2020”.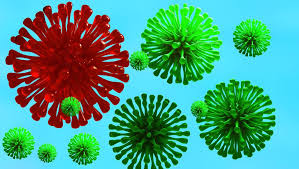
متابعًا: “في عام 2009؛ انتهت الأزمة، ولكن الركود مازال مستمرًا حتى الآن؛ أي أكثر من عشرة سنوات، وهذا غير طبيعي، وإذا قارنا هذا الوضع بدورات أزمات أخرى، نجد أن آمد الركود الحالي طال كثيرًا، وأنا على إطلاع أن مفاوضات ما جرت خلف الكواليس للخروج من الوضع الحالي بإشعال حرب جديدة، ولكن في هذا الوقت؛ الجميع يعلم أن إشعال حرب صغيرة ينطوي حتمًا على خطر تصاعدها وتحولها إلى حرب كبيرة قد تغدو حربًا نووية تقضي على البشرية، لذا من يعملون خلف الكواليس العالمية تخلوا عن فكرة شن حرب كبيرة كوسيلة لإنتشال الاقتصاد من دائرة الكساد، ولكن الحرب في حقيقة الأمر دائرة الآن وسوف تستمر، والفرق أنها حرب باردة، كما كان يقال في القرن العشرين؛ ويسمونها الآن (الحرب الهجينة)، أما جائحة فيروس كورونا فقد سعرت هذه الحرب الهجينة، فقد ظهرت في الوقت المناسب للنظام الرأسمالي العالمي.. ولكن الحروب عادة ما تجعل أحد المشاركين فيها منتفعًا، وثمة ما يكون في عداد الخاسرين عندما تنتهي الحرب، وقد يختفي آخرون من خارطة العالم السياسية. ونحن الآن شهود هلع إعلامي بخصوص فيروس كورونا، أنا أفترض أن هذا الهلع ذو طابع إعلامي بنسبة 90%؛ ومهمته إحداث رجة في العالم للانتقال في الاقتصاد إلى طور جديد، طور الإنهيار”.
الأزمة كما يرد في كتب الاقتصاد العالمية من شأنها أن تُزيل بطريقة عفوية وعنفية إختلالات التوازن المتراكمة في الاقتصاد، وأزمة 2007/2008 لم تلغي الإختلالات، فـ”الركود” بعد أن بدأ لم يتحول إلى أسلوب ناعم لإزالة الإختلالات بل تعاظمت.. “الركود” طال آمده؛ وعندئذ أخذت المصارف المركزية تطبع دولارات غير مكفولة، لا غطاء لها، أما الكمية الكبيرة من الأموال المطبوعة فقد أفضت شيئًا فشيئًا إلى تشكل فوقعات مالية في البورصات، ومرة أخرى تزايد حجم الديون في جميع قطاعات الاقتصاد، وحوالي عام 2007 لامست ديون “الولايات المتحدة” مؤشرات 300% من الناتج المحلي الإجمالي، والأمر نفسه حدث في “الاتحاد الأوروبي”، وفي “الصين” أيضًا بلغ الدين 300% من الناتج المحلي الإجمالي، هكذا وضع أكثر جدية مما كان عليه عشية أزمة 2007/2008، ما استدعى ضرورة تجاوز هذا الوضع الاقتصادي.. الحرب عادة ما تلغي الديون الكبيرة، فبعد الحرب ما إن يزول الدائن، وهذا ما حدث في السابق، وإما أن يتحول المدين إلى دائن، “أميركا” مثالًا على ذلك؛ فبعد أن كانت أكبر مدين في العالم إنخرطت في الحرب العالمية الأولى فأصبحت أكبر دائن.
ويرفض “فالنتين كاتاسونوف”؛ وضع أي تنبؤات بما ستأول إليه أزمة الرأسمالية العالمية فيما بعد الجائحة الفيروسية “الاقتصادية”، لافتًا إلى الوضع الحالي لأميركا التي يرى أنها تُعاني حربًا أهلية اقتصادية في جوهر الأمر، قائلًا: “ربما يبدو هذا الأمر مبالغة فاقعة، ولكن أميركا تشهد الآن صراعًا بين ترامب وأولائك الذين يسمون الدولة العميقة، ونتيجة هذا الصراع الداخلي سيتحدد موقع الولايات المتحدة في العالم، يُحاول ترامب عمليًا أن يُعيد الجن إلى الزجاجة التي أطلق منها عام 1944، عند إقامة نظام بريتين وودز المالي العالمي، آنذاك بالتحديد إتخذ القرار بأن يُصبح الدولار المرتبط بمكافيء ذهبي عُملة دولية، وهكذا ظهر معيار الدولار الذهب، بدا الأمر وكأن أميركا كانت تحلم بذلك؛ فلم يُعد الدولار عُملة قومية، بعد ذلك صار حملة الأسهم في نظام الاحتياطي الفيدرالي يحصلون على دخل من كل دولار ورقي متداول في كل أنحاء العالم، وكهذا ظهر إلى الوجود نموذج الرأسمالية المالية، ولكي يُصبح الدولار عُملة عالمية، كان على الاقتصاد الأميركي الحقيقي أن يندثر هكذا بكل بساطة، فالدولار الأميركي في حقيقته هو ايصال دين مثله مثل أي ورقة نقدية، وكي تنتشر هذه الدولارات بكميات كبيرة خارج حدود أميركا يجب أن يكون رصيد الميزان التجاري للولايات المتحدة سلبيًا، والرصيد يكون سلبيًا عندما يزيد الاستيراد على التصدير، أي الاقتصاد القومي يفقد قدرته التنافسية ومواقعه في الأسواق العالمية، حتى عام 1964 لم تكن أوروبا في وضع يسمح لها ببيع سلعها على نطاق واسع والحصول مقابل ذلك على الدولارات من الولايات المتحدة، ولكن في العام 1965 تغير الوضع فصارت الدولارات تصل من أميركا بكميات كبيرة؛ وفي هذا الوقت بدأت في الولايات المتحدة مرحلة إضعاف الاقتصاد الحقيقي، أود الإشارة إلى أن قرارات مؤتمر بريتين وودز عام 1944 قد لاقت رفضًا شديدًا في الكونغرس الأميركي”. (10)
بداية جديدة للتاريخ .. أم هدنة لإلتقاط الأنفاس ؟
أما “مايك ديفيس” فيرى في الأزمة الحالية أنها تُجبر رأس المال، كبيرًا وصغيرًا، على مواجهة الإنهيار المحتمل لسلاسل الإنتاج العالمية وعدم القدرة على إعادة توفير إمدادات أرخص من العمالة الأجنبية باستمرار. في الوقت نفسه، تُشير إلى أسواق جديدة مهمة أو قابلة للإتساع للقاحات وأنظمة التعقيم وتكنولوجيا المراقبة وتوصيل البقالة للمنازل، وما إلى ذلك. ستؤدي المخاطر والفرص مجتمعة إلى إصلاح جزئي: المنتجات والإجراءات الجديدة التي تُقلل من المخاطر الصحية الناجمة عن استمرار ظهور الأمراض، بينما تُحفز في نفس الوقت زيادة تطوير “رأسمالية المراقبة”. لكن من شبه المؤكد أن هذه الحماية ستكون محدودة – إذا تُركت للأسواق والأنظمة القومية الاستبدادية – وسوف تقتصر على الدول والطبقات الثرية. سوف يعززون الجدران بدلًا من إزالتها، ويعمقون الانقسام بين إنسانيتين: إحداهما تمتلك الموارد اللازمة لتخفيف تبعات تغير المناخ والأوبئة الجديدة والأخرى لا تمتلكها.
موضحًا: “في إعتقادي أن الأزمة الحضارية في عصرنا مُحددة بعدم قدرة الرأسمالية على توفير الدخل لغالبية البشرية، أو توفير الوظائف أو الأدوار الاجتماعية الهادفة، كما أنها عاجزة عن وقف إنبعاثات الوقود الإحفوري، وترجمة التقدم البيولوجي الثوري إلى ما يخدم الصحة العامة. هذه أزمات متداخلة، لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، ويجب النظر إليها ككل متراكب، وليس كقضايا منفصلة. ولكن لصياغة الأمر بلغة أكثر كلاسيكية، يمكن القول إن الرأسمالية الفائقة أصبحت في الوقت الراهن قيدًا يُكبل محاولات تطوير قوى الإنتاج اللازمة لبقاء جنسنا البشري على قيد الحياة”. (11)
في حين يلحظ الباحث الاقتصادي المصري، “مجدي عبدالهادي”، تضارب آراء الخبراء مختلفي التخصصات حول الآثار الهيكلية بعيدة المدى للأزمة مما يمس قواعد وآليات عمل النظام الأساسية بالأخص، ويرى أن أغلبها اتفق على بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية حال استطالت أزمة “كورونا” لما يصل لعام أو عام ونصف؛ كما ترى بعض التوقعات، من أهمها :
أولًا: تراجع كبير في الثقة العامة بالقطاع الخاص وتغليب منطق الربح في القطاعات الاجتماعية الأساسية.
ثانيًا: هزّة قوية في الإيمان بنجاعة ومتانة نظام التجارة الدولية وسلاسل التوريد والقيمة العالمية الكبيرة والمعقدة.
ثالثًا: إتجاهات للإنغلاق وتعزيز الدول القومية، تدعمه خبرة الدول حاليًا مع ميل كلٍّ منها للحلول الفردية وضعف التعاون الدولي.
رابعًا: ستتغيّر أساليب الإنتاج الزراعي والحيواني الكبير، ومعها أنماط الاستهلاك الغذائي والاشتراطات الصحية، كما ستتعزّز برامج البحث العلمي المشتبكة مع جوانبها الاجتماعية والبيئية، … ستتغيّر أنماط العمل، ويزداد الإتجاه للاستفادة من التقنيات الحديثة للعمل عن بُعد، خصوصًا بعد اتساعها وتجربتها عمليًا وإجباريًا في خضم الأزمة.
خامسًا: ستزداد المخاوف من الهيمنة المالية والمصرفية الهائلة، بما يتصل بها من هشاشة اقتصادية تُهدِّد بالإنهيارات السريعة دومًا مع كل صدمة عرض أو طلب فعلية أو لمجرد مخاوف استثمارية.
سادسًا: ربما تتراجع جزئيًا النزعة الاستهلاكية التي سادت منذ السبعينيات مع التجربة المؤلمة للركود وإنقطاع الدخول وفقدان الأمان الوظيفي، فتزداد الميول الإدخارية ونزعات “المينيماليزم” أو التقليل من الاستهلاك والشراء قدر الإمكان.
وعليه؛ يحاول “عبدالهادي” استنتاج تفتّح إمكانات لبعض التحوّلات النوعية في الوعي الاجتماعي، أي تحوّلات على مستوى الإيديولوجية تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، بما يفتح أبوابًا لتغيرات حقيقية أوسع في كامل حياتنا، إنها الرؤية الجديدة للاقتصاد التي يمكن لـ”كورونا” أن يهبنا إياها، والتي ستشمل غالبًا تغيّرات جذرية في المواقف تجاه “أبقار الرأسمالية المقدسة”. (12)
فأولًا، من المُرجَّح جدًا أن تكسب دعوات تقرير “حدود النمو” مزيدًا من القبول على حساب إيديولوجية “النمو للنمو” المرتبطة بالتراكم المستمر لرأس المال، … ستتبيّن بمزيد من الوضوح أهمية اعتماد أفق واقعي للنمو الاقتصادي والتوسع الاستهلاكي، كما ستظهر إمكانات جديدة للناس تتعلّق بخفض يوم وأسبوع العمل…
ثانيًا؛ ربما تتّجه الحكومات إلى مزيد من السيطرة على أسواقها المحلية، وتحقيق قدر من الإكتفاء الذاتي، وتقصير سلاسل توريدها من الخارج، وتقليص هيمنة رأس المال المالي ودور البورصات والأموال الساخنة، لتقليل المخاطر والهشاشة المتصلة بها، كما ستقلّص هيمنة القطاع الخاص وحافز الربح على القطاعات الإنسانية والاجتماعية الإستراتيجية لصالح مزيد من الصالح الاجتماعي العام عليها.
ثالثًا؛ وأخيرًا وليس آخرًا، سيتنامى وعي متناقض تجاه عالمية النظام الرأسمالي، فمن ناحية، ستستعيد الدولة القومية بعض قوتها وأهميتها في المدى القصير، ويتراجع التعاون الدولي وربما تتقلّص التجارة الدولية وحرية حركة رأس المال جزئيًا، لكن من ناحية أخرى كذلك، سيزداد الوعي بأهمية التنسيق الدولي في الملفات ذات التأثيرات العالمية العابرة للحدود. ومع ذلك، لن يكفي هذا التغيّر المحتمل في نظرتنا للاقتصاد لإحداث تغيّر موازٍ في واقعنا معه، فهذا يشترط فعلًا اجتماعيًا وتوازنات قوى، وبالمُجمل نضالات شعبية ربما لا تتراكم القوى الكافية لها في المدى المنظور، وإن ظلّت النظرة الجديدة خطوة مهمة على طريقها.
وبالفعل جاءت تلك التنبؤات التي خلصت إليها آراء معظم خبراء ومنظري الاقتصاد السياسي؛ من تبعات للجائحة الوبائية (كوفيد-19)، والتي يمكن تلخيصها في :
1 – إمكانية نشوب حرب عسكرية، بأغراض تقسيم الأسواق والأذرع الاقتصادية وإعادة فرض النفوذ الاقتصادي/السياسي، بين تكتلات دولية متضاربة المصالح بقيادة “الولايات المتحدة” من جهة و”الصين” من جهة أخرى.. ليس من الضروري أن تكون حربًا مباشرة كبرى بين القوتين، ولكن يمكنها النشوب في شكل حروب صغيرة (بالوكالة أو في صيغ حروب نوعية)، خاصة بعد تسخين المشهد بعد إنهيار أسعار البترول العالمية والصراع المباشر بين “روسيا” و”السعودية” في هذا المضمار؛ وتصعيد التوترات “الأميركية-الإيرانية” لحد التحرشات العسكرية الواضحة على الأراضي العراقية، وبداية تخلي واشنطن عن حلفاءها التاريخيين في الرياض كمثال ليس للحصر، فضلًا عن إصرار إدارة “ترامب” على التحرش – حتى ولو على مستوى التصريحات اللفظية – بـ”الصين” ملقيًا عليها كامل مسؤولية انتشار الفيروس.
2 – انتهاء مرحلة سياسات القطب الواحد، التي تُعتبر جائحة “كورونا” خاتمة مرحلتها النهائية التي بدأت منذ سنوات سابقة، وإن لم تنتهي ظاهرة هيمنة “العصر الأميركي” فعلى الأقل سوف تجد من يقاسمها فرض مظلتها المهمنة عالميًا فيما يُشبه أجواء الحرب الباردة سابقًا، ولكنها حرب باردة بين عولمتين متضادتين المصالح، (الحرب الهجينة)، وليست حرب إيديولوجيات متناقضة.
3 – تنمية دور الدولة القومية في إطار اليميني، وتصعيد وتائر نبذ الآخر، المتمثل مباشرة في المهاجرين والوافدين، وتقليص دور التعاون الدولي.
وهنا تحديدًا أهتز الوجدان الليبرالي الغربي رعبًا خشية على انهيار نموذجه الديموقراطي الذي أجتهد مستبسلًا في فرضه عالميًا، لدرجة لجوءه المتكرر للدبابات والآلة العسكرية لفرضه قصرًا، خاصة بعد كل تلك القراءات النظرية للمشهد الحالي للرأسمالية المأزومة وآفاقها بفرض أضلاع مثلث: “الكينزية، المارشالية، الفاشية”.. فتحت عنوان: “فيروس كورونا في مواجهة الديمقراطية.. كيف يغيّر الوباء العالم”، نشر موقع (غازيتا رو)، مقالًا حول اختبار وباء “كورونا” الديمقراطيات الأوروبية، وحقوق الإنسان وآليات العمل الحكومية. مؤكدًا على أنه: “في حال تهديد العدوى للسياسيين، غالبًا ما تُصبح البرلمانات أقل فاعلية. هذا واضح في الولايات المتحدة، حيث خسر حزب الرئيس الجمهوري الأغلبية في مجلس الشيوخ بسبب الحجر الصحي لخمسة أعضاء جمهوريين. ونتيجة لذلك، استمرت مناقشة مشروع قانون تدابير الطواريء للتعامل مع عواقب الوباء عدة أيام إضافية”. (13)
…………………………………………………
(1) آلان وودز – (فوكو ياما يُعيد النظر في أفكاره: “الاشتراكية يجب أن تعود”) – موقع ماركسي – 24 تشرين أول/أكتوبر 2018.
(2) د. محمد دوير – (ماركس ضد نيتشه.. الطريق إلى ما بعد الحداثة) – روافد للنشر والتوزيع – القاهرة 2020.
(3) آلان وودز – (فوكو ياما يُعيد النظر في أفكاره: “الاشتراكية يجب أن تعود”) – مصدر سابق.
(4) جان دومينيك ميشال – (“كوفيد-19”.. هل هي نهاية اللعبة ؟) – صحيفة (الأخبار) اللبنانية – الخميس 9 نيسان/أبريل 2020.
(5) مجدي عبدالهادي – (كيف نعالج مشكلات تمويل البحث العلمي في المنطقة العربية ؟) – 22 آذار/مارس 2020.
(6) آلان وودز – (فوكو ياما يُعيد النظر في أفكاره: “الاشتراكية يجب أن تعود”) – مصدر سابق.
(7) إبراهيم نوار – (لمن ستكون الغلبة في الصراع على النفوذ في العالم بعد وباء كورونا ؟) – صحيفة (القدس العربي) – 31 آذار/مارس 2020.
(8) (عن الأوبئة والرأسمالية الفائقة وصراعات المستقبل.. حوار مع مايك ديفيس) – (مدى مصر) – شريف عبدالقدوس – ترجمة نصر عبدالرحمن – 3 نيسان/أبريل 2020.
(9) ترجمة نشرها المترجم والكاتب “مشعل يسار” على حسابه الخاص على شبكة (فيس بوك)؛ بعنوان: (لا حاجة للأقنعة ولا للقفازات ولا للإنحباس في المنزل، ولن يكون هناك لقاح)، وهي ترجمة لحوار متلفز أجري مع البروفسور الإيطالي، “ستيفانو مونتاناري”، مع قناة (byoblu24)، يوم 2 نيسان/أبريل 2020.
(10) مقابلة أجرتها قناة (روسيا اليوم) “RT”؛ ضمن برنامج “رحلة في الذاكرة”، مع البروفسور، “فالنتين كاتاسونوف” – نيسان/أبريل 2020.
(11) (عن الأوبئة والرأسمالية الفائقة وصراعات المستقبل.. حوار مع مايك ديفيس) – (مدى مصر) – مصدر سابق.
(12) مجدي عبدالهادي – (أبقار الرأسمالية المقدسة.. هكذا سيغير “كوفيد -19” نظرتنا للاقتصاد العالمي) – موقع (الجزيرة نت) – إصدار (الميدان) – نيسان/أبريل 2020.
(13) (روسيا اليوم) – (فيروس كورونا في مواجهة الديمقراطية.. كيف يغيّر الوباء العالم) – تاريخ النشر: 31 آذار/مارس 2020.

