خاص: حاورته- سماح عادل
“خالد أحمد الحيمي” كاتب يمني، فائز بجائزة رئيس الجمهورية للشباب، صدرت له مجموعتين قصصيتين: (لا شيء سوى الحلم- مذبوحاً كما يحلو لهم).
إلى الحوار:
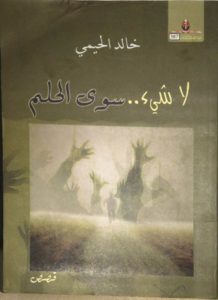
(كتابات) متى بدأ شغفك بالكتابة وكيف تطور؟
- شغف الكتابة يسبقه شغف القراءة، وبداياتي قارئاً نهماً لكل ما يقع في يدي منذ الطفولة، أتذكر أني كنت أوفر مصروفي المدرسي لشراء القصص المصورة، ومجلات الأطفال، في مرحلة الإعدادية استكشفت عوالم أخرى عبر قراءة الروايات ودواوين الشعر وكتب التاريخ وغيرها، وكتبت وقتها بعض الشذرات الشعرية والخواطر وقصص قصيرة ينقصها النضج الفني.
ومع بداية المرحلة الثانوية كتبت موضوعاً إنشائياً أدهش معلم اللغة العربية الذي ظل يثني عليه، ويعرضه على بقية المعلمين، هذا دفعني لكتابة المزيد، وأشعل ملكة الكتابة لدي، لكن البداية الفعلية كانت في السنة الجامعية الأولى حين فزت بالمركز الأول في مسابقة القصة القصيرة مما لفت انتباه أساتذتي ومنهم “د. مشتاق عباس معن” وهو شاعر وناقد معروف من العراق، ورائد القصيدة التفاعلية على الشبكة العنكبوتية، وقد قدم لي النصح وحث على يدي وصقل موهبتي، ووجهني للنشر والمشاركة في الفعاليات والمسابقات الأدبية. وبدأت مرحلة ناضجة وواعية من الكتابة، تُوجت بجائزة رئيس الجمهورية.
(كتابات) فزت بجائزة رئيس الجمهورية للشباب.. ما هو شعورك إزاء تلك الجائزة؟
- فوزي بجائزة رئيس الجمهورية للشباب مثل دافعاً قوياً، وعزز ثقتي بنفسي، وملأتني بالحماسة للكتابة، وقدمني للساحة الأدبية في بلدي بعد أن كنت مغموراً تماماً.
(كتابات) في قصة “مخبر لعين” تحكي عن أحوال اليمن مؤخرا والحرب العبثية التي تتعرض لها.. حدثنا عن ذلك؟
- قبل أن تندلع الحرب كانت هناك إرهاصات تدل عليها، وتقود إليها منها موجة من الاغتيالات المنظمة طالت سياسيين وقادة عسكريين ومثقفين وأساتذة جامعات ونافذين… واستمر الأمر حتى بعد اندلاع الحرب لفترة، وقصة “مخبر لعين” تسير بهذا الاتجاه وأبعد؛ لأنها تكشف ما حدث ويحدث في أتون الحرب الأهلية وكيف يتناسل المخبرون، ويشك الكل في الكل وتختفي الحقيقة، وتنتشر الفوضى والعنف والقتل، والاعتقالات ومصادرة الحريات، ومآسٍ عديدة تخلقها الحرب …؟!
(كتابات) في قصة “رؤوس تالفة” هل السخرية هنا مقصودة أم وليدة لحظة الكتابة؟
- مقصودة طبعاً، الموضوع برمته ساخر، ولكنه انسكب كالصلصال وتم تشكيله أثناء الكتابة، أجد متعة كبيرة في الكتابة الساخرة، حجم المآسي التي نحملها أكثر مما نحتمل؛ والتعامل معها بروح ساخرة، يجعلنا أقوى منها.
(كتابات) في مجموعة “لا شيء سوى الحلم”.. هل تستلهم الشخصيات والأحداث من الواقع أم يلعب الخيال دورا كبيرا؟
- استلهمت معظم قصص المجموعة الأولى من الواقع لكنها لم تأت مطابقة له، لعب الخيال دوره في صنع الشخصيات والأحداث، ومنها ما يذهب إلى السوريالية… القصة ليست سرداً تاريخياً بل فناً، قد أكون بطلاً لإحدى قصصي فأذهب إلى عالمي الخاص وهو مزيج مني وواقعي والأفق الذي أرنو إليه، أغوص بعيداً حيث الخيال الجامح، أو أعود لأسقط في مستنقع الواقع، ما يهمني حقاً هو أن يكون لي عالمي الذي لا يشبه الآخرين.
(كتابات) احكِ لنا عن مجموعتك القصصية الثانية (مذبوحاً كما يحلو لهم)؟
- ضمن الرعاية التي تقدمها الأمانة العامة لجوائز رئيس الجمهورية لما بعد الفوز أصدرت مجموعتي القصصية الثانية (مذبوحاً كما يحلو لهم) العام 2014، وهي قصص قصيرة جداً تناولت قضايا متعددة، عبر التكثيف في اللغة والصورة، والرمزية دون إسراف. كانت بداية تجربة في ق.ق.ج التي ما تزال تثير لغطاً بين المهتمين بكتابتها على الرغم من تطور تقنياتها ووصولها إلى مرحلة النضج الفني تقريباً.
(كتابات) في رأيك هل لابد أن يعبر الأدب عن المجتمع وقضاياه الراهنة؟
- الأديب جزء من مجتمعه، وهو ليس بمنأى عما يحدث من حوله، بصورة أو بأخرى سيتأثر ويؤثر، وسيجد نفسه في المعمعة شاء أو أبى… هناك قضايا مصيرية تخص الأمة، تهدد الحاضر والمستقبل، ولا يمكننا أن نتجاهلها، ونعيش يوتوبيا خاصة بنا. مثلاً الحرب العبثية في اليمن وما خلفته من دمار وقتل وتشريد ومجاعات وأوبئة وتعطيل للتعليم والحياة العامة كل هذا ألهب مشاعر الشعراء والكتاب، ودفعهم لمقارعة الحرب بالكلمة، وتعريتها، ومؤازرة الشعب المطحون برحاها.
(كتابات) ما تقييمك لحال الثقافة في اليمن؟
- يكفي أن نعرف حال المثقف، وهي حال لا تسر، غياب للحريات، وتكميم للأفواه، واعتقالات وتعسف وحصار… ويعيش المثقف اليمني ظروفاً مادية ونفسية صعبة للغاية، بعد انقطاع الرواتب منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، ويجد نفسه في صراع يومي مع الرغيف… هناك الكثير من المثقفين تركوا البلد وهاجروا بحثاً عن الحياة الكريمة، وبعضهم آثر البقاء أو أرغم عليه، إجمالاً المثقف اليمني يرزح تحت ثقل الحرب ويصطلي بنارها، ويقاسي من ويلاتها… لكن وعلى الرغم من كل ما سبق هناك حراك ثقافي وإبداعي يوازي حجم الكارثة، ويتفوق عليها، شعراً وسرداً وكتابات أخرى، كل يوم جديد يطلع على اليمن يرافقه موت ودمار، والمقابل عصافير وفراشات وفن وأدب، وإصدارات جديدة، وهكذا يُبعث اليمني من رماد الحرب؛ ليعلن أن الحياة أجدى بأن يعيشها كما يحلو له، لا كما يريد تجار الحروب، وغربان الخراب.
(كتابات) في رأيك لِمَ لا ينتشر الأدب اليمني في منطقة الشرق؟
- هذا ليس ذنب الأدب اليمني، أراهن بأن الأدب اليمني المعاصر لاسيما الشعر يضاهي نظيره في الشرق، ويتفوق عليه أحياناً… لدينا مشكلة هنا في اليمن تتمثل في غياب النقد بقدر الإنتاج الشعري والأدبي بشكل عام، وإهمال الجهات المعنية في البلد للأديب وتهميشه، والحرب، ثم دور الإعلام وهذا سبب جوهري إذ لا يوجد لدينا إعلام مقروء أو مرئي قادر على صناعة النجومية والشهرة للأديب، أو حتى إيصال صوته للخارج، كما هو في مصر أو الشام أو العراق، والخليج العربي…
ما إن يخرج المبدع اليمني خارج أسوار الوطن، إن جاز لي التعبير، حتى يعلو صوته، ويبدأ نجمه في البزوغ. في الوقت الراهن تلعب شبكات التواصل الاجتماعي دوراً بارزاً في إظهار المواهب ونتاجها الإبداعي، فيسبوك مثّل ملاذاً لليمنيين، وقربهم من رفاقهم في البلدان العربية، مع أنه ليس مقياساً فهو يعج بالغث والسمين، لكنه المتاح في ظل إعلام رث ومتهالك طائفي أو حزبي أو مناطقي لبلد تعربد فيه الحرب والجوع والفقر والأوبئة .
(كتابات) تكتب القصة والشعر.. أيهما أقرب إليك.. وكيف يعبر الشعر عنك؟
- أكتب القصة بشغف، وأشعر بعلاقة حميمية معها، وأكثر ما أكتبه قصة قصيرة، أو قصة قصيرة جداً، ما زلت أتهيب الاقتراب من الرواية، أما الشعر فلم أقصده، ولم أطرق بابه، هو من يزورني متى شاء، وأجده ينداح رقراقاً ليبث لواعج ومشاعر ذاتية وجدانية؛ ولهذا أعده تعبيراً صادقاً عني.
وما ادعيت يوماً أني شاعر، تهزمني سردية القصة أحياناً فأكتب نصوصاً تجمع بينهما، ولاحقاً ستتوافر لدي نصوص سردية شعرية، أفكر بإصدارها بين دفتي كتاب، دون الخلط بين الأجناس الأدبية.
نصوص لخالد الحيمي..
رؤوس تالفة..
« يستطيع أيّ إنسان أن يبدّل رأسه. الثمن ليس باهضاً والنتائج مبهرة. أسرعوا العرض محدود، من لم يبدّل رأسه اليوم فلن يجد له رأساً غداً».
إنّه مجرد إعلان مدجج بالمؤثرات، وغير موثوق في صحته، تطلّ في نهايته مذيعة شقراء بنهدين ضخمين، وسرّة مكشوفة وهي تمضغ كلماتها: ليس في الأمر خدعة، عليكم أن تجربوا. فقط اتصلوا بنا على الرقم (……………….) أو ابعثوا برسالة نصية قصيرة على الرقم المرادف لاسم بلدكم.
طبعاً لم تصدقوا هذا الإعلان. أنا أيضاً لم أصدقه، صحيح أنّ أموراً غريبة صارت تحدث لرؤوس الناس فتتعطل وتتحول إلى خردة، ولكنّي لم أرَ أو أسمع أن أحداً ذهب لاستبدالها ..
قبل أيام، عندما كنت أمشي في باحة الجامعة أوقفتني طالبة جامعية- رأسها تزدحم بعلب الماكياج وأرقام هواتف العشاقـ وأعطتني منشوراً توقَّعت أن يكون سياسياً أو ما شابهه، لكنّي صُعقت عندما فتحته و به ذات الإعلان.
صباح أمس اقتحمت الشمس نوافذ غرفتي، ولم يكن النوم قد وجد طريقه إلى عينيَّ المتعبتين، لم أكن مهموماً وحسب، بل محاصرًا بوساوسي البوليسية، كلما أغمضت جفنيّ أجد نفسي تائهاً خائفاً أجري بلا هوادة في شوارع قذرة؛ تطاردني سيارات وجنود موتورون.. أقدِّم لهم هويتي المدعّمة بوجهي البلاستيكي فلا يقبلونها، ويُلقون بي في سجن خرافي .
امتلأت رأسي بالأفكار المتباينة، صرت أشعر بها تتدلّى من أعلى فكرة شاهقة، وتسقط في الفراغ.. وتضيع .
– هذا بداية التلف.
قالت لي صديقة متشاعرة تكتب برموش عينيها، وأردفت:
– أنا أيضاً صرت أرى كائنات غريبة ومخيفة تخرج من أفلام سينمائية ركيكة وتهاجمني محاولة اقتلاع نهديَّ.
مع أنّي لا أدري لماذا نهداها بالتحديد لكنّي أُبدي أسفي محذراً لها من تفاقم الوضع.
أصدقائي بدا عليهم الانزعاج، وسادت بينهم الفوضى وهم يتناقشون:
– هذا هراء.. إنّه مجرد هراء.
– يقولون إنّها تُصنع من عظام حيوانات نافقة .
– ربما تكون مفخخة .
– ربما تكون رؤوساً نووية فتجلب لنا الدمار.
– ربما ..
قال لي أستاذي في الجامعة مهدئاً من روعي:
– إنّها عملية استنساخ لا أكثر، يتم بعدها استبدال الرأس القديمة برأس جديدة لا تختلف عنها في شيء، لكنّها تخلو من الوساوس، والأفكار السوداء، … والسياسة .
– السياسة ؟!
– نعم .. إنّها الأشد إتلافاً للعقول.
أتذكر صديقاً لي مغرماً بالسياسة كان دائم الشكوى:
– الفئران تسكن في رأسي ولا تدعني أنام .
الأدهى من ذلك أنّه مقتنع أن أحدهم زرعها في رأسه- عنوة- لتنال من أفكاره العظيمة، فتتصدع أو تنهار كما انهار سدّ مأرب.
اليوم تأكد لي أنّ الحياة بتعقيداتها ومؤثراتها أصابت رؤوس الناس بالتلف، وبات من الاعتيادي أن نسمع الناس يحكون لبعضهم البعض ما يحدث:
– أحسّ برأسي تتحول إلى ملعب لكرة القدم…
– سفن القراصنة تتعارك في رأسي…
– رأسي لم تعد تحتمل التجارب النووية…
– هناك تسرب للنفط من جمجمتي…
– تجتمع النقابات العمالية في رأسي…
– ما شأني بالمسلسلات المد بلجة…
– رأسي تمتلئ بالوحل…
– رأسي تكاد تنفجر…
– رأسي ………………………….
ربّما بعد حين- وعند ناصية كلّ شارع- سيتم بناء مؤسسة جديدة؛ لاستبدال الرؤوس التالفة… سيكون الزحام على أشدّه، والناس يتهافتون من كل صوب، يأتون برؤوس أكلها الصدأ، ويعودون برؤوس جديدة تومض بالأفكار.
…….
رجلٌ طوّحت به الحرب..
دوي مدفع بأقصى المدينة يودي بسكينة روحه، ويشتت أفكاره. رصاص كثيف يرافق الموت في جولته الجديدة، أي ثوب يرتديه الآن؟ لا شك أنه يحمل فأساً، يقرع الأبواب؛ تُفتح له، لكن الفأس ينكسر، والمدينة تتقيء على وجهه.
يخطف الموت الأرواح بلا هوادة، يصبح بشعاً ومخيفاً، لكنه يصاب بالذعر حين تلتقي عيناه بعيني امرأة قصّ الحزن ظفائرها.
(يا لتفاهة هذه الحرب) يهمس لنفسه، يفتح النافذة.. سرب آخر من الطائرات يقتحم السماء، مراهق يحمل بندقية يتبول عند برميل القمامة، دراجة نارية تتكئ على جدار، وأصوات انفجارات تتوالى رتيبة.. يبصق في الفراغ، يشعل سيجارة، يتمتم مخاطباً دخانها (حراب الموت تخطئ قلباً لتصيب آخر.. مثخنة هذه البلاد بالقتلة، والقتلى أيضاً) يأخذ نفساً من سيجارته يحصي أسماء القتلى واحداً واحداً، يأخذ نفساً عميقاً، ويترك قلبه يرفرف إلى الأعلى ويعود أشبه بفراشة محترقة.. يراقب دخان سيجارته وهو يتلوى مثقلاً بأنفاسه الموجوعة .
نسمة باردة تداعب وجهه، قطة تتمسح بقدميه وتموء، طائرة أضاعت هدفها تكح في السماء، تيقظ سحابة نائمة؛ تتأرجح السحابة لكنها لا تلقي للأمر بالاً.
حسناً- يخاطب الفراغ- تلك السحابة يمكنها التنبؤ بالاتجاهات الممكنة للطيور المهاجرة، وأحوال الطقس، ومواعيد العشاق، وسخافات أخرى، لكنها لا تستطيع التكهن بما قد يفعله رجل طوحت به الحرب، ورأى وطنه يُبطح أرضاً، وتُحزّ رقبته أمام ناظريه. كيف لسحابة أن تفهم..؟!
يمكن لرصاصة بليدة أن توضح الأمر على نحو أفضل..
تعود الطائرات، تلقي حمولتها؛ تشتعل الجبال، وتهتز الأرض، يتطاير زجاج النوافذ. بكاء أطفال بالجوار، أمهات خائفات يحاولن تهدئة صغارهن، لعنات وشتائم تختلط بأدعية وابتهالات..
يتسمر في مكانه لحظات… ينتزع بندقيته من مكمنها، يصعد على السطح، يطلق الرصاص في كل اتجاه، تنفد رصاصاته، يجلس متكئاً على بندقيته تتردد أنفاسه، ويتسارع نبض قلبه..
يتناهى إلى سمعه دوي انفجار بعيد، إطلاق نار متقطع و.. صمت هزيل يحاول الوقوف على قدميه تصرعه رصاصة طائشة.
……

مخبر لعين..
أُدخن باعتباري رجل سيموت في آخر المطاف، كذلك أمارس الجنس، أما الطعام فلا أخال أيَّ كائن حيّ في هذا البلد يحظى بطعام مناسب.
تهمس لي ندى زميلتي في العمل:
– يوماً ما ستسقط ميتاً بسبب هذه التي في يدك.
أنظر إليها مبتسماً وأهمس:
– سيكون ذلك رائعاً لأنَّ حسناء مثلك ستذرف الدموع لأجلي.
في أحلامك. تردّ وتنشغل بكومة الفوضى أمامها. يرنّ جوالي فأتباطأ في الردّ عليه، وعند اللحظة الأخيرة أجيب:
– مرحبا
– أين أنت يا رجل ؟
– ستقول كنت شارداً أدخن سيجارة.. ألا تكفّ عن التدخين أبداً؟
– حسناً يا عمر، لست شارداً وليس في يدي سيجارة، وأنا أنصت لك.
مات جارنا حسين في المستشفى لا أحد يعلم كيف مات لكنّهم يقولون إنّه مات بالسكته القلبية ربّما كانوا محقين فقد كان مدخناً شرهاً مثلك.. سنشيع جثمانه بعد صلاة الظهر.. هل ستأتي؟
– لا أدري لِمَ اجتاحني الغضب فجأة واندفعت أصرخ:
– اسمع يا عمر، حسين لم يمت لأنّه كان مدخناً شرهاً، بل لأنّه كان مخبراً لعيناً.
أُنهي المكالمة، وألوذ بصمت حرون. تنظر إليّ ندى ملياً وتزمّ شفتيها وتتجاهلني. أشعل سيجارة وأتناول معطفي، وأخرج. الساعة تناهز العاشرة وهذا يعني أنّ الوقت مبكر جدّاً على الذهاب، لكنّي أفعل هذا- كغيري- منذ انهارت البلد، وانخرطت في حرب عبثية، وتقطّعت سبل الحياة بما في ذلك الراتب.
في الشارع تلفت انتباهي سيارة قادمة بسرعة جنونية يُصدر فراملها صريراً مزعجاً قبل أن تتوقف أمام المقصف القريب ويطلُّ منها شاب يحمل كلاشنكوف يطلق منه تسع رصاصات أو أكثر باتجاه رجل حمسيني يسقط في الحال مضرجاً بدمه. وتختفي السيارة بنفس السرعة التي ظهرت فيها. في لمح البصر يتجمهر الناس، ولم أصحُ من الصدمة بعد. ندى تجري نحو القتيل وتعود فزعة ، تقف بجانبي وهي ترتعش:
– أعرفه..
– من القاتل؟
– القتيل.. رأيته مراراً هنا يحتسي الشاي بالحليب، ويثرثر مع رفاقه أو عبر الجوال.
تطوّع بعضهم وأبعد الفضوليين عن جسد القتيل ريثما تأتي الشرطة التي قد تأتي الًيَوُمً أو غداً أو بعد سنة، ففي النهاية الشرطة عاجزة عن فعل شيء بما في ذلك حماية نفسها.. سمعت عن اغتيالات، ولكنّي لم أعش أحداثها كاليوم، مع أنّي أؤمن أنّ معظم القتلى رجال مميزون، وقتلتهم حثالة لا يساوون شسع نعالهم.. ولكنّها الحياة.. أليس كذلك ؟ أسير على غير هدى لساعتين إحساس بالخواء والعدمية يلازمني، المشهد يتكرر في مخيلتي: السيارة المسرعة، القاتل الملثم، الكلاشنكوف، لعلعة الرصاص، الأستاذ الجامعي يسقط أرضاً . لمعت في رأسي تفاصيل أخرى، القاتل كان شاباً أسمر ضئيل الجسم يضع لثاماً على وجهه، وأظنّه لم يبلغ سن الرشد.
أما القتيل فأعرفه وهو ما لم تدركه زميلتي فهذا الرجل أستاذ جامعي مرموق ومفكر وكاتب لامع مقالاته تملأ الصحف وشهرته تتجاوز الحدود، وأجزم أن أفكاره التي أزعجتهم قد صرعته. يُرفع آذان الظهر، وأنا على مشارف الحي، أتذكر حسين، أقنع نفسي: لا داعي لأسير في جنازته. لكنّي أبكي.. لا أدري لماذا ؟! لأجل حسين، أو لأجل الأستاذ الجامعي، أو لأجل نفسي. يمرّ الموكب الجنائزي من أمامي، أقف صامتاً وينضم إليّ عمر، نتابع الموكب يبتعد:
– مات المخبر.
– أظنّ أنّ معظم الاعتقالات في حينا كان هو وراءها.
– كان يتظاهر برفضه للطغيان واستلاب البلد وزجّه في حروب عبثية، ليجرنا إلى الكلام، ويُوقِع بنا.
– مخبر لعين.
– مخبر لعين. ردد عمر بعدي وابتسم. أشعلت سيجارة وذكرتٍ له أنّ حسين قبل يومين صافحني فسألته مازحاً:
– لماذا تبدو غامضاً يا جاري.. كأنّك تخفي الأسرار خلف أسوار قلبك ؟
فرد متلمضاً:
– أيّة أسرار يا صاح نحن بالكاد على قيد الحياة.. ؟!
قال عمر:
ثعلب مراوغ. ونقل نظره إلى سيارة عسكرية تقترب منّا، وما لبث أن شحب وجهه وأحد المسلحين يشير إليه، ثمّ يقفز موجهاً سلاحه نحوه. جفل عمر، وصرخ:
لا يحق لكم تهديدي أو اعتقالي بلا ذنب اقترفته.. هناك قانون يحميني. أنفث آخر نَفَس من سيجارتي، وأراقب السيارة العسكرية تغادر وعمر مكبلًا تحيط به البنادق، وأهمس لنفسي:
– مسكين يا عمر، لن تعرف – أبداً- أنّ من وشى بك ورفاقك لم يكن حسين. .أنت ورفاقك وحسين والأستاذ الجامعي وآخرين كانوا ضحايا لـ .. رصاصة غادرة تستقرّ في رأسي، تجحظ عيناي، يهوي جسدي يرتطم بالأرض وتتدفق الدماء..

