خاص: قراءة- سماح عادل
كثير من القراء يهتم بالحوارات مع الكتاب، لأنها تكشف لهم الكثير عن الكتاب الذين يشغفون بهم، كما تزيح الغموض عنهم وتكشف آراءهم تجاه الأدب والكتابة وتجاه أعمالهم الناجحة.
كتاب (ستار التخيل) للكاتب والمترجم العراقي “مظفر لامي” كتاب متميز، وهو عبارة عن ترجمة لحوارات مع “ميلان كونديرا”، “جاو اكسينغيان”، “ميشيل دو سوختو”، “جان ماري غوستاف لوكليزو”، “الان فانكيلكروت”، “فيليب روث”، “اورهان باموك”، “توني موريسون”.

أنتوني بورخس..
“أنتوني بورخس”كاتب انكليزي، شاعر، مسرحي، مؤلف موسيقي، عالم لغوي مترجم وناقد، أكثر أعماله شهرة هي (البرتقالة الآلية)، ألف “بورخس” اثنين وأربعين رواية، حاوره “كاترين ديفد”.
يقول “أنتوني بورخس” عن كتابة السيرة الذاتية: “كتابة السيرة الذاتية أمر ينطوي على كثير من المخاطرة، حين نشرت كتاب (سلطة الظلمات) وكان البطل فيه من المثليين، سألني كل من قابلته: وأنت.. هل أنت مثله؟، وفي أمريكا صنف هذا الكتاب المكتبات ضمن أدب المثليين! هذا سخف.. و الظاهر يجد الكثير من الناس صعوبة في فهم ما يجده الكاتب مثيراً للخيال في موضوعة ما، قد ينظرون إليها من جانب مختلف. أنا أقول أنه يمكن الكتابة عن أي شيء، ما دام عمل الكاتب يعتمد أساساً على التخيل، بالطبع ممكن أن نضل سبيلنا”.
ميلان كونديرا..
“ميلان كونديرا” كاتب من أصل تشيكي، عاش منفياً في فرنساً منذ عام ١٩٧٥ حتى اكتسابه الجنسية الفرنسية عام ١٩٨١، أكثر أعماله شهرة هي “خفة الكائن التي لاتحتمل”، “كتاب الضحك والنسيان” و”المزحة”.
في حوار مع “لويس اوبنهيم” يقول عن الرواية الأوربية بالنسبة له: “أنا أكون حقاً مربكاً حين يتعذر علي العثور على المصطلح المناسب، فإن قلت (رواية غربية)، سيقال أنك تنسى الرواية الروسية، وإن قلت (رواية عالمية) فانا أحجب الحقيقة التي تقول إنني إنما أتحدث عن الرواية التي هي مرتبطة تاريخياً بأوربا. لهذا حين أقول (رواية أوربية) إنما افهم هذا التوصيف ليس كمصطلح جغرافي بل (روحي).. ما أدعوه ب (الرواية الأوربية) هو التأريخ الذي يمتد من سرفانتس حتى فوكنر”.
وعن كتابة (فن الرواية) وهل يقدم نظرية شخصية جدا للرواية يقول: “هو ليس نظرية بالضبط، بل اعتراف لصاحب مهنة. شخصياً، أحب كثيراً أن استمع لأصحاب الصنعة، ربما كنت مخطئاً باختيار عنوان يمكن أن يشير في عمومه لبحث ذي مطامح نظرية”.
وعن تطور تفكيره وفنه يقول: “عند بلوغي سن الثلاثين، كنت قد كتبت أشياء كثيرة، الموسيقى أكثرها جميعاً، وكتبت الشعر أيضا وحتى مسرحية، كنت أعمل أطر مختلفة عديدة، باحثاً عن صوتي، عن أسلوبي ونفسي، ومع القصة الأولى (غراميات مرحة)، التي كتبتها ١٩٥٩ كنت متأكداً أنني وجدت نفسي، أصبحت كاتباً للنثر وروائياً، وأنا لست شيئاً غير ذلك، منذ ذلك الوقت أصبح عملي الفني لا يعرف التحولات، بل يتطور، بتواصل”.
جاو اكسنغيان..
“جاو اكسنغيان” ولد في 1940 في الصين، روائي ،كاتب مسرحي، ناقد ورسام، لاجئ في فرنسا منذ ١٩٨٧. نال جائزة نوبل للآداب عام ٢٠٠٠، الروايتان اللتان جلبتا له الشهرة، (جبل الروح) و (كتاب رجل وحيد). ثم اتجه لكتابة المسرح.
في حواره مع “اليت ارميل” يقول”جاو اكسنغيان”عن غاية وجود الأدب: “نحن نواجه أزمة فكر، وما نحن بحاجة إليه هو الحيوية التي يمكن لفكر جديد أن يقدمها. وهو لن يأتي من العلم القائم على التجربة والتكرار، وعلى منطق عقلي مقنع. العقل هو أداة نتعرف بها على آلية سير الكون، فيزيائيا، بايلوجياً و كيميائياً، لكنه لا يتمكن من حل المعضلات التي تطرحها الطبيعة البشرية التي لاتتقيد بأي قانون قابل للبرهنة. هذا العالم ليس عاقلا أبداً!، إنه عبثي وفوضوي. العلم يبلغ الآن مراحل متقدمة على صعد الحياة لكنه يخفق دائماً تفسير السلوك الإنساني. ذلك الجزء المجهول الذي يحتله الدين، مكان الرب. وكلما اقتحم العلم مواضع جديدة في الحياة ينأى الدين بعيداً. لن يتسنى للعلم أبداً أن يطرق كل الميادين، لكن الأدب يستطيع أن يحل مكانه، في تلك الأماكن التي تبقى مظلمة، متخطياً حتى الفلسفة التي لم تعد تعطي كل الأجوبة.. الطبيعة البشرية متقلبة، لا يمكن التكهن بها أو السيطرة عليها، ولن يستطيع العلم ولا حتى الفلسفة أن يعطي لها تفسيراً. الأدب يستطيع أن يسبر أغوارها حين يقدم شهادته. ما يخفق علماء الاجتماع والفلاسفة في توضيحه، كتاب الأدب قادرون على إظهاره، وفهم آلية عمل النفس البشرية. إنه شكل آخر من المعرفة، ليست علمية ولا فلسفية، بل معرفة إحساس وإدراك وكذلك خيال. الأدب الحقيقي هو ما أسميه بالأدب البارد، إدلاء بشهادة، وليس منتجاً ثقافياً يطرح للسوق. بل هو مسعى لمعرفة حقيقية البشر عبر كشف ما هو خفي، وملامسة ما هو حقيقي في الأعماق القصية للوجود”.
وعن التفكير في نهاية العالم يقول “جاو”: “هو قلقي الأكبر، الفلم الأخير الذي فرغت منه عنوانه (بعد الطوفان). بنفس الوتيرة المتصاعدة التي يتقدم العلم بها، يتفاقم وضع البشرية، ويقترب الطوفان. بالتأكيد العلم يبطئ من قدومه، لكن الاستغلال المتعاظم للطبيعة يجعل الكارثة أمراً لا مفر منه. لا يمكننا الاعتماد على العلم فقط، لا بد لنا من حكمة أخرى، معرفة أخرى، تعتمد على ما هو حقيقي في الوضع البشري، وعلى وصف القلق المعاصر الذي يتجاوز الثقافة، الحدود، الأمم، اللغات والأعراق”.
ميشيل دو سوختو..
“ميشيل دو سوختو” مؤرخ بارز ومتخصص علوم إنسانية عديدة. مؤلف لأكثر من عشرين كتاباً، وهو حالياً أستاذ زائر جامعة كاليفورنيا “سان دييغو”.
في حوار مع “لورا ويليت” يقول “ميشيل دو سوختو”عن تقييمه للنقد الأدبي: ” بشكل إجمالي، ووصف كاريكتوري، كانت البنيوية استعماراً للحقل الأدبي من قبل طرائق علمية، كذلك نتاج أدبي تحدده سلسلة من القواعد والفرضيات العلمية، بينما نشهد اليوم أن واقع الحال معكوس تماماً، فالأدب هو من يمتلك القوة والمقاربة النظرية، والقادر على غزو مجالات العلوم الإنسانية، إلى الحد الذي أصبحت الفلسفة، الانثروبولوجي والتاريخ تحُلل باعتبارها هي الأخرى أدباً. أصبح لدينا ما يخص ذلك نوع من تحرك معاكس، أنعش استقلالية الأدب، كما أظهر المدى الذي أصبحت فيه حقول العلوم الإنسانية مرهونة بعلاقتها بالكتابة أو بالأدب”.
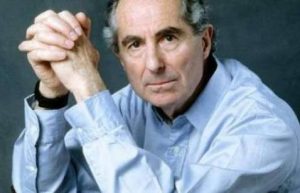
وعن موقعه بالنسبة للنقد المعاصر يقول “دو سوختو”: ” بالنسبة لي، لدي ثقافة مؤرخ، إن عشرين عاماً من الجهد في حقل التحليل النفسي قد غيرت بعمق بعض الطرق التي كنت استخدمها كمؤرخ، استطاعت أن توسع الحيز المحدود في بحوثي. الدراسات متداخلة في حقولها. هي في الحقيقة ليست انتقاءاً ولا جمعا للحقول المعرفية. فائدتها المرجوة تكمن في الجدارة التي حصلت عليها في مجال بعينه، ثم إمكانية أن تغير الطرق التي اعتدت على استخدامها مستعيناً بتجارب أخرى ومجالات مختلفة. العمل الجاد في تخصص ما، يصبح وحده النافع للعمل في حقل آخر. وإلا سنسقط في إيديولوجيا عامة، في جمع توفيقي هش يمثل الاعتلال الذي يشوب المعرفة، في نوع من تدين مدع وبائس”.
جان ماري غوستاف لوكليزيو..
“جان ماري غوستاف لوكليزيو” كاتب وأستاذ فرنسي ألف أكثر من أربعين عملا، منح عن روايته (المحضر) جائزة نوبل للأدب عام ٢٠٠٨ لكونه (مؤلف رحلات حديثة، مغامر، شاعر ومتصوف حسي، مستكشف للإنسانية، خلف نطاق سطوة المدنية وداخلها.).
عن الغرب والشعوب المستعمرة يقول “لوكليزيو”: “أنا أيضاً بوجهين، انتمي، من دون أي شك، للغرب المستعمر. عائلتي استعمرت جزيرة موريس نهاية القرن التاسع عشر، من خلال الاستعمار الانكليزي، الذي لا يختلف عن غيره، استطيع أن أحصي بعض المتعصبين للرق بين أجدادي. وبالرغم من أن جيلي ليس هو الذي أتى بالاستعمار، لكنه كان شاهداً على فتراته الأخيرة المغرب والجزائر، غرب أفريقيا، و أماكن أخرى من العالم. ومن شعوري بالانتساب لمجموعة من البشر ارتكبت كل هذه الانتهاكات، ولد تصوري الثابت لهذه الحقبة من التاريخ. أنا غربي بالتأكيد، لكن لدي مشاعر ارتياب بكل ما هو موغل في العقلانية و المنطق. انجذب للسحر، لما هو فوق الطبيعي، للأماكن التي يتعايش فيها الحاضر مع الماضي بصورة غامضة وطبيعية.. يبدو لي أن التحدث أخيرا عن التاريخ الاستعماري الفرنسي الذي لم ينل ما يكفي من النقاش هو أمر جيد. وهو لا يعني إهانة الذات، بل التطهر من تلك العلل القديمة التي لازالت موجودة: العنصرية، مشاعر التفوق.. لا لاستخدام الكلمات الكبيرة، ولا للتحدث عن الإبادة الجماعية. الأمر ببساطة شديدة، هناك مسؤولية على المستعمر تجاه هذه البلدان الصغيرة التي استقلت وتعيش فعلياً على ما تجود به الأسرة الدولية. على فرنسا أن تمهد الطريق لبلدان طال مكوثها مرحلة الصغر كي تبلغ رشدها”.
آلان فانكيلكروفت..
“آلان فانكيلكروفت” كاتب، فيلسوف و باحث فرنسي، مؤلف للعديد من المؤلفات حول الأدب، وهو شخصية مثيرة للجدل الوسط الفكري الفرنسي.
عن كتابة الشهير في النقد الأدبي “قلبا عاقلا” يقول: “الرواية تتعاطى وتنجز عملية إخراج للعائق الماثل بين الخيال والوهم، نحن نصوغ الأوهام كل حين، هناك صياغات فردية وأخرى جمعية. والخيال هو الوسيلة التي نستدعي به هذه الاستيهامات. الأدب يقف جانب الخيال، صياغة الوهم، كما يخبرنا فرويد، هو تحقيق لرغبة ما، أكون فيها، بطل ومحط أنظار. بينما الخيال على العكس من ذلك، هو ذلك النمط من التفكير الذي يمكنني من الخروج من نفسي، والتحقق من وجهات نظر أخرى غير التي بحوزتي. والقلب العاقل هو هزيمة الاستيهام بالخيال. ما هو الأدب الرائع، إن لم يكن جدلاً أبدياً مع الرداءة، وتساؤلاً قلقاً عن أضرار الحماقة القصصية، الأدب يروي لنا حكايات من أجل أن نكف عن سرد حكايات مع أنفسنا.. المسألة برمتها هي أن نعرف لأي أدب نريد أن نفوض مصيرنا، ذاك الذي يستكشف الوجود أم الذي نستعيده من تلك الأنماط المقولبة المشحونة بالإثارة”.
وعن البطل في الرواية يقول: “أقول، مع توماس بافل، أنه إنسان محجوز عناء توطنه في العالم. الحقيقة، نحن جميعاً نرغب أن نكون الكونت دي مونت كريستو، الفارس الكبير الذي يعيد الحقوق المهضومة، ويرضي انتقامه العادل حتى الآخر بكل قسوة. الرواية تبعدنا عن هذا الجهد الزائف، ومن أجلنا نحن الذين نحلم بإخضاع العالم لمشيئتنا، الرواية تعيد للعالم صموده”.
فيليب روث..
ولد الروائي الأميركي “فيليب روث” عام ١٩٣٣ في نيو آرك بولاية نيوجيرسي، أول كتاب أصدره هو (وداعاً كولومبوس). حصل الكاتب على العديد من الجوائز الأدبية.
عن حضور جسد الإنسان في رواياته يقول “فيليب روث”: “لن أذهب للقول أن جسد الإنسان أكثر حضوراً من روحه في رواياتي، لكن حقاً إن البعد الجسدي موجود فيها، وهذا الأمر كان متعباً، على الأقل منذ رواية (عقدة بروتنوي)، حاولت دائماً أن أكتب موضوعة الجسد من وجهة نظر روائية، بنفس حال وجودها في حياة كل منا: جسدنا ليس شغلنا الشاغل، لا نفكر به دائماً، لكن المعاناة الجسدية أو المتعة الجسدية الكبيرتين غالباً ما تعد تعبيراً عن وجوده”.
وعن رواياته يقول: “نعم الروايات المبكرة مثل (ضد الحياة)، (عملية شايلوك)، أو (مسرح ساباث)، هن حقاً روايات فظة، غير محتشمة أحياناً، متهورة، متصعلكة، لكن الروايات التي تبعتها اتخذت بناءا مختلفاً، أنت تسميه كلاسيكياً، ربما هذا صحيح، لكن الشكل تحدده المادة التي تكتب. لن أنُظَّر في هذا الأمر، لا ابدأ في كتابة رواية متسائلا عن الشكل الذي ستتخذه، الموضوع هو من يحدد ذلك. كل رواية لها حكايتها الخاصة، أما زاوية النظر الكلية فهي تلك الروح التي توجه عملي، لا أعرف إن كان لهذه الوحدة من وجود، الأشياء تتغير تدريجياً كلما تقدم بك العمر، اعتقد أنني كتبت ثمانية وعشرين كتاباً، غيرأن كلا منها كان له منهج معين، الكاتب الذي كتب الرواية الخامسة هو ليس ذاته من كتب العاشرة وهذا ليس هو من كتب الخامسة عشر، مع مرور السنين تتقدم العمر وحياتك تتطور وتصبح كاتباً أفضل، وبعد مضي سبعين أو ثمانين عاماً تكون متعباً منهكاً، قدراتك الذهنية قد أفلت وأضمحلت، وأخيراً، الأكثر أهمية هو أن ذاكرتك تتآكل وتصدأ، وتفقد الرابط المباشر معها. هذه الظواهر الثلاث مجتمعة هي من تجعل من كبر السن مرحلة يكون ما يكتبه الكاتب فيها رديئاً بشكل عاما، لم تبلغني أي من هذه الأمارات بعد، كما يبدو لي، والكتابة هي عملً يومي بالنسبة لي، لن أعرف ماذا أفعل بنفسي وبحياتي إن توقفت عنها. الكتابة هي الركن الذي تحتمي به، إنها بابك”.
وعن قراءه في الولايات المتحدة يقول: “لا أعرف من هم قرائي في الولايات المتحدة ولا كم عددهم. ببساطة أعرف أنهم لا يشكلون قاعدة كبيره. وأنا متشائم من مستقبل القراءة. لن أستطيع التحدث عن بلدان أخرى غير بلدي، في الولايات المتحدة القراءة الجادة المكثفة الفطنة هي نشاط يتراجع بوتيرة مستمرة. قراءة الرواية هو فن أخذ في الأفول في مواجهة الشاشة وسلطتها المنومة. الشكل الروائي كضوء باحث في العالم و التجربة البشرية أصبح مهملا. لكن هذا لا يشعرني بالحزن، بالرغم من أن ذلك أمر مؤسف لأن المفارقة الغريبة أن الكتابة الروائية تمضي بشكل جيد. الرواية الأمريكية في حالة جيدة جداً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولأن عدد القراء يتناقص، يقل ما يكسبه الكتاب أكثر فأكثر، لكن ذلك لا يثبط من همة الكتابة عندهم. الكاتب لا يكتب مرغماً من أجل أن يكسب عدداً كبيراً من القراء. حين تكتب يكون القارئ الأكثر أهمية والذي تحسب له ألف حساب هو أنت”.
أورهان باموك..
“أورهان باموك” روائي تركي، درس العمارة والصحافة قبل أن يتجه للأدب والكتابة ويعد واحداً من أهم الكتاب المعاصرين في تركيا.
عن فوزه بجائزة نوبل يقول “أورهان باموك”: “الأمر الأول الذي تغيره جائزة نوبل في حياتك هو حسابك المصرفي، وهي بالتأكيد شرف كبير بالنسبة لي وأنا التركي الأول الذي ينال هذا الامتياز. أنا سعيد جداً بها، لكن من جانب أخر، تتطلب هذه الجائزة أن أتحول لدبلوماسي، وهو أمر أصادف صعوبة فيه، لأن طبيعتي لا تميل للحياة الاجتماعية والمقابلات بل للتوحد والانجاز. دعيت لأماكن شتى العالم كي أبدي رأياً ما يدور في السياسة وهذا شيء غير محتمل بالنسبة لي. أنا كاتب وليس معلقاً سياسياً. لكن حصولي على هذه الجائزة مبكراً سيجنبني أن أسُأل من قبل الصحفيين إن كنت أتمنى الحصول عليها يوماً.. إنه سوء فهم، لا اعتقد أنني ملزم بسبب نيلي للجائزة أن أتحول لشخص أخر مختلف، أعني شخصا ينخرط فجأة في الحديث في شؤون السياسة. لا أحب فعل ذلك. هذه الجائزة لا تزيد ولا تنقص من فضيلة الحائز عليها. مسؤوليتي لا تكمن في إدعاء إنقاذ العالم أو تغييره من خلال خطب سياسية، بل في مواصلة كتابة الكتب، فهذا هو سبب حصولي على الجائزة وليس من أجل أسباب سياسية”.
وعن الأدب وتغيير العالم يقول: “لا أملك طموحاً مثل هذا، لا أكتب لأغير العالم، أنا أكتب لان علي أن أكتب. هذا كل شيء. أنا مثل صبي يلعب بكرته بشغف فيأتي أحد ليسأله إن كان يقصد من لعبه بالكرة تغيير العالم. الجواب لا، هو يلعب لأن هذه اللعبة هي الوسيلة الوحيدة التي عثر عليها لكي يثبت أنه موجود. أما إذا أصبح بعد ذلك بطلا مهماً وإن ذلك غير بعض الأشياء في العالم، فهذا بحث آخر. لنأخذ الأمر بجدية، خدمة الإنسانية ليست هي الهدف الذي يتوخاه الأدب. على الكاتب أن يسبر أغوار روحه وخياله. الانعطافة الحادة تحدث حين يمضي حتى الحدود القصوى لهذه المغامرة، وهو يستطيع عبر كشفه للأعماق السحيقة للنفس البشرية أن يكتب كتباً يمكن أن تكون بطريقة ما نافعة للبشرية. لكن لا يجب لهذه النقطة الأخيرة أن تكون هي الفكرة المتسلطة والموجهة لتفكيره. خدمة البشرية نتيجة وليست هدفاً”.

توني موريسون..
“توني موريسون” كاتبة أمريكية من أصل إفريقي، روايتها الأولى (العين الأكثر زرقة) نشرتها عام ١٩٧٠. حازت على العديد من الجوائز الهامة.
في حوار مع “بير بوردو” تقول “توني موريسون” عن أدبها: “أن نضع أنفسنا هكذا موضع الشاهد على حالة ما، أو نكون مثل أحد ليس لديه من شيء ليقوله سوى (أخ لدي ألم!) أو (أنا احتج) هو أمر مخز بشدة، حتى لو كان مهماً جداً.. حاولت أن أجعل من رواية المحبوبة رواية تاريخية، لكنها أفلتت من حدود المسار التاريخي الصارم. حين فرغت منها قررت أن يكون كتابي التالي عن الحقبة التاريخية اللاحقة والتي تدعى عصر الجاز، لكن ما كنت راغبة به بالخصوص هو أن يكون القراء قبل كل شيء واعين للبناء وللإعداد الواضح الذي أردت أن استخدم فيه كل ما أمكن من بنى الجاز.. مثل كل الكتاب، أحلم أن تكون لي مكانة خاصة، فريدة وأصيلة بما يكفي لتجعلني خارج أي مقارنة. لكن الحقيقة أننا جميعاً بقدر ما قرأنا الكثير، لا نحب أن تشخص المؤثرات التي كان لها أثر علينا. مع ذلك أعلم تماماً أنني سبق ونسب لي التأثر بكتاب أمريكان من البيض والسود لأسباب مختلفة أحياناً وأحياناً أخرى للأسباب ذاتها. الشخصيات التي لها أهمية كبيرة عندي هم كتاب العشرينات أمثال “جان تومير” وبالخصوص أجد في نفسي فضولاً كبيراً وانجذاباً لأدب السود الذي مكنني من اكتشاف كنوز مجهولة في تلك الحقبة، وهي ليست روايات بل حكايات عبيد أو عن العبيد القدماء”.
وتواصل: “أرى الأدب في تلك الكمية من الحكايات المذهلة التي كتبها أناس استطاعوا بريشهم أن يفكوا عن رقابهم نير العبودية ويدخلوا رحاب الحرية. لا أعرف شعبا مضطهدا في تاريخ الإنسانية تأمل وكتب ونشر متناولاً وضعه الخاص بهذا القدر. كذلك هناك ذلك المنجم الذي لا ينضب من الأغاني والألفاظ والروحانيات التي كانت وستبقى صوت الجاز، ذلك الشكل الشعري الذي يبوح لي عن مكنوناته الحال. هذه التركة التي خلفها الأسلاف هي التي تحضر إذن بوضوح أعمالي. لكن في حالات معينة، أضع هؤلاء الكتاب موضع البحث والتساؤل.. استطيع أن أفهم كم كان مهماً عند كل هؤلاء الكتاب الذين رزحوا تحت نير الاستعباد والذين كتبوا بداية القرن العشرين أن يثبتوا لجمهور البيض، الذين بيدهم قوانين اللعبة، مقدرتهم الجيدة الكتابة. لقد شرعوا في الكتابة، مستخدمين لغة غاية الدقة وسعة الاطلاع. أو على العكس من ذلك، حاولوا إعادة إنتاج ما يسمى بالعامية السوداء الخالية من العبارات الملائمة تماماً، لكنهم فعلوا ذلك مرتكبين الغالب أخطاء النسخ الإملائي محاولين بذلك إعطاء قيمة لخصوصية لغة السود. هذه المسألة تثير اهتمامي بشكل خاص في عملي، استطيع بهذه الكيفية الادعاء أنني ابذل جهداً واعياً لإعادة ارتباطي بكتاب من الزمن الماضي”.

