خاص : بقلم – د. عبدالجواد ياسين*
-1-
أنماط التدين “المختلفة” أبدت ردود فعل “متشابهة” حيال الأزمة، سواء في طريقة التعاطي معها عمليًا، أو في قراءتها على المستوى النظري: التحدي المبكر لإجراءات الحظر ثم التراجع التدريجي عنه، أمكن رصده كواقعة متكررة في سياقات إسلامية ومسيحية ويهودية وهندوسية متعددة. وفي جميع هذه السياقات جرى التفكير في الوباء كموضوع “إلهي”، أي كفعل خارجي مفارق، بمعزل عن الأسباب الطبيعية. إما بوصفه إجراءً عقابيًا موجهًا بالأساس إلى الآخر الديني، أو بوصفه ابتلاءً لا يخلو من الخير حين يتعلق الأمر بالأنا الدينية. وبوجه عام جرى توظيفه تبشيريًا لاستدعاء فكرة الحاجة إلى الدين، التي تظهر بوضوح كلما انكشف عجز الإنسان أمام الطبيعة؛ وخصوصًا أمام الموت. وجرت الإشارة بحماس إلى الإحصائيات المتنوعة التي تكشف عن ارتفاع مؤشر الممارسة الدينية عبر العالم منذ بداية الأزمة، بما في ذلك المجتمعات الغربية ذات التراث العلمي العلماني، (57% من الأميركيين يصلون مرة على الأقل أسبوعيًا منذ مارس (آذار) الماضي، وهي نسبة عالية مقارنة بالسابق).
يُقر العقل “الوضعي” المعاصر إجمالًا بفكرة “الحاجة” إلى الدين كمعطى واقعي من معطيات الاجتماع “الراهن”، وينظر إلى ممارسات التدين المتنامية كظاهرة مفهومة في ظل الهلع الذي جلبه الفيروس، فالإنسان المعاصر لا يزال يحتاج إلى قوة إسناد خارجية هي قوة الآلهة التي ظلت – بتعبير فرويد – “تحتفظ بمهمتها الثلاثية: إبعاد قوى الطبيعة، التوفيق بين البشر ووحشية القدر كما يتجلى في الموت بشكل خاص، والتعويض عن الآلام وأوجه الحرمان التي تفرضها على الإنسان حياة المتحضرين المشتركة”.
لكن العقل الوضعي ما بعد الحداثي، الذي ينزع إلى اليسار إجمالًا، والذي انقلب على مفاهيم التنوير وعقلانيته الأداتية، فقد إيمانه بحياد العلم وقدرته المطلقة؛ العلم الذي حل محل الدين على مستوى السلطة، تحول عبر التكنولوجيا إلى “آلة” كلية قاهرة لحرية الإنسان، وخاضعة تمامًا لهيمنة الرأسمالية. وبعد أن أفقد العالم يقينه بالغيب، لم يفِ بوعوده، كبديل قادر على إشباع الإنسان خصوصًا حاجاته النفسية والوجدانية، التي تضررت كثيرًا من جراء الحداثة بقهر الآلة وقهر السلطة.
-2-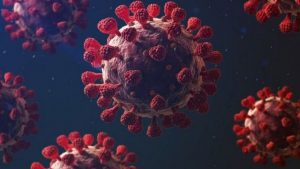
يظهر ذلك في أزمة الفيروس بشكل واضح، حيث تعين على العلم أن يقوم بوظيفة الدين، فالحاجة إلى الدين – كما يشرح جورجيو أغامبين – ظاهرة تحضر بوضوح في الوضع الحالي، “ويمكن الاستدلال عليها بملاحظة الاستخدام المتكرر والمهووس للمفردات والاستعارات الأخروية في وسائل الإعلام، وخطاباتها الثقيلة التي تستحضر باستمرار صورة نهاية العالم”.
ومع ذلك “يبدو الأمر وكأن الحاجة إلى الدين، التي لم تعد الكنيسة قادرة على إشباعها، تبحث عن موطن جديد، وجدته فيما بات منذ زمن الدين الحقيقي في عصرنا: العلم”.
هل يبدو نص أغامبين مرتبكًا، فهو يخلط بين حضور الدين وحضور الحاجة إلى الدين، فبالرغم من إشارته إلى المفردات الأخروية الخاصة بالدين، لا تحضر الكنيسة بل يحضر العلم بوصفه الدين الحقيقي. المطالب بسد حاجات الإنسان. وبهذه الصفة يبدأ أغامبين في شن هجومه المتوقع على العلم: “يمكن للعلم مثل أي دين، إنتاج الخرافات والمخاوف المألوفة في الأديان وقت الأزمات، وما تجلبه من آراء وقوانين مختلفة ومتضاربة. تتراوح المواقف من أقلية مهرطقة (تضم بدورها علماء مشهورين) تنكر خطورة الظاهرة، إلى الخطاب الأرثوذكسي السائد الذي يؤكد النقيض، إلا أن أنصاره وممثليه مختلفون جذريًا في آرائهم حول كيفية مكافحة المرض، وكما هي الحال دائمًا في مثل هذه الأوضاع، يظهر بعض الخبراء أو مدعي الخبرة على الساحة، من الحائزين على استحسان أصحاب السيادة، الذي يفوض – بدوره – التدابير التي تناسب مصالحه الخاصة، والتي تميل لوجهة نظر هذا الفريق أو ذاك، مثلما جرى في النزاعات الدينية التي قسمت الكنيسة”.
يسقط أغامبين على العلم مفردات المصطلح الديني الموروثة من قاموس الصراع مع الكنيسة، وهو قاموس هجائي، يستطيع الإشارة إلى العلم كعقيدة ذات خطاب أرثوذكسي سائد، تمثله مؤسسة “المجتمع العلمي القريبة من صاحب السيادة، والتي تستطيع الحكم بالهرطقة “العلمية” على الآراء المعارضة في العلم – كما كان في الدين – خرافات ومخاوف مألوفة، وآراء وقوانين مختلفة ومتضاربة.
في هذا الطرح، حيث لم يعد “علم الدين”/الكنيسة قادرًا على مواجهة المشكل، لا يبدو “دين العلم” – بدوره – قادرًا على هذه المواجهة. وهذا هو لب المسألة كما يفهمها العقل الوضعي ما بعد الحداثي في الغرب. ومن هذه الزاوية يظهر الطابع الجذري للأزمة الراهنة، أعني قوتها الكاشفة التي تشير إلى خلل هيكلي في بنية النظام الاجتماعي العالم، وهي بالطبع أوسع من بنية النظام الرأسمالي السائد. إن هذا من وجهة نظر أغامبين “هو الجانب الإيجابي الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الوضع الحالي: من المحتمل أن يبدأ الناس لاحقًا بالتساؤل عما إذا كانت طريقة حياتهم هي الطريقة الصحيحة”.
-3-
ثمة مشكل – إذاً – في الوعي المعاصر مع العلم، الذي بشرت الحداثة منذ وضعانية كونت، بقدرته المطلقة على حل جميع مشاكل الإنسان، عبر قانون موحد يشمل السيطرة على الطبيعة والبيولوجيا والنفس وعلاقات الاجتماع. لا يتعلق الأمر – الآن – بعجز العلم عن مواجهة حاجات الذات النفسية والروحية التي يصعب إخضاعها للتجربة فحسب، بل يتعلق بمستوى “الإنجاز” الذي حققه العلم في مجاله الأصلي التجريبي، وهو مجال “المادة الطبيعية” الذي يضم البيولوجيا.
قياسًا إلى حجم الوعود التي أطلقتها الحداثة، يمكن الحديث عن انطباع بخيبة أمل في فاعلية العلم، الذي كان ينتظر منه أن يقدم أفضل مما قدمه بالفعل خصوصًا في مجال الصحة. منذ منتصف القرن العشرين تزايد الاهتمام بالبيولوجيا التي صارت تحتل الصدارة في اهتمامات البحث العلمي على حساب الفيزياء مع ذلك، وعلى الرغم من الحديث عن إنجازات واسعة في مجال التكنولوجيا الحيوية، لم يعد العالم يسمع عن تطورات ثورية مكافئة على مستوى العلاج/الدواء لأمراض أساسية شائعة.
ومع الوعي بالطبيعة المركبة للبيولوجيا الإنسانية، والصعوبات الاعتيادية للبحث العلمي التي تتعلق بمستوى التطور ذاته، يسري الاعتقاد بأن نقص الإنجاز العلمي في هذا المجال، يرجع إلى أسباب “خارجية” تتلخص في خضوعه للإيديولوجيا أصلًا، ومصادرته بوجه خاص من قبل “الرأسمالية المتوحشة”، أي في إرتهانه الدائم لمنطق المصالح الاقتصادية.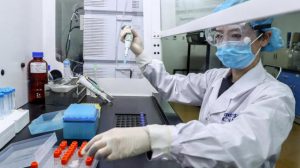
في سياق الأزمة الراهنة، ما الذي كان يمكن للعالم أن يتوقعه من العلم ؟ أو في صياغة أخرى، كيف يقيم العالم مسؤولية العلم حيال الأزمة ؟ لا أشير هنا إلى إلتزامه الوظيفي بتقديم الحلول ترتيبًا على قدرته الكلية المفترضة، بل إلى مسؤوليته المباشرة عن حدوثها (وليس عن مجرد فشله في توقعها ومنع نتائجها). كيف يمكن تكييف مسؤوليته عن الأداء “المعلمي” الذي أسفر في نهاية المطاف عن توليد الفيروس وإنفلاته الوبائي على هذا النحو “غير العلمي” ؟ لقد كشف هذا الأداء عن درجة كارثية من نقص المعلومات على مستوى الخبراء، أوقعت الجميع في حالة من العماء المعرفي، ومن ثم العجز عن اتخاذ القرار على مستوى الحكومات والجماعات والأفراد. أم إن الأمر لا يتعلق بالعلم بل “بإرادة” العلم، أو بيروقراطية “المجتمع العلمي” التي صارت بحاجة إلى مراجعة نقدية شاملة ؟
-4-
ينتمي هذا الطرح في مجمله إلى سياقات الوعي الغربي، الذي خاض تجربة الحداثة، وفرغ تقريبًا من اشتباكاتها الإشكالية مع الدين، قبل أن يشرع في تجاوزها إلى مرحلة “ما بعد الحداثة” باشتباكاتها الإشكالية الجديدة مع العقلانية والعلم. تفرز هذه السياقات، بالطبع، مشاغلها الخاصة، المغايرة لمشاغل الوعي في الشرق العربي/الإسلامي، الذي لم تكتمل تجربته مع الحداثة ببنيتها العلموية العلمانية.
تعبر الرؤية ما بعد الحداثية عن تيار متصاعد في الغرب، لكنه يبقى تيارًا جزئيًا يعكس مشاغل ثقافوية ذات طابع نخبوي. فالمجتمع الغربي لا يزال في مجمله مجتمعًا “حداثيًا” من جهة انصياعه لسلة العلم، واحتفاظه برابطة هشة مع الدين (التقليدي). في هذا السياق جرى تجاوز ونسيان الاشتباكات الإشكالية “القديمة” بين الدين والعلم التي حسمت لصالح الأخير.
في السياق الإسلامي المقابل، لا تزال هذه الاشتباكات الإشكالية القديمة حاضرة دون حسم. وهي حاضرة على نحو أكثر تعقيدًا بسبب احتكاكها “النظري” بأفكار الطرح ما بعد الحداثي، بما في ذلك الاشتباكات الإشكالية الجديدة مع سلطة العلم ذاتها.
كيف تظهر إشكاليات الدين والعلم في النموذج الإسلامي على وقع الأزمة الراهنة.
…………………………………………………………
- الدكتور “عبدالجواد ياسين”؛ مفكر مصري متميز من أعلام حركة إصلاح التراث الإسلامي، له عدة مؤلفات في الفكر السياسي والفقه الدستوري، من أبرزها: (السلطة في الإسلام: العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ) – (الدين والتدين التشريع والنصّ والاجتماع) – (مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة) – (السلطة في الإسلام نقد النظرية السياسية) – (اللاهوت).


