خاص : كتبت – سماح عادل :
“عبدالحكيم قاسم” كاتب مصري.. ولد في قرية “ميت القرشي” بمحافظة الدقهلية، عام 1934، في عام 1943 التحق بمدرسة الأقباط الابتدائية “بميت غمر”، حيث سكن في بيت جده لأمه وكان يعود لأسرته في الأجازات الصيفية، ثم درس في مدرسة “الناصر” الثانوية بطنطا، وفي 1954 ذهب للإقامة في القاهرة بعد إصابته بالملاريا، وتردي أحواله الدراسية، وسكن بغرفة بإحدى عمارات حي “شبرا”، والتحق بكلية الحقوق “جامعة الإسكندرية” عام 1955، وتطوع بعد التحاقه بها بعام في “الحرس الوطني” دفاعاً عن مدينة الإسكندرية بعد وقوع العدوان الثلاثي، ولم يكمل “عبدالحكيم قاسم” دراسته بكلية الحقوق نظراً لمرض والده وتدهور أحواله المالية، فترك الجامعة والتحق في عمل كتابي في “هيئة البريد” بالقاهرة، ولكنه حصل على ليسانس الحقوق من “جامعة الإسكندرية” في عام 1966، وعمل بعدها في “الهيئة العامة للتأمين والمعاشات” حتى رحيله لألمانيا.
حياته..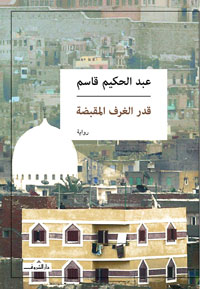
في كانون أول/ديسمبر 1959، تم القبض على “عبدالحكيم قاسم” بتهمة الإنتماء لـ”الحزب الشيوعي المصري”؛ وحكم عليه بالسجن خمس سنوات قضاها بـ”سجن الواحات”، وأفرج عنه في آيار/مايو 1964، وعمل بعد تخرجه في مكتبة، “ركسان”، أرملة الباحث والكاتب الراحل “شهدي عطية الشافعي”.
عام 1987 قرر “عبدالحكيم قاسم” خوض انتخابات مجلس الشعب على قائمة “حزب التجمع”، ولكنه خسر الانتخابات، وعقب خسارته أصيب بنزيف حاد في المخ دخل على أثره المستشفى، ليخرج بعد أربعة أشهر وقد أصيب بشلل في يده اليمنى أعاقه عن الكتابة بنفسه وظل يملي زوجته ما يريد كتابته حتى رحيله.
سافر إلى ألمانيا سنة 1974 للمشاركة في ندوة أدبية، غير أن المقام امتد به هناك 11 سنة، عاشها في برلين المنقسمة آنذاك إلى شطرين، غربي وشرقي. في “برلين” بدأ، “عبدالحكيم قاسم”، في الإعداد لأطروحة الدكتوراه عن الأدب المصري، وتحديداً عن جيله، جيل الستينيات، لكن بسبب الأوضاع المالية المتدهورة به اضطر إلى العمل حارس ليلي لكي ينفق على عائلته، إلى أن عاد إلى مصر سنة 1985.
الكتابة..
في 1957، كتب أول قصة له بعنوان (العصا الصغيرة)، واشترك بها في مسابقة “نادي القصة” بالقاهرة لكنها رُفضت، ونُشرت أولى قصصه (الصندوق) في مجلة (الآداب) البيروتية عام 1965، ثم تتابع النشر بعد ذلك في مجلة (المجلة)، التي كان يشرف عليها الأديب “يحيى حقي” في منتصف الستينيات من القرن الماضي، بدأ الكتابة الأدبية خلال فترة السجن، حيث كتب روايته (أيام الإنسان السبعة)، والتي صدرت في عام 1969 عن “دار الكتاب العربي”، والتي ترجمت إلى الإنكليزية في 1989، وصدرت له روايته (محاولة للخروج) في عام 1978، وصدرت له مجموعته القصصية (الأشواق والأسى)، والتي ضمت تسع قصص في عام 1984، كما صدر له في “كتاب الهلال حكايات للأطفال” بعنوان (الصغيران وأفراخ اليمامة) في عام 1990، كما صدرت مجموعته القصصية (ديوان الملحقات) في سلسلة “مختارات فصول”.
وصدر بعد رحيله في العام 1991، كتابه (الديوان الأخير) عن “دار شرقيات” الذي ضم 17 قصة قصيرة؛ وعدة فصول من روايته، التي لم تكتمل، (كفر سيدي سليم)، والمسرحية الوحيدة التي كتبها لإذاعة البرنامج الثاني عام 1988، (ليل وفانوس ورجال).
الريف..
يقول الكاتب، “سعد القرشي”، في مقالة له عن “عبدالحكيم قاسم”: “يمكن للقارئ أن يرصد السيرة الذاتية والإبداعية لعبدالحكيم بقراءة أعماله. ففي رواية (قدر الغرف المقبضة) 1982، رحلة شاب ريفي حالم بالعدل، تؤرقه المعرفة وقوة الملاحظة منذ صغره، إذ يرى «التدين والفسق يختلطان هنا بطريقة محيرة»، ويعجز عن المواجهة، ويفشل في تجاوز أسوار التقاليد، ويضيق بالأسقف الواطئة العطنة فيلجأ إلى المناورة، إلا أن جولاته ومحاولاته تنتهي «نهاية مروعة حينما تفترسه الغرف المقبضة وتقضي عليه». يحلم ببيت يسع عالمه الرحيب، فيطارده القبح من القرية إلى المدن الصغيرة والكبيرة، إلى قهر السجن، إلى برلين، التي تأكد له فيها «إحساسه العميق بأنه غريب وغير مرغوب»، ولا يجد عزاء إلا في عطر الأحباب. أعيد قراءة (قدر الغرف المقبضة) فأرى القهر يتعقبه في ألمانيا. قال لي إنه كان يتجنب الكلام مع زوجته باللغة العربية في حضور آخرين.. خلال التغريبة الألمانية كتب مسرحية من فصل واحد عنوانها (ليل وفانوس ورجال)، وعدداً من أبرز أعماله القصصية والروائية القصيرة، ومنها (الأخت لأب) و(رجوع الشيخ) و(المهدي)، أما (طرف من خبر الآخرة) وصدرت في كتاب بالقاهرة 1986 فهي فريدة، عمل رشيق يواجه الفناء بكبرياء لا تخفي الهشاشة أمام المجهول، تحدٍّ لكابوس الموت بكتابة فيها من الشعر شفافيته المستعصية على الشرح، عمل يسعى إلى تحويل تجربة الموت إلى معرفة جمالية”.
ديوان الملحقات..
يقول الكاتب، “محمد عبدالله الهادي”، عنه: “(ديوان الملحقات) هو آخر مجموعة قصصية للأديب الراحل «عبدالحكيم قاسم»، وتحمل المجموعة قدراً هائلاً من الحزن والأسى، ومحاولته المستميتة القبض على لحظات الفرح العابرة في أفق حياته، كان يتمثل الموت ـ موته ـ بحضوره الطاغي والقادر بين القصص، وكتابات «عبدالحكيم قاسم» عن القرية ـ كما في هذه المجموعة ـ تعتبر ذات خصوصية شديدة لها مذاقها وطعمها ونكهتها، الريف عنده له طابع خاص يتميز به عن كتابات القرى الأخرى للمبدعين الآخرين، خاصة أبناء جيله، جيل الستينيات، كان يكتب بتنوع وثراء وحب عميق لناسه وأرضه، كما كان مولعاً باللغة التي كان يعشقها، ينحت منها جملاً وعبارات جميلة ورصينة في آن، كلمات ينتقيها من المعجم تبدو عامية لكنها فصحى، كما كان حريصاً ألاَّ تطغى جماليات اللغة التي يعشقها على مفردات المضمون فتهمشه أو ترهله أو تنفيه أو تبعده عن موقعه في القص. وتتميز قصص المجموعة مثل قصص مجموعاته السابقة بعدم الغموض أو الإغراق في الرمز، كما لم تستهواه محاولات التجديد الحداثية التي إستهوت أبناء جيله”.
أيام الإنسان السبعة..
يقول “عبدالحكيم قاسم”، في أحد الحوارات عن روايته الأولى (أيام الإنسان السبعة): “كنت قد تقدمت بمجموعة قصصية لدار الكاتب العربي، وسألني أسعد حليم إن كانت عندي رواية، لأن الكل من الأدباء الشبان قدموا قصصاً قصيرة، وكنت قد كتبت وقتها ستة فصول من رواية (أيام الإنسان السبعة)، لكنني قلتُ له نعم وأسرعت إلى بيتي وكتبت الفصل السابع في ذات الليلة، وكانت في الصباح الرواية على مكتب حليم، ومر عام والرواية لم تنشر، فذهبت إلى الشاعر صلاح عبدالصبور، وكان وقتها مسؤولاً عن النشرة فذهبت إليه غاضباً متجهماً، لكنه حدثني برفق ودعاني إلى فنجان قهوة، لكني رفضت، فقال صلاح: أنت حر في رفض الدعوة لكن الكتاب سينشر.. وكتب عبدالصبور عن روايتي تلك كتابة رائعة أعدها من أفضل ما كتب عن روايتي، وقد نقل الشاعر صلاح عبدالصبور أمر نشر روايتي إلى د. سهير القلماوي، وكانت وقتها رئيس مجلس إدارة دار الكاتب العربي، وعرفت أن د. سهير أصرت على أن تنشر الرواية فوراً. لقد كان وراء نشر روايتي الأولى ثلاثة أشخاص؛ هم: صلاح عبدالصبور وسهير القلماوي وأسعد حليم”.
عشق الكتابة..
عن عشقه للكتابة يقول “عبدالحكيم قاسم”: “كنت شغوفاً بموضوعات الإنشاء التي نأخذها في المدرسة، هذا الشغف كان يضنيني، فمرة أكتب قطعة نثرية ومرة أكتب بيتاً من الشعر، ثم عرفتُ الفرق بين تلك الأجناس الأدبية عرفتُ الكتابة في خطاباتي التي كنت أكتبها إلى أقاربي وأصدقائي، نعم بدأت رحلتي مع الكتابة للآخرين من خلال خطاباتي إليهم، والحقيقة كانت هذه الخطابات محاولة لفهم مشاعري، وبدأت أعرف أنني قوال أُحمس الناس ويتحمسون لي، فكنت سعيداً بكسب حب الناس وشوقهم لي، فأنا أتكلم بطريقة خاصة يسمعها الناس مني.. رغم كتابتي للكثير من الشعر إلا أنني كنتُ ميالاً وعاشقاً للنثر. وقد نشرت أشعاراً وقصاصات من تأملات في مجلة الحائط في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وكان هذا أول لقاء لي مع الجمهور”.
الكتاب العرب..
في رسالة من “عبدالحكيم قاسم” إلى الناقد السوري، “بطرس الحلاق”، بتاريخ 5/6/1981، في برلين الغربية يقول رأيه في الكٌتاب العرب: “أخي بطرس.. المخيف في الكُتاب العرب أنهم حادوا السمع؛ ويكثرون الجلوس على المقاهي وسماع المقابلات والتضادات والسجع والبديع والجناس الذهني. وينقصهم دائماً اللمحة النافذة إلى العصر… إنه جيل كامل كان في عصر عبدالناصر مخبوط على رأسه. وجاء السادات وصفى التركة، والورثة لا زالوا ذاهلين ينظرون. ثمة كتب تنشر وتهمل، أو يتحمس لها أو يساء فهمها. قليل هو الكتاب الذي يفهم ويلاقى اهتماماً ما يوازي بالضبط قيمته الحقيقية. هنا يكون دور الكاتب أقصد الناقد.. إنه يحدد قيمة الكتاب بالنسبة للحظة التاريخية التي تعيشها الأمة؛ ويطالب له بما يوازيه من اهتمام. وتصوري أن الناقد تكون وظيفته إما واعية واضحة تماماً له، أو هي غريزة عنده بعد قراءة وإطلاع واسعين”.
الثمانينيات..
يقول الكاتب، “شعبان يوسف”، في مقالة له عن صدمة “عبدالحكيم قاسم”، حين عودته لمصر: “السنوات التي قضاها عبدالحكيم في مصر، هي التي تلت عودته في الثمانينيات، وسبقت رحيله في 1991، كانت مصر قد تغيرت كثيراً، ولم تكن تلك التي يريدها أو يحلم بها، ولم تحتف به المؤسسات كما يليق بكاتب كبير، وحتى الآن لم تصدر أعماله الكاملة، لذلك وغيره أصيب عبدالحكيم بمحنة مرضية كبيرة، أربكت مشروعه الأدبي، الذي لم يكن قد إكتمل كل ذلك دفع عبدالحكيم للبحث مراراً وتكراراً عن هوية مصر، رغم أنه كان يكتبها بالتفاصيل في كل إبداعاته، فتعرفنا على ما كان غائباً، وما كان يتوارى، وما كان ملتبساً، وفى روايته (قدر الغرف المقبضة)، تنقل بنا قاسم في كل الأماكن التي سكنها، وتألم فيها، وكان قد إختصر ذلك الألم بعد عودته بجملة قصيرة في إحدى قصصه، (طبلة السحور) 11/10\1986، عندما قال: «إنني لما رجعت من غربتي الطويلة، مشيت بظهر البلد متردداً متحذراً خجلاناً، أقرئ السلام مداهناً متزلفاً، ويجيء رد السلام مرحباً جهيراً، لكن السمع لا يخطئ الصمت متكوراً في قلب الصخب، تنتكس اللهفة ويبور القصد الحسن».. ولكن «حكيم» راح يفتش بعيداً عن قلعة الإبداع، ليكتب دراسات وأبحاثاً ومقالات ليكشف لنا بعض أسرار الهوية، فكتب سلسلة ذهبية من المقالات القصيرة في جريدة (الشعب)، ومجلة (الهلال)، ثم كتب مجموعة دراسات لافتة، ومن أهم تلك الدراسات كانت تلك التي نشرها في عام محنته المرضية «1986» في مجلة (البيان) الكويتية، تحت عنوان (عن الغناء)، والدراسة جاءت في 30 صفحة، ورغم أنه لم يكتب سيرة ذاتية، بشكل مباشر، إلا أن تلك الدراسة أعتبرها نوعاً من الإخبار عن تلك السيرة المبثوثة في نصوصه الإبداعية، وهذه الدراسة تكاد تكون نصاً إبداعياً مختلفاً”.
عنيداً وقوياً..
تقول “إيزيس عبدالحكيم قاسم”، في حوار لها بصحيفة (الوفد): “أعتقد أنه كان كتاباً مفتوحاً لكل من كان يعرفه، حتى في فترة سفره وإغترابه عن مصر سنة 1974 إلى ألمانيا الغربية قبل الدمج ما بين ألمانيا الشرقية والغربية، كان يراسل أصدقاءه من هناك ونشرت هذه الرسائل، ومنها تستطيع أن تعرف ويعرف الوسط الثقافي والأجيال الجديدة من هو عبدالحكيم قاسم، أبي كان عنيداً وقوياً ولديه قدرات شديدة على التحمل.. أبي كما قال عن نفسه تربى على الفرن.. في الغرف المعتمة. وأكل اللقمة الحاف. وسبح في الترع الآسنة، فمن بعد ذلك يستطيع أن يغير أفكاره أو إنتماءاته أو حبه للوطن”.
وحول رضاه عن ما أنجزه على مستوى الكتابة، تقول “إيزيس”: “نعم.. كان يقول ما أنجزته ككاتب وكإنسان ربما يكون قليلاً إلى حد ما. لكن في نهاية الرحلة أنا راضٍ. كان يقول وهو مفعم بالرضا والهدوء مع النفس ومع الآخر في أيامه الأخيرة أنا إجتهدت في حدود جهدي.. وهذه الإمكانيات التي منحنى إياه الله.. وعلى قدر هذه الإمكانيات إجتهدت. كان يقول بصدق ورضا: أعرف أنني لست نجماً في سماء الكتابة المصرية، لكن في الوقت نفسه أنا كاتب موجود في زاوية ما في ضمير القارئ المصري والعربي”.
اللغة المميزة..
تتناول، “د. أماني فؤاد”، لغة “عبدالحكيم قاسم” في أعماله في مقالة لها، تقول: “وتبقى اللغة وتكويناتها المتنوعة علامة مميزة وفاصلة في سرد عبدالحكيم قاسم، لغة تدعو إلى التوقف النقدي طويلاً خاصة في آخر أعماله (ديوان الملحقات)، اللغة حادة، تدعوك للتوقف مراراً، لغة لا تتسم بالإنسيابية ولا السلاسة إلا بعد القراءة الثانية أو الثالثة، وهو إختيار لم يبرز بتلك الدرجة في نصه المبكر (أيام الإنسان السبعة) فقد كانت لغته أكثر سلاسة.. تظهر المفردات في ديوان الملحقات فصيحة تميل إلى الغربة لخروجها النادر من المعاجم، تفصح عن عشق المبدع للغة العربية في صورتها التراثية غير المتداولة في بعض الجمل والفقرات، لكن استخداماته لبعض المفردات المعجمية المهجورة لا يصنع غموضاً في المعنى، يستخدمها بالقدر الذي يظل النص فيها مفهوماً، ولا تحدث قطيعة أو جفوة بين النص ومتلقيه، ويبقى السياق عاملاً مؤثراً في فض ندرتها في الاستخدام، مفردات من قبيل «بلاقع، أشفينا، تأريق»، وغيرها كثيراً.. ينضاف إلى ذلك اختياراته للصيغ الصرفية: صيغ المبالغة والإشتقاقات أو غيرها من التكوينات الصرفية من قبيل قوله صخابون، يتخلع، أهرمها السن، زمتت، يبرجس، مع ملاحظة طبيعية النكهة الريفية التي تلون بعض تلك المفردات”.
وتواصل: “فاللغة عنده لغة مزدحمة، حبلى بالأمطار الغزيرة، فهي إضافة إلى رصانتها كمفردات وهندسة الجملة ذاتها، تزخر بالتشكيلات المجازية المتجددة غير المعهودة، لمَّ حملت به نصوصه أفك القضايا الإنسانية في صورتها الأعمق، وللبعد الصوفي الذي تحويه أعماله.. فللقاص قاسم طريقة خاصة لصياغة جمله وفقراته، وهى طريقة جبلية تدعو إلى التوقف والتأمل لأبعادها النفسية والإبداعية، نلمح حدة في استخدامه للضمائر، وإصرار متعمد على ضرورة ذكرها، وثبتها في أول الجمل، كأن يقول في نص (ترديد ألمانى): «فإذا رآه الأسود تحفز، وهو حدج الأسود بنظرة يتطاير فيها الشرر».. في الشواهد السابقة قد أفسر الأمر بأنه يتعلق برؤية المبدع لإبراز الاختلاف بين الجنسيات والعرقيات، وبين طبائع الشخوص برغم قرابتهم، يرصد لتحولاتهم، لذا يركز النص على الضمائر ليبرز في ذبذبات حادة غير إنسيابية هذه الاختلافات، ليشير ضمناً إلى التباين بين البشر، وأحياناً إلى جحيم الآخر.. لقد تلونت جمل «عبدالحكيم قاسم» برؤيته لشخصياته ونماذجه وطبائعهم المختلفة، وأتصور أنها تضمنت حتى رؤيته لذاته وأقنعتها، وهو ما جعل جمله تميل إلى الجملة الأسمية أكثر من الجمل الفعلية – التي هي الأصل في العربية – ويرجع هذا لتلك الرؤية التي رأى بها الآخرين من حوله، رؤيته للأفكار المتناقضة والمتعايشة التي تحيط بالإنسان وتجعله واقعاً في ثنائية حتمية، لم يخفف من هذه الحدة في أدبه سوى تجربته الصوفية في الإبداع، كما أن غلبة الأسمية قد ترجع إلى ميل إبداعه السردي إلى المناطق الشعرية وجوهرها وما يميزها من ذاتية وغنائية”.
أعماله..
مجموعاته القصصية:
الأشواق والأسى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1984.
الظنون والرؤى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1986.
الهجرة إلى غير المألوف، دار الفكر للدراسات والنشر، 1987.
ديوان الملحقات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1990.
الديوان الأخير، دار شرقيات، القاهرة، 1991.
رواياته:
أيام الإنسان السبعة
قدر الغرف المقبضة.
طرف من خبر الآخرة.
محاولة للخروج.
المهدي.
وفاته..
توفي “عبدالحكيم قاسم”، في 13 تشرين ثان/نوفمبر من عام 1990، بعد رحلة طويلة مع المرض.

