خاص: إعداد- سماح عادل
“عادل صادق عنّو العامل” شاعر ومترجم عراقي، من مواليد ١٩٣٩ في الأنبار. عاش طفولته في ناحية الغراف- ذي قار، ثم انتقل إلى بغداد في أوائل الخمسينات وأكمل دراسته الثانوية والجامعية فيها. وحصل على بكالوريوس في اللغة الانجليزية،عمل في مجالي التدريس والصحافة. غادر”عادل العامل” العراق في عام ١٩٨٢، وكتب الشعر في مراحل متقدمة من عمره. كما نشر في العديد من المجلات العربية.
من أعماله:
– قصائد من زمن العشق، شعر.
– قصائد للسيدة الجميلة، شعر.
– الحديقة تغادر أسوارها، شعر.
– عندما تضحك المدينة وتبكي، قصص قصيرة.
– قلب بسيط، رواية قصيرة مترجمة ل”جوستاف فلوبير”.
– ثلاثة وجوه للذئب، قصص للأطفال.
من أين يأتي الديكتاتور..
في مقالة له بعنوان (من أين يأتي الدكتاتور؟) يكتب “عادل العامل” عن تشابه ظروف نشأة الطغاة: “يوصف الحاكم في العادة بالطاغية، أو الدكتاتور، أو الحاكم بأمره، أو المستبد، تبعاً لطريقة إدارته للبلد، والتزامه بنصوص الدستور، وموقفه الفعلي من حقوق الإنسان، ودرجة مشاطرته الآخرين الرأي واتخاذ القرار بشأن القضايا العامة. ويعتمد هذا على جملة من الأمور التي تشكّل شخصية الحاكم، بطبيعة الحال، منها نوع نشأته الأولى، وأسلوب تربيته في الأسرة، وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه، وسلامته النفسية أو العقلية، وثقافته الشخصية، وطريقة وصوله إلى السلطة.

ويُلاحظ من السيرة الشخصية لعدد من الحكّام في العالم، أن طاغية لم يحكم بلداً من البلدان وكان سليم النشأة والتعليم والانتماء الحضري، إلا في النادر. فقد ولد الطاغية الألماني أدولف هتلر في بلدة بروناو النمساوية الصغيرة لأبٍ وأم لم يعقدا قرانهما إلا بعد سنوات؛ والسوفييتي ستالين في قرية غوري الجورجية لأب إسكافي وأم فلاحة في وضع القنانة وكان الأب مدمناً على الكحول ودائم الضرب لستالين وأمه؛ والتشيلي بينوشيت في مدينة فالباريسو لأبٍ ينحدر من مهاجر فرنسي وأم تنحدر من أصلٍ باسكي؛ والدومينيكاني تروخييو في مدينة سان كريستوبال لوالدين ينحدران من أصول متعددة ولا يُعرف تاريخ سنواته المبكرة بعد أن كلّف أحدهم وهو في السلطة بكتابة تاريخه الشخصي؛ والسوري حافظ الأسد في بلدة القرداحة الصغيرة؛ والمصري جمال عبد الناصر في الإسكندرية لأب صعيدي من قرية بني مر في محافظة أسيوط كان يعمل وكيلاً لمكتب بريد.
والزائيري موبوتو في مدينة ليسالا وكان والده يعمل طباخا عند حاكم ليسالا ومات والده وهو ما يزال بعمر ثمان سنين ثم رباه جده وعمه؛ والأندونيسي سوهارتو في كيميوسوك، الهند الشرقية الهولندية لأسرة تشتغل بالزراعة وعاش متنقلا بين أمه وأبيه وأقاربه بعد انفصال والديه ولم يكن قد جاوز عمره السنتين؛ واليمني علي عبد الله صالح في قرية بيت الأحمر بسنحان خارج صنعاء لعائلة فقيرة وفقد والده مبكرا وتربى على يد زوج والدته في تلك القرية وكان يرعى الغنم، وعمل سائق مدرعة في الجيش.
والأوغندي عيدي أمين في بلدة كوبوكو وهجره أبوه طفلاً فعاش مع أسرة أمه، ومعمر القذافي في قرية (جهنم) بمنطقة سرت في عائلة بدوية بسيطة الحال… و سنجد ما يشابه هذا بالنسبة لبقية الطغاة في العالم في الماضي والحاضر”.
وبالنسبة للعراق يواصل: “وإذا استعرضنا تاريخ الذين حكموا العراق، مثلاً، بعد انقلاب 1958 على النظام الملكي، وجدنا أن عبد الكريم قاسم ولد في محلة المهدية ببغداد ووالده من عشيرة الزبيد وكان يمتهن النجارة، وقد عاش عبد الكريم فترة شبابه متنقلاً بين بلدة الصويرة وبغداد، والشامية حيث عمل معلماً، ثم مناطق أخرى مختلفة فيما بعد بحكم عمله في الجيش؛ وولد عبد السلام عارف في بغداد في أسرة تعمل في تجارة الأقمشة متحدرة من منطقة خان ضاري، إحدى ضواحي الفلوجة، وكان جده شيخ عشيرة الجميلة؛ وولد أحمد حسن البكر في بلدة تكريت لأب كان يعمل قاطعا للتذاكر في السكك الحديدية.
وولد صدام حسين في قرية العوجة التي تبعد 23 كم عن تكريت وعاش طفولة بائسة، بعد وفاة أبيه الغامضة وزواج أمه قارئة الطالع من عمه التسلّطي الذي كان يعامله بازدراء ويقسو عليه كما هو معروف. وجميع هؤلاء جاءوا إلى السلطة بانقلابات عسكرية أو حركات تآمرية، واستبدوا بالسلطة حتى يوم إزاحتهم عنها بمثل الطريقة التي جاءوا بها تقريباً. وهكذا يندر، في هذا الإطار، أن تجد حتى بين الذين كانوا قياديين في الانقلابات والمحاولات الانقلابية في العراق مَن كان من أهل بغداد الأصليين، بوجهٍ خاص، على حد علمي”.
وعن الظروف الملائمة لنشأة الحاكم الجيد يكتب: “فلو كان الحاكم من أسرة ميسورة ومعروفة ذات امتداد حضري من أهل العاصمة أو مدينة كبيرة، ونشأ في ظروف طبيعية، وعاش حياةً مستقرة، وجاء إلى السلطة بطريقة ديمقراطية أو تصعيدية وفقاً للكفاءة واحترام الرأي العام، لكان في الغالب أقل ميلاً للاستبداد، والانفراد بالرأي واتخاذ القرار، والرغبة في البقاء حاكماً حتى يُزاح بالقوة.
والسبب في ذلك أن ابن العاصمة أو المدينة الكبيرة بوجهٍ عام أكثر ميلاً للوضع المستقر، والتزاماً بقواعد المجتمع المدني، واحتراماً لمعايير الخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة، لأن الحياة المستقرة الطويلة تفرض الأخلاقيات التي تخدم استمرارها ومصلحة سكانها من وراء ذلك. بينما لابن الريف أو الصحراء قناعاته ومفاهيمه الخاصة المختلفة المنبثقة من بيئته المتخلفة حضارياً.
وتقاليد وسطه الاجتماعي الضيق، وتطلعاته الرومانسية إلى حياة المدينة الكبيرة الزاخرة بالمغريات مقارنةً بشظف العيش والركود الذي هو فيه. وإذا أضفنا إلى ذلك ما يتولد لدى البعض في طفولتهم من عقد نفسية مرتبطة بسوء المعاملة، أو اليتم المبكر، أو الكبت الطويل، تحول ذلك إلى رغبة جارفة للتعويض عن القهر بطريقةٍ ما، كالسلوك الإجرامي العادي، أو الإرهاب، أو الوصول إلى السلطة بأي وسيلة كانت، الاغتيال، التزوير، الاحتيال، الانقلاب العسكري، الاستعانة بالأجنبي، إلخ.
وهكذا، واستناداً على ما ورد أعلاه، وتجارب الماضي والحاضر، والدراسات العلمية والاجتماعية، فإن على الناس، في الظروف الاعتيادية بطبيعة الحال، أن يدققوا جيداً في تاريخ مَن يختارونه لحكمهم، أو مَن ينسلّ إليه بطريقةٍ ما، ويناضلوا لسد الطريق أمام الحاكم الذي لا يجدونه مطابقاً للمواصفات السليمة، بكل قوة ووعيٍ و إصرار.
لأنهم إن لم يفعلوا هذا خوفاً من خسارة مكسبٍ ما، أو مقتل فردٍ أو عشرة، على سبيل المثال، فإنهم ربما خسروا كل شيء و فقدوا مئات الآلاف من أبنائهم ثمناً لإسقاط الطاغية، أو في أعقاب إزاحته عن السلطة، بفعل تراكمات عهده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتأزمة محلياً ودولياً. وها هي الصومال، والعراق، وسوريا، واليمن، وليبيا … شواهد حية على ذلك. لكن هل يمكن أن تكون هناك سلطة من دون دكتاتورية بطريقةٍ أو بأخرى؟ ذلك أمر يتطلب حديثاً آخر”.
العلاقة الإبداعية بـين المؤلف والمحرر ودار النشر..
وفي مقالة هامة بعنوان (العلاقة الإبداعية بـين المؤلف والمحرر ودار النشر) قام بترجمتها “عادل العامل”يكتب: “هناك صلة قوية بين قوة التقليد الروائي في البلد ونفوذ المحرر. ويستشهد أندرَي غاسبارد من دار” كتب الساقي” بحقيقة أن الروايات شكل أدبي جديد نسبياً في اللغة العربية كسبب من الأسباب الكامنة وراء عدم وجود تقليد تحريري قوي في العالم العربي، كما تقول ريبيكا كارتر في مقالها هذا. أما في الهند، فإن التحرير ينتعش فقط في النشر باللغة الانكليزية، والسبب في ذلك جزئياً أن اللغات الهندية الأخرى لها تقاليد نشر مختلفة بالنسبة للأدب القصصي (سَلسلة القصة في المجلات، أو تعاونيات مؤلفين مثلاً) لكن أيضاً بسبب سيادة الرواية.
وقد ذكر العديد من المحررين الهنود العمل المؤثر لدَيفيد ديفيدار مع فيكرام سيث في رواية (ولد مناسب). وتأثير الطرق البريطانية والأميركية هنا واضح، وهذا يسري من دون القول بأن “المحرر الأميركي” يُعتبر على الدوام المثال الأسمى لشخص قادر على خفق الرواية إلى شكل. وحين بحثتِ هذه القطعة، بدأتُ أدرك أن تاريخ تقليدٍ بلغ أوجه في أمثال ماكسويل بيركينز كان أكثر من موضوع لرسالة الدكتوراه في الفلسفة، وليس شيئاً ما أعطيه حق قدره هنا. وقد قام هانز جيورجين من دار فيشر بألمانيا من أجلي بتتبع أثر خط يمتد من إيراسموس ومانيوتيوس إلى ناشري القرن التاسع عشر الألمان العظام مثل رودولف شتاينر، الذين استجابوا للتصاعد في معرفة الكتابة والقراءة والطلب الملازم لها على أدب يمكن شراؤه.
فتحدَّث عن تأسيس دار فيشر فيلاغ في عام 1886 وصداقة العمر بين مالكها والأديب الألماني توماس مان. وواضحٌ أن هذه التقاليد كان لها تأثيرا كبيرا على النشر الأميركي، الذي رد في المقابل بتأثيره، مصدّراً ليس الروايات الملهمة فقط، بل وفكرة المحرر الإبداعي أيضاً”.
وعن أسباب وجود محررين أقوياء يواصل: “لكن إذا كان التقليد الروائي لازماً لوجود محررين أقوياء، عندئذٍ يكون هناك اقتصاد يستطيع أن: أ) يدفع تكلفة الترف، وب) قِيَم الترف. ففي هولندة يمكنك أن تدرس الأمور العملية للتحرير في الجامعة. وفي الدانمارك، تقوم (مدرسة الكتّاب الوطنيين) بتعليم الطلبة “أن يتوقعوا التشاحن مع محرريهم”، وفقاً لتعبير جوهانيز ريس من دار جيلديندال. وفي كلا هذين البلدين، يمكن وضع المهارات المتعَلَّمة موضع التطبيق داخل دور النشر.
أما في روسيا، فإن الصورة مختلفة نوعاً ما. فمعهد الأدب بموسكو يرعى المحررين الشباب، لكن المحررين المدرَّبين هناك، وفقاً للوكيلة والمحررة أيلينا كوستيوكوفيتش، لا يمكنهم أن يجدوا وظائف لهم لأن صناعة نشر ما بعد المرحلة السوفييتية فتية جداً على تطوير تقليد تحريري خلال هذه المدة. وبدلاً من ذلك تركز على طباعة أكثر ما يمكن من المطبوعات وبأقل تكاليف إنتاج ممكنة. وفي مثل هذه البيئة على “المحرر” أن يُصبح مركّزاً على كتابة النسخة والعثور على فرص انتشار للمؤلفين.
هذا النوع من التوجه التجاري القاسي مجرد بداية للتأثير في محررين في أماكن مثل هولندة وألمانيا. ويكتب هانز جيورجين بالمز عن كيف أن “المزيد والمزيد من المهام يجري تكديسها على مكتب المحرر، جاعلةً إياه يبدو مثل مدير إنتاج ذي عملية معقدة جداً، وتاركةً له القليل من الوقت ليعنى بحاجات المؤلف. “لكنه لا يعتقد بأن مفتاح التحويل من “محرر” إلى “مدير إنتاج” قد تم بشكل كامل. إن ذلك فقط “على الأفق”، يقول بالمز، وسيكون غير سعيد لو حدث ذلك”.
ويضيف: “ويبدو أينريك موريلو أقل تفاؤلاً بشأن علاقة دور النشر الأسبانية بمحرريها، حيث يقول: “في أسبانيا، المحررون مثل الخنازير في معمل نقانق: رائحتهم سيئة، لكن من الصعب الاستغناء عنهم. أما في هولندة، فإن الجهود المبذولة للتخلص منهم تحقق نجاحاً أكبر فأكبر. وفي بعض الشركات المتحدة الكبيرة، فإن المحرر مجرد شخص يقرأ تقارير قرّاء، وليس كتباً حتى. “والأمل، بالنسبة لموريلو، هو في النتاج الجديد من دور النشر المستقلة الصغيرة، حيث يؤخذ الوقت للعمل مع المؤلفين، وذلك على وجه التحديد اتجاه حديث بأن العلاقة الإبداعية بين المحرر والمؤلف آخذة بالانتقال من شركات النشر الكبيرة.
إن العموميات أمر خطِر، مع هذا، عند مناقشة بيان يتعلق كثيراً بأفراد وعلاقات شخصية. وغالباً ما يذكر المحررون البريطانيون والأميركيون اعتقاداً بأن المحررين، في بلدان أخرى، لا يحررون، لكن هذا لم تفرزه محادثاتي مع ناشرين أجانب. فالشيء الوحيد الذي ميَّز جميع المحررين الذين اتصلتُ بهم هو تشوقهم للحديث عن موضوع التحرير، وحبهم لِما يقومون به. وكانت لديهم جميعاً قصص عن محررين استثنائيين: كارلوس بارال، الذي أتى بأدب حديث إلى أسبانيا في الخمسينيات والستينيات والذي يعزو إليه الروائي البيروي بارغاس يوسا الكثير من الاقتراحات المفيدة بشأن نتاجه؛ أو غرازيا تشيرشي في إيطاليا، وهي امرأة استثنائية، قامت برعاية مؤلفين من أمثال ستيفانو بيني وأليساندرو باريكو، وهي تتتبع رواياتهم عبر مسودات كثيرة، و تزورهم في بيوتهم، حاملةً إليهم وجبات طعام ليقدموها إلى أشخاص نافعين لهم.
وتقتبس كلارا كابيتو من الروائي البرتغالي البارز أنطونيو لوبو أنطونيس قوله “أن تجد، في البرتغال، محرراً عظيماً أصعب من أن تجد كاتباً عظيماً. “لكن هذا كان في سياق تفجّعه على الموت المبكر لمحررته، التي قال إنه لم يكن يتخيّل تقريباً أن يواصل العمل من دونها”.
وعن إنكار الجميل من قبل الكتاب تجاه المحررين: “و لا يتلقى المحررون على الدوام مثل هذا الاستحسان العلني من الكتّاب الذين يعملون معهم. وقد قالت لي ميوغ سوكمَن من دار ميتيس في تركيا إنها، في الثمانية والعشرين عاماً من عملها التحريري، لم يشكرها علناً سوى مؤلف واحد على مساعدتها في إظهار كتابه بالشكل الذي حقق له النجاح. وتوضح ميوغ في تواضع أنها لا تتوقع تشكراتٍ علنية: فمن عمل المحرر، بعد كل شيء، أن يجعل الكتاب أفضل. لكن ما يهمها أنه إذا ما رفض مؤلف أن يعترف بدور المحرر في نجاحه، فإن المؤلفين لن “يحاولوا أبداً كتابة نصٍ أفضل، بل يعتمدون دائماً على آخرين في إصلاحه”.
وهذا في الحقيقة بعيد جداً عن استحضار ألبيرتو رولو للكيمياء الإعجازية تقريباً التي تحدث حين يكون المؤلف والمحرر منفتحين أحدهما على الآخر. “فبطريقتين مختلفتين جداً، لا يعود النص الذي اشتغلا سويةً عليه راجعاً لهما. ويعود المحرر إلى مؤسسته. ويرجع المؤلف إلى حياته. والوقت الذي تشاطراه بعيد تماماً عن المؤسسة وعن عملها التجاري مثلما هو بعيد عن أنا الكاتب ورغبتها في التعبير عن ذاتها. لكنه وقت أساسي، وإلا فشل الكاتب، وفشل المحرر، وفشل النشر”.
أهمية القارئ..
وعن وجود عنصر مهم يكمل العملية: “وتعتقد آمي سبانغلر، وهي وكيلة تمثّل مؤلفين أتراكاً، بأن هذه الكيمياء تحتاج إلى عنصر ثالث: القارئ. و هي متفائلة بشأن مستقبل التحرير في تركيا. و كما ترى، “فإن جمهوراً متنامياً في الوقت الحالي من القراء المتفتحي الذهن سيطلب من ناشريهم ما هو أفضل، ولهذا سيكون الناشرون مجبرين على السماح لمحرريهم بوقتٍ أكثر لتكوين عناوين فردية. وسيكون على الكتّاب بدورهم أن يُصبحوا معتادين على انفتاح أكثر للنقد وتلقي المشورة”.
وعن النشر الرقمي: “ولك أن تدعوها خيالية إذا شئتَ، لكن تلك هي رؤيتي. “وأعترف أنا بأنها رؤيتي أيضاً، وإلا فإنني يمكن أن أكون قد تخليت عن العمل الآن. وفي كتاب أقوم بنشره لاحقاً هذا العام، (2011)، عنوانه (هذه ليست نهاية الكتاب)، يتحدث أمبيرتو أيكو عن كيف أن الكتاب، بالنسبة للكاتب، لا يمكن إنهاؤه أبداً في الواقع، وكيف أن النشر الرقمي يفتح إمكانية إعطاء القارئ مدخلاً للوصول إلى نصٍ متطور باستمرار.
صحيحٌ أن النص الكامل مثلٌ أعلى مستحيل، لكن الشيء الوحيد الذي سيبقى، برأيي، في الصناعة المتطورة سريعاً التي أعمل فيها هو أن الكتّاب سيريدون على الدوام شخصٍاً ما يتحدثون إليه عن كيفية جعل نصوصهم أفضل. وقد يكون هذا الشخص يعمل في دار للنشر، لكنه قد يكون على السواء عاملاً في وكالة أو مكتبة. والأمر المهم هنا أن يمتلك هذا الشخص رغبةً في أن ينحّي أهواءه جانباً لينغمر في إبداعية شخص آخر، ويساعد في أن تجد هذه الإبداعية شكلاً لها. ولحسن الحظ، هناك أشخاص من هذا القبيل في كل مكان”.
إنقاذ الدولة..
وفي مقالة له بعنوان (ما هكذا تُنقَـذ الدولة!) يكتب “عادل العامل”: “يعاني العراق اليوم من أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخه الحديث، بالرغم من كونه من أغنى بلدان العالم بالثروات الطبيعية وفي مقدمتها النفط، “هادم اللذات ومفرّق الجماعات” لدينا، خلافاً لما هو منتظر منه في البلدان ذات الأنظمة الرشيدة. وتحاول الحكومة الآن بشتى الطرق والمسوغات تلافي هذه الورطة أو المحنة “المفاجئة”.
فتجدها تستقطع الأموال من رواتب وأجور الموظفين والعمال والمتقاعدين، وتفرض الرسوم والضرائب، وتستنجد بأهل الخير هنا وهناك في مختلف أنحاء المعمورة على أساس أن العراق “يحارب الإرهاب نيابة عن العالم”، أو تجعل شبكة الإعلام العراقي تشن حملة تذكّرنا بحملات أيام زمان “كل شيء من أجل المعركة” السيئة الصيت، أما الآن فهي بعنوان “الوطن محتاجك”، تستنفر فيها الشبكة غيرة شيوخ العشائر، و”الناشطين والناشطات”، ومراجعي المستشفيات العامة، وتلاميذ المدارس الحكومية، بل والمقاتلين في الجبهات، وتدعوهم للفرح بإجراءات الحكومة الهادفة إلى تعويض الخزينة العامة على حسابهم عما ألحقه بها اللصوص والمرتزقة والفاسدون من خراب، بينما تتظاهر جماهير الناس ضد الفساد وسوء الأحوال المعيشية، وتعاني الملايين منهم تحت خط الفقر!”.
ويواصل: “ولم نعد نسمع شيئاً جديداً جدياً عن إصلاحات السيد العبادي ومكافحة الفساد بالشواهد والأرقام، بل نقرأ، مثلاً، أن السيد وزير النفط يسعى إلى إنتاج 7 ملايين برميل من النفط يومياً، بمعدات فنية متهالكة، وعناصر فاسدة، ومن دون حساب لمواقف الأطراف المنتجة الأخرى وقدرة السوق العالمية على استيعاب سخاء السيد وزير النفط، بل ومن دون أي اعتبار لاستنفاد الاحتياطي النفطي، ثروة الأجيال المقبلة.
هذا إذا استطاع الأخ تنفيذ “سعيه” بينما البلاء ممسك بتلابيب الدولة والحكومة على وشك الانصراف! فلو نظرنا إلى كل ما تفعله الحكومة وتفكر به في هذا الإطار مع استمرار الفساد ورؤوسه الكبيرة في مواقع السلطة والنفوذ، فإنه سيبدو لنا أشبه بمحاولة إنقاذ سفينة من الغرق بطريقة إفراغها من الماء المتسرب إليها باستمرار من دون سد منافذ التسرب أو معالجة أسبابه. وأي طفل سيقول لك ذلك عدا أطفال السياسة العابثين بمصير البلد، بطبيعة الحال!”.
ويؤكد: “وهذا هو المضحك والمبكي في أمر العراق على الدوام. فبدلاً من معالجة أسباب مشكلةٍ ما بصورة جذرية تحلها وتمنع حدوثها مرة أخرى، يلجأ الحاكم وأنصاره إلى الترقيع أو التسويغ أو المعالجات المؤقتة القصيرة المفعول، بانتظار “غودو” الكاتب الأيرلندي صمويل بيكيت، بدءً بمقولة عبد الكريم قاسم المأثورة بأنه ابن الشعب وفوق الميول والاتجاهات، تهرّباً من الحياة الحزبية الديمقراطية غير المناسبة لرغبته بالبقاء في السلطة، إلى نهب البعثيون الأموال والمصوغات الذهبية من الناس تحت شعار “كل شيء من أجل المعركة” لتعويض الآثار الاقتصادية المدمرة لسياساتهم الكارثية وإرهاب المعارضين ونهب العامّة، إلى استنجاد الحكومة الحالية بالناس البسطاء الحال لإنقاذها من فشل ترقيعاتها، ومن نتائج السياسات الطائشة للحكومة “الفضائية” السابقة. بينما الحل واضح، لكنه صعب بالتأكيد من دون اجتثاث الرؤوس الكبيرة الفاسدة المتحكمة بمفاصل الإدارة والنفوذ، وهي ظاهرة ومعروفة للجميع، ولا يمكن اجتثاثها في ظروفنا الراهنة، كما يبدو، إلا بعملية جراحية أمريكية ليس في مصلحة الولايات المتحدة إجراؤها، أو بثورة شعبية كاسحة لا يعرف نتائجها المدمرة.. إلا الله! وعدا ذلك، يتلخص الحل الآني في ثلاث خطوات فورية أساسية فقط:
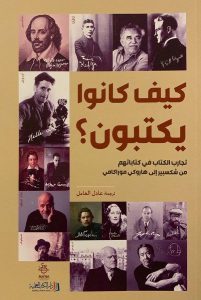
– اعتقال هذه الرؤوس الكبيرة وتقديمها إلى قضاء نزيه حازم.
– تشديد عقوبة الفساد إلى حد الإعدام بوصفه جريمة اقتصادية في زمن الحرب، وخيانة للمسؤولية الوطنية، وخروجاً على تعاليم الدين. والفساد أشد ضرراً بالناس من الزنا والقتل وقطع الطريق، وأحكام الدين في هذه الأمور معروفة ولا يتجادل فيها اثنان!
– استعادة الأموال التي استحوذ عليها أزلام النظام البعثي المباد والحكومات التي أعقبته حتى الآن، وهي وحدها كافية لإنقاذ السفينة، وجعل الوطن لا يحتاج إلى “ملاليم” مواطنيه بل يفيض عليهم بملياراته الوفيرة.
غير أن على رئيس الحكومة القيام قبل ذلك بعمل جريء واحد ليستطيع تنفيذ ما جاء أعلاه: أن يبادر إلى إجراء انتخابات عامة حقيقية، تحت رقابة وطنية وعربية ودولية، تأتي له بمجلس نواب يمثّل إرادة الشعب ويكون نصيراً له وشريكاً فعليا في إنقاذ العراق.. أو أن يرتدي بدلة جنرال، بطريقةٍ ما، ويحكم البلد بمراسيم “ثورية ” بدء بالبيان الأول العتيد إيّاه!”.
وفاته..
فارق “عادل العامل” الحياة يوم الأربعاء ٢١ تموز- يوليو ٢٠٢١ في تركيا.
قصيدة ل”عادل العامل”..
تعليق على هامش امرأة..
زَمَنٌ ..
كانَ لي فيهِ ..
قلبٌ ..
يُحبُّ ..
انتهى ..
الآنَ ..
لا قلبَ لي ..
و لا عادَ لي ..
فيهِ ..
ما أبتغيهْ !
****
ما الذي يجعلُ ..
النارَ ..
مَحرقةً للفَراشِ ..
ويُنبِتُ نَرجِسةً ..
فوقَ كفِّ الحجَرْ ؟!
ما الذي يستفزُّ..
المطرْ ؟!
ما الذي يُوقِظُ الروحَ..
من موتها..
مُشعلاً كهرباءَ..
النظَرْ ؟!
****
أنتِ..
هل أنتِ..
نفسُكِ..
تلكَ التي أشعلَتْ..
غابةَ القلبِ..
عابثةً..
دونما حَذَرٍ..
بالرماد ؟!
أم أنا مُثقلٌ..
بالأسى..
والتمنِّي الجميلِ..
على هامشٍ..
من حياتِكِ..
أبحثُ لي..
عن غدٍ..
لُغةٍ..
أو بلادْ ؟!
حاولي..
حاولي مرةً..
أن ترَي نفسَكِ الآنَ..
خارجَ نفسِكِ..
أو تختفي داخلي..
حاولي
عندَها..
لا تكونينَ شَرنقةً..
بل فضاءً..
نضيرْ!
****
زَمَنٌ..
كانَ لي..
فيهِ قلبٌ..
وفيه …..!

