خاص: إعداد- سماح عادل
كاتب من لبنان، له 3 روايات (الحيّ اللاتينيّ، الخندق العميق، أصابعنا التي تحترق)، وعدد من المجموعات القصصيّة، ومسرحيّة (زهرة من دم). أسس مجلة الآداب سنة 1953، ورئس تحريرها حتى 1991. أسس دار الآداب سنة 1956. ألف قاموس المنهل (فرنسي ــــ عربي) مع “جبور عبد النور”، قبل أن يستقلّ به لاحقًا. أحد مؤسسي اتحاد الكتّاب اللبنانيين، وأمينه العام لدورات عدة. ترجم عشرات الكتب من الفرنسية إلى العربية، وأبرزها مؤلَّفات “جان بول سارتر والبير كامو وريجيس دوبريه”.
مجاهدة ثقافية..
في مقال بعنوان (سهيل إدريس عاش في شبه مجاهدة ثقافية نهضوية اتّسعت لآمالٍ كثيرةٍ) كتب (سليمان بختي): “سهيل إدريس تمرّ ذكراه العاشرة بصمت وخجل، هو الذي كان الروائي، القصّاص، المترجم، الصحافي، الناشر، مؤلّف القواميس، والأكاديمي وأحد مؤسسي اتحاد الكتّاب اللبنانيين. رجل من حروف وكلمات. عاش حياته في شبه مجاهدة ثقافية نهضوية اتسعت همته لآمال كثيرة. نهل العلم من مدارس بيروت، المدينة التي أحبّ والشاهدة على نجاحاته وإنجازاته. درس بداية في المدارس الدينية ولبس العمامة لفترة وخاض صراعاً بينه وبين نفسه والمجتمع ليشقّ طريقاً مغايراً. وكتب هذه السيرة في روايته “الخندق الغميق” 1958 التي انتهت بمغادرته لبنان إلى فرنسا.
ولكن قبل ذلك عمل في الصحافة محرراً في جريدة “أخبار المساء” و”الأنوار” و”الصياد” و”الجديد”. كما أعدّ بعض البرامج لإذاعة “الشرق الأدنى”. سافر إلى فرنسا ملتحقاً بجامعة “السوربون” لإعداد الدكتوراه بمنحتين: الأولى من وزارة التربية والثانية من “جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية”. وكان موضوع أطروحته “الرواية العربية الحديثة من 1900 حتى 1950 والتأثيرات الأجنبية فيها”.
أنشأ عام 1953 مجلة “الآداب” مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي ثم استقلّ بها عام 1956 وعرفت “الآداب” حضوراً وشهرة ودوراً ريادياً في لبنان والعالم العربي. واستمرّت في الصدور منذ تأسيسها 1953 وحتى العام 2012 أي بعد وفاته بأربع سنوات بهمّة ابنه سماح إدريس”.
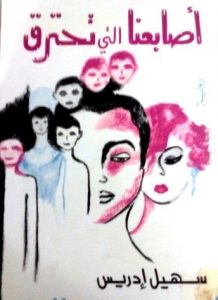
مجلة “الآداب”..
ويواصل عن مجلة “الآداب”: “أراد سهيل إدريس أن يجعل من المجلة منبراً للفكر القومي العربي. ولعلّ نكبة فلسطين هي التي حرّكت لديه فكرة احتضان أدب ملتزم يدنو إلى تعبئة الشعور القومي عند طريق الأدب. وظهر على صفحاتها أدباء ونقّاد وشعراء لبنانيون وعرب كثيرون وأهمهم: بدر شاكر السياب، نزار قباني، خليل حاوي، عبد الوهاب البياني، سعدي يوسف، محمد الفيتوري، بلند الحيدري، صلاح عبد الصبور، أحمد عبد المعطي حجازي وغيرهم. وفي الستينيات ظهر محمود درويش وسميح القاسم وحسب الشيخ جعفر وعز الدين المناصرة وممدوح عدوان وأمل دنقل ومحمد إبراهيم أبو سنة ومحمد علي شمس الدين وشوقي بزيغ واليأس لحود وغيرهم” .
وعن دار “الآداب”: “أسّس مع الشاعر نزار قباني “دار الآداب” واستقل بها في العام 1961 وعرفت الدار أيضاً انتشاراً راسخاً وقوياً في لبنان والعالم العربي. وخصوصاً في مجال الرواية والترجمة لنتاج التيار الوجودي في فرنسا والذي مثّله جون بول سارتر وسيمون دي بوفوار والببير كامو وفرنسواز ساغان. ترجم إدريس أكثر من 20 كتاباً من الفرنسية إلى العربية مغنياً المكتبة العربية. كما درّس مادة الترجمة لفترة في جامعة بيروت العربية”.
وتكملة لسيرة سهيل إدريس يقول: “انهمك بعد حرب 1967 على تأليف القواميس فأنجز “المنهل” مع جبور عبد النور وعمل أكثر من ربع قرن مع صبحي الصالح وابنه سماح على طبعة عربية فرنسية وعربية عربية منه. أسّس عام 1968 مع 4 كتّاب لبنانيين هم قسطنطين زريق وجوزف مغيزل ومنير البعلبكي وأدونيس “إتحاد الكتّاب اللبنانيين” وانتُخب أميناً عاماً لثلاث دورات متتالية. والحال أن الرواية كانت خياره وغرامه الأول ولكن ضاع وقتها في استغراق إدريس في العمل في الترجمة وإدارته لمجلة “الآداب” و”دار الآداب”، لكنه كتب وأبدع”.
وعن الكتابة لديه يقول: “عكست رواياته وقصصه حياته ومرآة أيامه. وبرأيه إن العمل الروائي يجب أن يعبّر عن العام بواسطة الخاص وأن يكون موضوعياً في ما هو ذاتي. كتب “أقاصيص أولى” نشرها كاملة في العام 2000. وكتب “الحي اللاتيني” 1953 وصور فيها إدريس الصراع بين الشرق والغرب ولعلها من الروايات الأولى التي تصدّت لإشكالية الشرق والغرب. قال عنها نجيب محفوظ “الحي اللاتيني معلم من معالم الرواية العربية الحديثة”.
أسمعه كيف ينهي روايته “الحي اللاتيني”: “لا ما أنت بالحالم، وقد آن لك أن تصدق عينيك، أو ما تشعر باهتزاز الباخرة وهي تشقّ هذه الأمواج، مبتعدة بك عن الشاطئ، متجهة صوب عاصمة بلادك. لقد انتهينا إذن الآن يا بني، أليس كذلك؟ فأجابها من غير أن ينظر إليها، لا بل الآن نبدأ يا أمي”.
كما عبّرت روايته “الخندق الغميق” 1958 عن الصراع مع الذات لإيجاد الطريق. لعلّه صراع بين جيلين ومفهومين وبين الجمود والتحرّر وصراع التحولات الاجتماعية. أما روايته “أصابعنا التي تحترق” 1962 صوّرت حياته بعد عودته إلى بيروت وتأسيسه مجلة “الآداب” وفيها رصد لحياة العديد من مبدعي لبنان مثل رئيف خوري وحسين مروه وسعيد تقي الدين وسعيد عقل ونزار قباني وغيرهم. كما نشر سهيل إدريس الجزء الأول من مذكّراته بعنوان “ذكريات الأدب والحبّ” 2002 مستوحياً من تجربته ورماد الذاكرة. وفي الفكر والنقد كتب “في معترك القومية والحرية” و”مواقف وقضايا أدبية”.
ما أزال أذكر في بداية التسعينيات عندما احتفلنا بخمسينية “الآداب” اقترحت على الشاعر شوقي أبي شقرا ـ كانت الصفحات الثقافية في جريدة “النهار” في عهدته ـ تخصيص صفحة للآداب، فقال: لا بل صفحتين واحدة لحوار سهيل إدريس والثانية لشهادات عن المجلة من كتّابها”.
أذكر أنني توجّهت لزيارته في مكتبه ولما تبين سبب الزيارة، قال: “أنت قادم من “النهار” لمحاورتي وبيننا وبين مجلة وشوقي أبي شقرا والنهار ما صنع الحدّاد ولكن لنحاور”.
وأضاف: “مرجعنا في الكتابة الجاحظ وصاحبك شوقي مرجعه كليلة ودمنة”. تعدّدت في ما بعد اللقاءات وكان حواراً مطولاً معه لكتابي “إشارات النصّ والإبداع” 1995، وكان كذلك بيننا ردود في ملحق “النهار” حول كتاب: “يوسف الخال ومجلة شعر” 2004 للمستشرق الايطالي جاك اماتسي. ثم كتب مقالاً نقدياً عن كتابه “ذكريات الأدب والحب”.
في الفترة الأخيرة من حياته بدا سهيل إدريس مسكوناً بما يبقى وبما يزول، يعتصره الهمّ والقلق على لبنان، وعلى ما أنجز وما يهدّده الاندثار والنسيان. ثادراً كأنه يرى ولا يرى”.
الحي اللاتيني..
في حوار معه نشر في 2008 أجراه “الشاذلي زوكار” في 1993 يقول “سهيل إدريس” عن روايته “الحي اللاتيني”: “إنّ الشباب العربي مازالت أمامَه طموحاتٌ من أجل التطوّر والتقدّم، ومازالت أمامَه أسئلةٌ كثيرةٌ تدعوه إلى المقارنة بين واقعه المتهافت وبين حضارة مزدهرة. فكيف له أن يَلْحق، أو أن تَلحق أمّتُه، بهذه الحضارة؟ كيف له أن يؤسِّسَ أو يشاركَ في تأسيس حضارة جديدة تكون تتمّةً للحضارة العربية المشرقة في القرون الوسطى، تلك الحضارة التي التمعتْ في الوقت الذي كانت تنطفئ فيه حضارةُ الغرب؟ كيف لنا أن نبعثَ مثلَ هذه الحضارة وأن نواصلَ مسيرتنا في الحياة العالمية؟
هكذا في الحقيقة استطاع بطلُ رواية الحيّ اللاتيني أن يَطْرح قضايا أعتقد أنّها ماتزال حتى اليوم مطروحةً. فمشكلةُ تصادُمِ الغرب والشرق، ومشكلةُ المثاقفة التي يرفضها دعاةُ التفريق بين حضارتين ومذهبين في الحياة، من المشاكل التي ماتزال مطروحةً، وخصوصًا بعد النكسات الكبيرة التي شهدتْها أمّتُنا العربية. كيف نعي ذاتنا؟ هذه هي القضية التي حملتْها الحيّ اللاتيني، ولو أنّها صيغت في إطارٍ عاطفيّ. والحقّ أنّ النقّادَ العرب، في ما تناولوه من روايات تَطْرح موضوعَ الشرق والغرب وتصادُمهما، قد وضعوا اليدَ على نقاطٍ كثيرةٍ في روايتي هذه، تجعلها حيّةً. وهي الآن تجاوزتْ طبعاتِها العشرَ، وماتزال تدرَّس في الجامعة وتُختار للمطالعة. أقول، إذن، إنّ الحيّ اللاتيني قصّةُ فرد، ولكنّها قصّةُ جيلٍ وأجيالٍ”.
وعن الحب في أعماله الأدبية يقول: “في موضوع الحبّ، سبق لي أن رويتُ قصّةً حدثتْ لي، وهي متعلّقة برواية الحيّ اللاتيني. فهذه الرواية حين صدرتْ، كما تعرف، أثارت ضجّةً في الوسط الأدبي ومناقشاتٍ مطوّلةً، وبثّتْ في نفسي نوعًا من الغرور، حتى اعتقدتُ أنّني قُذفتُ إلى الخلود بسببها! وذاتَ يوم كنتُ في إحدى الجلسات الأدبية فتعرّفتُ بفتاةٍ قالت إنّها قرأت الحيّ اللاتيني، فسألتُها بنوع من الكبرياء: “وهل أعجبتكِ الرواية؟” قَلَبَتْ شفتيْها قائلةً: “لا… لم تعجبني!” استغربتُ هذا الموقف طبعًا، واستخففتُ بهذه الفتاة التي لا تريد أن تعترف بالشهادات التي كَتَبها النقّادُ والكتّاب، وأرادت أن تعارض “الرأيَ العامَّ الأدبي” إذا صحّ التعبير. فقلتُ لها: “أخشى أنّك لم تقرئي الروايةَ قراءةً متمعّنة، ومعمّقة، فأنصحُكِ بأن تعيدي قراءتها.” قالت: “أنتَ أستاذ، وسآخذ بنصيحتك.”
وبعد فترة التقيتُ بها ثانيةً، فقالت لي: “قرأتُ الكتابَ مرّةً ثانية.” قلتُ لها: “أرجو أن تكوني قد غيّرتِ رأيكِ.” قالت: “نعم… غيّرتُه… ولكنْ إلى أسوأ. فهذه المرّة درستُ الروايةَ دراسةً ناقدة، فوجدتُ أنّكَ تشوِّه فيها الفتاةَ الشرقيّة وتمتدح الفتاةَ الغربية.” وأخذتْ تتكلّم ويرتفع صوتُها، فتجمّع حولنا بعضُ الحاضرين يتساءلون مَنْ هذه الفتاةُ الوقحة التي تتصدّى للدكتور سهيل إدريس صاحبِ الحيّ اللاتيني. وبقيتْ تتكلّم بهذا الحماس، الأمرُ الذي جعلني أتساءل: كيف السبيلُ إلى إسكات هذه الفتاة أمام كلّ هؤلاء الناس؟ فأجبتُ نفسي: إنّ أفضلَ طريقةٍ لإسكات هذه الفتاة هي أن أتزوّجها. وهذا هو الذي حصل، وتزوّجتُ عائدة مطرجي. ولكنّها لم تسكتْ، بل أنا الذي سكتُّ فيما بعد!”.
استسهال النقد..
وعن النقد العربي يقول “سهيل إدريس”: “ربما كان من الواضح أنّ النقد العربي قد انحسر في العقدين الماضييْن، بمعنى أنّنا كَفَفْنا عن أن نجد ما كنّا نجده في نقّادنا القدامى من الجهد وروح المعاناة و”الاستصعاب” (إذا صحّ التعبير)، مقابل كلمة “الاستسهال” التي هي الميزةُ الأساسيةُ في كثيرٍ ممّا يُنشر اليومَ من نقد. إنّه نقد خفيف… سهل.. لا يَعتمد الأسسَ العلميةَ والموضوعيةَ، بل يستهين بالكِتاب المنقود. وأَذْكر أن بعض النقّاد المعروفين سابقًا قد كفّوا اليومَ عن أن يَكْتبوا كما كانوا يكتبون، وربما كان ذلك بفضل بعض المجلاّت التي ترفض نشرَ دراساتٍ معمّقةٍ ومطوّلةٍ وتدّعي أنّ صفحاتها لا تتّسع لذلك.
إذن، هذا النقد هو الآن في أزمة، ولا بدّ من أن نستعيدَ له الوعيَ والعمقَ اللذين كنّا نحسّهما في كتابات النقّاد الأوائل، أمثال أنور المعدّاوي وعبد القادر القطّ وغالي شكري وصبري حافظ. لا بدّ من أن نسترجع مثل هذه الأصوات، وأن يعي النقّادُ المحْدثون دورَهم في تطوير الإبداع الأدبي الحديث”.
وعن اختفاء عمالقة الأدب والتعويل على الجيل الجديد من الكتاب يقول “سهيل إدريس”: “الحقيقة أنّ هناك اليوم أساليبَ في إغراء الكتّاب لكي يستسهلوا الكتابة، وهذا مرتبطٌ بالسؤال السابق. إنّ الكاتب العملاق هو الذي يَبْذل أكثرَ ما يستطيع من جهد ليتجاوز نفسَه، ويتجاوزَ طاقاته، فيبرز إذّاك كائنًا يعي مسؤوليةً كبيرةً في الكتابة. هكذا كان عمالقةُ الأدب العربي الحديث، أمثال طه حسين وعبّاس محمود العقّاد وميخائيل نعيمة وسواهم. وكثيرٌ منهم لم يكونوا يسألون على الإطلاق تعويضًا مادّيّاً عن هذه الأعمال العظيمة التي كانوا يقومون بها. ولم يكونوا يتّخذون الأدبَ وسيلةً واحدةً للرزق، بل كانوا يستجيبون لدوافعَ نفسيةٍ: فلقد كانوا ملتزمين بالكتابة من غير أن يُلْزِمهم أحدٌ إلاّ ضميرُهم ووعيُهم.
نحن اليومَ في عهدٍ تُشترى فيه الأقلامُ والضمائرُ والذِّمم، ولذلك نجد هبوطًا وانحدارًا في المعايير وفي الإنتاج. أخشى على الأقلام العربية كلِّها أن تَغْرق (ولأقلْها بصراحة) في هذا المنحدر البترودولاري الذي ربما كانت له خطّةٌ في أن يُسْكت الأصواتَ أو يصرفَها عن الأمور الجادّة، وعن الأدب الرفيع، ليتاحَ للسلطات أن تَفْرض سياستَها على الشارع وعلى الجماهير من غير أن تكون هناك أصواتٌ معارضةٌ لها. هناك مؤامرةُ تحاك ضدّ الفكر العربي، وليس بعيدًا أن يكون مشاركًا فيها جماعةُ “النظام العالمي الجديد” الذي يراد فرضُه على ضمائرنا بسبب هزيمةٍ تعرّضْنا لها. وينبغي أن يتنبّه لهذا، بالدرجة الأولى، المثقّفون الواعون والمسئولون”.
وفاته..
توفى “سهيل إدريس” في عام 2008.
استشهاد..
قصة لسهيل إدريس
(ضمن مجموعة نيران وثلوج، 1948)
بيروت
***
حين انتهت نشرةُ الأخبار، أطفأ أخي الأكبر، زياد، الراديو، وكان صوتُه منذ لحظات يدوّي بأنباء المعركة الأولى في فلسطين. ثمّ صعّد زفرةً طويلة، وجعل يهزّ برأسه إيماءةَ اليأس والخيبة. وما لبث أن قال بصوتٍ مكبوت، كأنّما يحدِّث نفسَه:
ــــ لا فائدة. لقد انتهى الأمرُ وخسر العربُ فلسطين.
وكان من الطبيعيّ أن ألتفتَ إلى أخي الأصغر، عماد، أستقري على وجهه تأثيرَ كلام أخيه، فإذا عيناه تحدّقان به، وفيهما مثلُ الغيظ والحنق المكنون. وإذا هو ينهض بحركةٍ غاضبة، ويلج غرفةَ النوم، ثمّ نسمع جميعًا صوتَ سريره يَصرّ إذ يستلقي عليه.
ومضى وقتٌ قصير، لم ينبس أحدُنا فيه بكلمة. كان يأسُ أخينا قد نشر فوقنا جوًّا من الكآبة، وما عتَّم كلٌّ منا أن مضى إلى سريره.
بيد أنّ طيْف الكرى لم يأخذْ بمَعاقد جفنيّ، فسرعان ما انتقل فكري إلى أخي عماد. فقد لاحظتُ أنه مغرِق في الصمت منذ أكثر من أسبوع، لا يكاد يأبه للّذي يجري حوله.
وكنتُ أعلم أنّه يؤْثر دائمًا أن يصمت على أن يُجيب، لسببٍ يسيرٍ على ما أظنّ: هو أنّ الكلام لم يكن عنده الوسيلةَ المثلى للتعبير عن الأفكار والمشاعر.
كان أخي عماد شابًّا هادئًا عاديَّ الإدراك والتفكير. وأنت إذا أتيح لكَ أن تلتقيه، فلن تلمسَ لديه التماعًا في الذهن أو إشراقًا في النظر. وحين يتناول الحديثُ أمرًا يعلو على إدراكِ طالبِ البكالوريا، ويتشعّب في مناحٍ تَستلزم بعضَ جهدٍ فكريّ، تراه يتأفّف ويُظْهر التبرّم، ثمّ يغادر الجمعَ من دون أن يتكلّم، أو يتمتمُ بين شفتيْه عباراتٍ مقتضبة، سمعتُ مرّةً إحداها:
ـــ خذوا.. أصبح كلُّ أستاذٍ “سقراط،” وكلُّ تلميذٍ “أفلاطون،” في هذا الزمن العجيب!
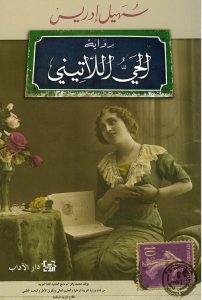
وقد يدفعك الفضولُ يومًا إلى أن تُلحّ عليه، بغيةَ استطلاع نظرته إلى الحياة، أو “فلسفته” فيها، إنْ كانت له فلسفة، فسترى أنّه عاجزٌ عن الإدلاء بأيّة كلمة. وهو قد يفكّر، ويَجهد في التفكير، ثمّ لا يجد إلّا أن يقول بيأسٍ ظاهر:
ـــ لا أدري ماذا أريد، ولكنّني لا أفهم هؤلاء الناس!
وأحسب أنّي أدركُ من شأنه أكثرَ ممّا يدرك رفقاؤه؛ فإنّني أشدُّ منهم اتصالًا به، ووقوفًا على أموره. وهكذا لم يصعبْ عليّ أن أُدركَ، من اعتصامه الدائم بالصمت، وزهدِه في الحديث، أنّه يؤمن بأنّ الناس يتكلّمون كثيرًا جدًّا، ويعملون قليلًا جدًّا؛ بل إنّهم يفكّرون أكثرَ ممّا يتطلّبه العملُ من التفكير.
ولعلّه كان طبيعيًّا أن أجدَ أخي عماد ينفق معظمَ أوقات فراغه في العمل، سواء كان مجديًا أو غيرَ مُجدٍ. ولا أذكر أنّي رأيتُه يومًا في البيت مقتعِدًا كرسيَّه ينظر في الفضاء حالمًا ومتأمّلًا. وكنتُ ألاحظ أنّه يكره هذه الموسيقى المائعة التي يبعثها الراديو، ولاسيّما حين يرافقها غناءٌ مثلَها مائعٌ. كما أنّه كان زاهدًا في ارتياد دُور السينما، لا يختلف عليها إلّا لمامًا.
حتى إنّ المرء ليحسب أنّ الحسّ الفنّيّ قد انعدم في نفسه أو كاد.
غير أنّي موقنٌ بأنّ رغبةَ العمل كانت تَملك عليه كلَّ إدراكه وجِماعَ أعصابه، وأنّ هذه الميزةَ التي يَنْعم بها أخي عماد لم تكن تتبدّى بأجلى مظاهرها إلّا في الشؤون الوطنيّة والقوميّة:
فقد كان وترًا مرهفًا يهتزّ لأيسر شعورٍ يمسّ الحسَّ الوطنيّ. وقد بكيتُ وسالت دموعي، يومَ اشتركتُ في المظاهرة التي نظّمها عام 1943 في أثناء حوادث تشرين؛ فكان هو الذي يقودها، ويهتف للبلاد والاستقلال هتافًا شارك فيه صوتُه كلَّ ذرّة من ذرّات جسمه، حتى لقد حسبتُه يتميّز ويتقطّع لدى كلّ هتاف. ثمّ جعلتُ أرتعش خوفًا وهلعًا حين برزتْ إحدى المصفَّحات الفرنسيّة، وهمّت بأن توجِّه نيرانَها إلى المتظاهرين، فوقف أخي عماد يتحدّى ويشتم ويهزّ قبضةَ يده الصغيرة في وجه المصفّحة الضخمة، وجسدُه يهتزّ شجاعةً وإقدامًا. ولم تكن الضربةُ الشديدة التي تلقّاها على رأسه بعقب إحدى البندقيّات، فأفقدته وعيَه، هي الضربةَ الوحيدةَ التي لاقاها في المظاهرات.
وكان عماد على طرفيْ نقيض من أخينا الأكبر: كان يؤمن بمواجهة الأمور بالصراحة والعزم والإقدام، حين كان زياد يتحايل عليها بكثيرٍ من الخوف والتراجع؛ وكان ممتلئ النفس ثقةً بالمستقبل، حين كان زياد يَظهر بمظهر الشكّ والارتياب. بيد أنّ عماد لم يكن ليجيب أخاه أو يناقشه إذا جرى الحديثُ يومًا في غير المجرى الذي يشتهي، بل كان يعتصم بالصمت ثمّ يغادر المجلسَ كاظمًا غيظَه.
***
ومنذ ثلاثة أسابيع، أرى عماد يبالغ في الصمت، ويغرق في السكوت، ولا يكاد يصرف وقتَه إلّا بالاستماع إلى أنباء الحوادث في فلسطين، وإلى الوقوف على أثر قرار التقسيم في سائر البلاد العربيّة. وكان ينطلق في الصباح المبكّر إلى مدرسته، ولا يعود إلّا في ساعة متأخّرة من الليل، إذ يقضي نهارَه بالاتصال برفاقه في مختلف المعاهد ويعمل على تنظيم الإضرابات.
وقد رأيتُه ذات صباح يُقْبل على خزانة أمّي، فيتناول منها سبع عشرة ليرةً ذهبيّة كان قد ادّخرها. وحين سألتْه أمّي عمّا ينوي فعله بها، أجاب باقتضاب:
ـــ سأرسلها إلى حيث يجب أن ترسَل.
فابتسم أخي زياد بسمةً باهتةً حاول [عماد] أن يتجاهلَها ويغضَّ عنها طرفَه.
وفي مساء الجمعة الماضي، وهو اليومُ الذي أضربتْ فيه بيروتُ إضرابًا شاملًا، وتظاهرتْ ضدّ التقسيم، عاد عماد منهوكَ القوى، مكدودًا من طول المسافات التي قطعها في التظاهرات. واستلقى على المقعد الطويل، يستمع إلى آخر أنباء الحوادث والمناوشات بين العرب واليهود في فلسطين.
وحين فرغ المذيعُ من إلقاء نشرة الأخبار، التفت أخي زياد إلى عماد يقول له مداعبًا:
ــــ نسيتُ أن أسألك: هل تطوّعتَ في سبيل فلسطين؟
فنظر إليه عماد، تكسو وجهَه مسحةُ ضيقٍ، ثمّ أومأ برأسه إيجابًا. وإذا بأخي الأكبر يطلق ضحكةً رنّانة، ويقول بصوتٍ يَقْطر بالسخرية:
ـــ إذن.. لقد أنقذتَ فلسطين!
ونظرنا جميعًا، فإذا عماد ينتفض مرتعشًا، وقد احمرّ وجهُه، وتشنّجتْ قسماتُه، وغامت عيناه بسحابةٍ من الغضب الشديد والألم المعذِّب، وارتعشتْ شفتاه ارتعاشَ الشيخوخة على شفتيْ مسنّ. ولا أذكر أنّي رأيتُه يومًا على مثل هذا الوضع من شدّة الغيظ وتوتّر الأعصاب. كانت أصابعُه منكمشةً في قبضةٍ يصبغها الدم. ولاحظنا جميعنا حيرتَه واضطرابَه. ولكن لم تكد تمضي لحظات حتى هبّ مقتربًا من زياد، ثمّ ألقى يدَه على كتفه، وأخذ يهزّه بعصبيّةٍ بالغة، جاحظَ العينين، وهو يمتم بغيظ:
ـــ حذارِ، إنني لم أعد أطيقك. إنّك تحاول دائمًا أن تجرح كرامتي.
فإذا هي قهقهة داوية تنبعث من صدر زياد، ثمّ يتوقّف لحظةً ليتابع:
ـــ ومتى كانت لك كرامةٌ يا عماد؟ إنّك ما زلت طفلًا يا أخي.
ولستُ أدري من أين أوتي عماد ذلك الإقدامَ وتلك القوّة؛ فلقد رأيناه يهجم على أخيه، فيأخذ يلكمه في وجهه وعنقه وصدره، وفي كلّ موضعٍ تستقرّ عليه يده، ثمّ يدفعه بسرعة حتى يبلغ به الجدار، ويستمرّ في ضربه ولكمه، ولا يكفّ عنه إلّا ساعةَ رآه يمتنع عن ردّ ضرباته. إذ ذاك، يتراجع ببطء إلى المقعد، فيرتمي عليه ويُطْرق برأسه من غير أن ينبس.
وتمضي لحظاتٌ، فينسحب عماد إلى سريره، وقد التمعتْ في عينيه دمعة.
***
وأفقتُ في صباح اليوم التالي على صوت أمّي تجهش بالبكاء. فركتُ عينيَّ ونظرت، فإذا أخي الأكبر زياد جالسٌ على حافّة سريرها، يروي لها أنّه قد استيقظ في موهن الليل على شفتين تلامسان جبينه، فإذا هو عماد مكبٌّ فوق رأسه يقول له، وفي صوته نشيج:
ـــ أرجوك أن تسامحَني يا أخي على ما بدر منّي ليلة أمس. لم أستطع أن أضبط أعصابي!
فلم يسع زياد إلّا أن يمدّ ذراعيْه، فيحوِّط بهما أخاه وهو يجيب بتأثّر:
ـــ بل أنا أطلب الصفح. لقد آذيتُكَ يا عماد في أنبل شعورٍ يضطرم في صدرك.
ولكنّه حين انفصل عنه، ألفاه مرتديًا ثيابَه الكاملة، فانتفض وسأله جزعًا:
ـــ ولكنْ إلى أين يا عماد؟
فتردّد لحظاتٍ قبل أن يجيبَ في الظلام بصوتٍ يمتلئ حياةً وبهجةً وأملًا:
ـــ إلى حيث يجب أن أذهبَ يا زياد. إنّني لم أشأ أن أؤذي أمّي، فقرّرتُ أن أذهب الآن وهي نائمة. ولكنّي أوصيكَ بأمرٍ واحدٍ يا أخي: هو أن تقبّل أمّي، وترجوها أن تدعو اللهَ من أجلي. فأنا أغادرها لتحتضنَني أمٌّ ثانية، أمُّنا الكبرى، الأرضُ الحبيبة التي أتوجّه إليها: فلسطين!
***
أمّا أنا، فسأنسى هذه اللحظةَ أنّي أخوكَ يا عماد، لأدعو لك اللهَ أن تُستشهد في معركة فلسطين. ذلك لأنّ فلسطين لن تعيشَ فيها العروبةُ إلا إذا مُتَّ أنتَ وأمثالُكَ من الذين خُلقوا لا ليتكلّموا، وإنّما ليموتوا مجاهدين صامتين.

