خاص: إعداد- سماح عادل
“سعيد الكفراوي” كاتب قصة قصيرة مصري، ينتمي لجيل الستينات، كرس أدبه للقصة القصيرة وكما كتب بعض المقالات عن الأدب.
حياته..
ولد “سعيد الكفراوي” في قرية كفر حجازي بالمحلة الكبرى سنة 1939، ونشأ فيها. اهتم بالأدب وهو صغير، كون في بداية الستينيات ناديا أدبيا في قصر ثقافة المحلة الكبرى مع أصدقائه “جابر عصفور” و”محمد المنسي قنديل” و”صنع الله إبراهيم” و”نصر حامد أبو زيد” و”محمد صالح” و”فريد أبو سعدة”، ثم تعرف “سعيد الكفراوي” على مجلس “نجيب محفوظ” على مقهى ريش بالقاهرة.
اعتقل “سعيد الكفراوي” في 1970، قبل أيام من وفاة “جمال عبد الناصر”،بسبب قصة قصيرة كتبها، وبعد خروجه من السجن حكي ل”نجيب محفوظ” ما جرى معه، واستوحى “نجيب محفوظ” من قصته شخصية “إسماعيل الشيخ” في روايته “الكرنك”.
القصة القصيرة..
بدأ “سعيد الكفراوي” كتابة القصة القصيرة في فترة الستينيات، ورغم ذلك نشرت أولى مجموعاته القصصية في الثمانينيات. وترجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والسويدية والدنماركية.
تولى رئاسة تحرير سلسلة “آفاق عربية” الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.
مجموعاته القصصية..
- مدينة الموت الجميل (1985)
- ستر العورة (1989)
- سدرة المنتهى (1990)
- مجرى العيون (1994)
- دوائر من حنين (1997)
- كُشك الموسيقى
- يا قلب مين يشتريك
- البغدادية
- زبيدة والوحش (2015): مختارات قصصية، صدرت عن الدار المصرية اللبنانية، وتضم ستة من مجموعاته القصصية.
الجوائز..
نال “سعيد الكفراوي”جائزة السلطان قابوس بن سعيد للقصة القصيرة عن مجموعته القصصية “البغدادية”. وجائزة الدولة التقديرية في الآداب، مصر، 2016.
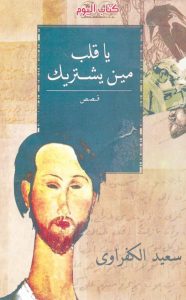
المعتقل..
في حوار معه أجرته “سلوى عبد الحليم” يقول “سعيد الكفراوي” عن تجربة الاعتقال: “أتذكر أنني خرجت من المعتقل حاملاً حقيبة فيها متاعي، وبداخلها يتكوم أسى مؤلم. توجهت إلى مقهى «ريش» حيث ندوة نجيب محفوظ، حين حضر كان يعرف حكايتي وطلب مني سردها بالتفصيل الممل. قلت له كاتب معتقل يحقق معه في الصباح اثنان باعتباره شيوعياً، وفي المساء يحقق معه اثنان باعتباره «إخوانياً»، وهكذا على مدار ستة شهور، وأنا لم أكن هذا ولا ذاك. يومها لاحظت الألم على وجه الكاتب الكبير المقام. يومها قال لي بانفعال: «اقطع هذا الشوط الرديء من حياتك» ثم بعد شهور صدرت «الكرنك» فوضع يده على كتفي وقال لي: «يا كفراوي أنت إسماعيل الشيخ اللي في الرواية». كان اعتقالاً فكاهياً، من تلك الكوميديات السوداء”.
ورأيه عن الحقبة الناصرية أنها: “حقبة بوليسية من أولها إلى آخرها. محنة للمثقفين الذين عاشوا وطأة التعصب الديني وزمن الانفتاح، كما عاشوا سطوة العسكر الذين استبدلوا ذواتهم بالأمة. عاش المثقف في ذلك الزمن مأزوماً يجمع بين النقائض. رأيتُ في المعتقل كل فصائل المثقفين، ونخب الحياة السياسية من ماركسيين وإخوان ولبيراليين وفوضويين أيضاً”.
وعن القصة القصيرة يقول: “شخصياً أحببت كتابة القصة القصيرة واعتبرتها الشكل الأمثل للتعبير عن تجربتي (إن كانت هناك تجربة) طبعاً تمنيت أن أكتب رواية ببنية مسبقة أردت لها الكمال، لذلك لم أكتبها أبداً. كنت أكتب قصصاً قصيرة يعتبرها بعض النقاد روايات قصيرة مثل «ستر العورة»، و «يا قلب مين يشتريك» و «البغدادية». لم تشغلني هوية النوع. أكتب قصة تشبهني. قصة لا ينفصل شكلها عن مضمونها وتسعى للتعبير عن جماعتها المغمورة. على أية حال، أنا من المؤمنين بأن كتابة قصة قصيرة جيدة تساهم في اكتشاف الحقائق القديمة التي لا تزال صالحة لإثارة الدهشة، مثلما كان يقول يحيى الطاهر عبد الله”.
الإنسان وحيدا..
في مقالة له بعنوان (أن يكون الإنسان وحيداً!!) يقول “سعيد الكفراوي”: “أواخر الستينات، تقريباً، كنت أحضر من قريتي لأقضى أياماً قليلة بمدينة القاهرة.. كنت أقيم في لوكاندة قليلة الأهمية، تطل على ميدان «باب اللوق»، «الأزهار» سابقاً.. وكنت عند مجيء الليل أجلس على مقهى «سوق الحمدية» لصاحبه سوري طيب. كنت أراهم يتتابعون، إما فرادى، أو أحدهم يتأبط ذراع صاحبه، وكنت أتأملهم بدهشة.. شكرى عياد.. عز الدين إسماعيل.. صلاح عبد الصبور.. فاروق خورشيد.. فاروق شوشة.. ثم جابر عصفور، ويأتي في عجلة طيب الذكر عبد الغفار مكاوي. حينها سألت أمل دنقل: «أين يذهب الجماعة؟»، أجابني: «لهم لقاء أسبوعي في شقة فاروق خورشيد هناك»، وأشار بإصبعه ناحية إحدى العمائر الخديوية القديمة، ثم نبهني أمل دنقل إلى أن هؤلاء الكتاب والشعراء آخر من بقى من جماعة الجمعية الأدبية المصرية، التي خرجت من جماعة الأمناء، التي أنشأها طيب الذكر الشيخ «أمين الخولي». ثم أكمل أمل دنقل: يلتقون بحكم رفقة التاريخ والإيمان بمبادئ الأمناء، يستعيدون دورهم المهم في الثقافة العربية”.
ويواصل: “حين رأيت «عبد الغفار مكاوي» يأتي وحده، نهضت وصافحته باعتزاز، ظل ملازماً لعلاقتنا حتى رحيله. يرحل «عبد الغفار مكاوي»، هذا المفكر الكبير، في نفر قليل شاهدوا جنازته، ونفر أقل حضروا عزاءه. وبين الميلاد والرحيل، رحلة من إنتاج الإبداع والمعارف تدفعني بأن أحنى هامتي لرجل أعطى الفكر والإبداع كل حياته!! رحم الله أستاذنا يحيى حقي الذي مضى حيث وجه الله تصحبه جنازة عدد أفرادها يساوى عدد أصابع يد واحدة «!!». أحزن كثيراً على الخواتيم المؤلمة لهؤلاء الكبار الذين أعطوا ومضوا!! وأنا أتخيل عبد الغفار مكاوي يهمس لنفسه الآن: «هل كان الأمر يستحق كل هذا الجهد؟! كانت لها سطوة على الفكر والأدب، وعاش طوال عمره ولاءه لعلمه وأساتذته وأصدقائه: أمين الخولي وشوقي ضيف وشكري عياد وصلاح عبد الصبور. آخر عمره، تقريباً في ربع ساعته الآخرة مثلاً، منحته الدولة «جائزة الدولة التقديرية» في الآداب، بعد أن حصل عليها أشباه الأدباء، وغير الموهوبين، وخدم السلطان، الذين حملوا ولاءاتهم على أكتافهم ومضوا فى الدنيا، خدماً للذي يساوى، والذي لا يساوى.. على «عبد الغفار مكاوي» رحمة الله”.
وفاته..
توفي “سعيد الكفراوي” يوم السبت 14 نوفمبر 2020 ، عن عمر ناهز 81 عامًا.
قصة قصيرة لسعيد الكفراوي..
بيت للعابرين..
“رن” التليفون “آخر الليل، فرفعت السماعة، وسمعتُ صوتاً نسوياً:
– آلو…
– نعم
– منزل الأستاذ “صبري”؟..
صبري سالم..؟.
– نعم
– أنت متأكد؟
– طبعا..
أنا “صبري” بنفسه.
تهلل الصوت:
– “صبري” ابن العم “سالم”. المولود في “كفر الغنايم” مركز “سمنود”؟.
– بالضبط. معلوماتك صحيحة.
لكن أنت من يا أفندم؟
– أنا “سمّة ” يا “صبري”.. “سمية فيض الله”.. المنصورة.. فاكر.. سنة 1957.. فاكر…
هتفتُ مأخوذاً:
– “سميّة”!
برق الشعاع ضارباً أقصى تجاويف الدماغ فضوّت الذاكرة، وتبدد ظلام النسيان، فيما تجمعت صورتها جزءاً، جزءاً. الصبية الصغيرة التي كانت على عتبة الشباب، بضفيرتها الوحيدة، وقلادة الذهب، والبسمة المنوّرة، والغمازتين.
صحتُ بلا وعي:
– ” سميّة “..
والله زمان.. والله زمان يا “سميّة” كيف أحوالك؟.
قالت بعدم تصديق:
– بخير..
نفسي أشوفك.. أصل أنا شفت صورتك في الجورنال.
.. أخذني الشك، ولم أصدق نفسي..
– أصلك تغيرت خالص.. اتصلت بالمسئولين فأعطوني رقم تليفونك.. نفسي أشوفك.. ياريت تحضر.
وأعطتني العنوان، ثم وضعت السماعة.
خرجت إلى شرفة البيت، كنتُ أتطلع إلى الليل، وأنا أقف وحيداً أقاوم ما أنا فيه “سبعة وثلاثون عاماً منقضية تنهض فجأة، وكأنها كانت محبوسة في كهف”. شعرتُ كأنني غير قادر على مواجهة الحنين، وبأنني لا أستطيع أن أقاوم ذلك الماضي الذي لا يخص أحداً غيري.
“المنصورة”.. سنة 1957.. أول الشباب.. زمن هؤلاء الذين يأتون من القرى محتشدين بقلة تجاربهم، وخجلهم، يتخبطون في شوارع المدن تائهين، حتى إذا ما وجدوا الملجأ كان لهم العزاء.
وبيت ” سميّة ” كان عزائي، مأواي، عندما سكنت حجرة على سطح بيتهم.
الآن.. ماذا في الآن؟.
هي هرمة تقترب من الستين. كانت أكبر مني بسنوات ثلاث. ربما هي الآن جدة، أو أرملة ودعت زوجها ووارته التراب، وتعيش وحدتها بلا آمال، منتظرة مثلي حسن الختام.
تذهب؟.
إلى أين تروح؟.
لتتفرج على مشيبك، أم لتتعرف آخر المطاف على ماصنعه بك زمنك الخاص؟.
خيل إلىّ في هذه اللحظة أنني أعدو من غير حسبان، متجاوراً سنينى، عائداً لتلك المنطقة السرية من ذلك الزمن البعيد، لأطل على لحظة من ألق، حيث كانت تأخذ بيدي- أنا القروي- ونحن نسير على كورنيش المدينة نتطلع إلى الضوء، والقوارب المركونة، والصور المعلقة، والناس على “الكازينو”، وكنت أنظر في عينيها فأعثر على الفرح، وأتأمل الغمازتين، وأطمئن نفسي بسؤالها: “بأن كانت تحبني؟ ” فتزوغ مني ضاحكة “حاذر يافلاح النبي لا أحد يأخذ كل شيء”.
في الصباح بدري ملأتُ صندوق السيارة فاكهة، وحلوى، وقطعاً من قماش، ومزهرية من زمن الخريف، وتوكلتُ.
دخلت “المنصورة” في الضحى. المدينة التي لم أرها من سنين. “المنصورة”.. لؤلؤة من ذكريات تسكن في القلب.. حكايات من الزمن القديم تنهض من النسيان حزمة من شرايين حيّة.
رأيت قاعدة الرخام، والكازينو العتيق، والنادي “اليوناني”، و “منيرفا” قائما على الكورنيش تلحس المياه قواعده الأسمنتية، بينما يجلس “مراكبي” عجوز على مؤخرة قاربه يتأمل الماء. قلت: ربما هو من كان شاباً ينقلنا على النهر ساعين في ذلك الزمن الذي كان. طرز البناء، وسينما “عدن”، والأزقة الصغيرة التي تحبس روائح البيوت انتفضت حيّة بملامحها وكأنني تركتها بالأمس.
كان البيت يقع بعد ضاحية “توريل” بالقرب من شاطئ النهر، تحوطه أشجار الكافور التي تفرش فروعها العصافير.
ركنت السيارة، وحملتُ هداياي، وضغطت على جرس البوابة الخارجية للبيت، ففتحت لي فتاة لها ملامح قروية سمراء، ونظرات تلمع في النور.
خطوت إلى حديقة مزهرة على غير أوان، ورأيتُ نافورة مسوّرة بحجر من رخام، تفوح من الحديقة روائح معطرة بذكريات تضرب خاصرتي من غير رحمة.
ليس هو البيت القديم، الذي كنتُ أسير بصالته، وأطل من نوافذه، وأسمع غناء الجارة الست “هدى” منطلقاً بأغنيات الحنين.
انتابني قدر من الخوف، وأحسست برعشة الذاهب ليلتقي بحياة كان قد عاشها من زمان.
صعدتُ درجات السلم الرخامية وانتظرتُ.
بعد قليل رأيتها تخرج، ترتدي فستاناً من الحرير الأحمر، موشى ذيله بقطيفة حمراء، ومطرزاً بوردات زهرية. كانت أمامي بشكلها القديم، وصباها الذي أعرفه.
شهقتُ، وصحتُ:
– “سميّة” كأنني فُتك البارح.
توجست قليلاً، ووشت ملامحها بالاضطراب، في كنتُ أهوي أنا مصعوقاً كلما تأكدت أن الزمن لم يمر بها.. نفس الملامح، والقامة، وخفة الروح.
مددتُ يدي فقبضت عليها:
– أهلا يا “صبري”.
خُيّل إلي أنني أهوي من مكان عال، وخفتُ أن أصرخ من ضربة المفاجأة. نظرتُ إليها بقلبي، وتأملتها بحواسي الخمس في سطوع النور، يشع منها ضياء الشباب، وعبير له رائحة الياسمين. هتفتُ في نفسي” شابة بنت الحلال، كأنها لم تتجاوز الثلاثين، تقف أمامي وكأنني غادرتها بالأمس”.
خفت من اختلاط الأمر عليّ، وحاولتُ بقدر ما أستطيع السيطرة على مشاعري.
دخلت أمامي مرحبة، تفرش الأرض بالتحايا، والضحكات فيما تستولي على البيت رائحة البخور الهندي، وشذى الياسمين.
– والله زمان يا “سميّة”.
ضحكت، فيما أتأملها متشككا وكأنني في حضرة أخرى.
هتفتُ لنفسي “ممكن؟ كيف تستطيع أجساد أن تقاوم الفناء بهذه الكيفية المرعبة؟”.
جلستُ أتأمل بشرتها التي تضيء في النور الذي يسطع من النافذة: فاجأتني:
– والله وكبرت يا “صبري”.. شاب شعرك وعجزت.
– الغريب إنك عكس ذلك تماما.
ابتسمت، واستأذنت لحظة، ولكي انتزع نفسي مما أنا فيه، تأملت صالة البيت الواسعة. كانت كبيرة وعلى قدر رفيع من الذوق، والغنى. ستائر القطيفة على النوافذ. صالون مذهب يستقر بطرازه الفرنسي. تحف، وصور على الحائط لمستنسخات من القرن الماضي، لحوريات، وملائكة مجنحين، وسجادة فارسية على الأرض موشومة بزخارف نباتية. صورة شخصية لها من ذلك الزمان، صبيّة في إطار من خشب بني اللون، وذي رصانة وُضعت في مكان ظاهر عمداً، وسبق إصرار.
أعرفها تلك الصورة غير الملونة، وأتذكر دقائق زمانها حينما استعرتها لأيام لأضعها في ألبوم صوري، حتى طلبتها مني مبتسمة “مالك.. الأصل معك”.
عادت ببهائها، ووجهها المنور تطلق ابتسامات طيبة، ويجلجل صوتها بكلمات الترحيب.
قلت:
– فاكرة هذه الصورة؟
– وهل هذه أشياء تنسى. كنت تحبها كثيراً.
أطلتْ من الباب الموارب يد تحمل صينية عليها فاكهة، وطقم شاي من البورسلين، ولمحت ظلاً لسيدة تكتسي بالسواد، وسمعتها وهي ترحب بي:
– أهلا وسهلا.
– أهلا بك.
سألت “سمية”:
– من هذه؟
– قريبة.
واكتفت.
بعد ذلك كنت أسمع خطوات السيدة تطرق سمعي دائرة في البيت بإيقاع رتيب، وصوت تنهداتها يأتيني مضمخا برائحة البخور والياسمين.
صمتُ راحلا إلى بعيد.
حينما كنت فيما مضى ألبدُ على “البحر الصغير” تحت “البونسيانا” ذات الأزهار الحمراء، متظاهراً بقراءة كتاب بالقرب من المدرسة “اليونانية” التي تتوسط الطريق لمدرستها ومعهدي، وأراها قادمة بمريلتها الزرقاء، وضفيرة شعرها المشبوكة بشريط أحمر، تضم حقيبة كتبها لصدرها، تعرف أنني أكمن عند الشجرة أنتظر رؤيتها في الخارج، إلا أنها آخر النهار كانت تعنفني “بطل تلصص”، وتكون فردت شعرها فانطلق في كثافة الليل، وأكون أنا قد أحببتها أكثر، وطويت جوانحي على الحلم، وتكون قد اقتربت مني قائلة “يالله يافلاح دعنا نذاكر”.
قلت:
– شيء غريب.
ردت
– ما هو الغريب؟
لم أرد، لأنني شاهدتُ السيدة المسنة من الباب المفتوح على الحديقة تشذب بمقص في يدها أشجار الزهور. كانت ترتدي فستاناً أسود بكمين طويلين، تطل من تحت طرحتها ذوائب من شعر في لون الفضة، وعندما رأيت جانب وجهها كانت تلبس نظارة سميكة، تستقر على وجه محتقن يشيع منه- الأسى والحزن.
سمعتها تطلق غناء كالعديد تدفع به نسمات. الخريف محملا شجنا.

قلت:
– غريبة.
– خيراً.
– كأنني أعرف هذه السيدة.
ارتعش صوتها عندما قالت:
– أبدا.. هذه قريبة من بعيد.
ثم قالت مغيرة الموضوع:
– فاكر “بريسكا” ؟
“حكاية من زمان” قلت:
– تقصدين “كوثر حجازي” – البنت التي كانت تمثل معكم مسرحية “أهل الكهف”. كنت عامل دور “مرنوش” الرجل الذي عاد من نومه بعد 300 سنة، يبحث عن امرأته وابنه.
– فاكر طبعا.. حتى أنت أيامها فكرت أنني أحبها.
ضحكت قائلة:
– كانت أياما حلوة يا “صبري”.. كانت أيام. خُيّل إليّ أنني أسمع صوت بكاء يأتي من تحت النافذة، وأن هناك من يتنصت علينا. وانشغلت بالسيدة العجوز الغريبة. سألتها: إن كانت سمعت صوت بكاء؟ فردت عليّ:
– أبداً.
تناولنا الغداء، ولم تكف عن الحديث. كلمتني عن نفسها، وبأنها تزوجت بعد أن سافرت أنا ولم أعد، وكلمتها عن نفسي حتى خف بنا الزمن فعدنا لسطوح الدار القديمة، وشوارع المدينة.
راحت الشمس.
وعزمت على الرحيل.
نهضت، ونهضت معي. قالت:
– ما بدري.
هل ستعود؟
– ضروري.
هبطت معي الدرج.
وقفنا تحت شجرة في الحديقة. لمحت نفس السيدة المسنة تجلس تحت النافذة التي كنا نجلس بجوارها.
تأملتها هذه المرة. كانت كهلة، شبه عمياء، مضروبة بالشيب والسمنة المفرطة.
انتابني إحساس غريب بأنني أعرفها، ربما قابلتها من قبل. سألت “سمية”:
– أنت متأكدة أنني لم أرها من قبل؟
قالت وقد هربت من مواجهتي:
– طبعا. هذه قريبة لنا تأتي أحيانا.
– غريبة.
سمعت العجوز تصيح بي، رافعة يدها:
– مع السلامة.
– الله يسلمك.
ورأيتها تدخل إلى البيت، ولا أعرف لماذا شعرت أنها تجهش بالبكاء.
خرجت للشارع خائفا من هبوط الظلام الوشيك، وأحسست بأنني تأخرت. تعثرتُ في حيرتي، واختلط علي الأمر، وكل تلك الأسئلة تمور بداخلي.
عندما استدرت رأيت السيدة العجوز تلصق وجهها بحديد النافذة وتطل عليّ. كانت تقبض على الحديد بأصابع كالمخالب. أسرعت من خطاي في اتجاه السيارة أخاف من النظر خلفي.

