خاص : كتب – محمد البسفي :
“العولمة”.. ذلك الاخطبوط الهلامي الواثق الذي بات يحوطنا بأذرعه الثقافية والاقتصادية وغيرها من عشرات الأذرع التي باتت تسيطر بنعومة وتتغلغل بإصرار قوي على كافة مناحي حياتنا اليومية كأبناء دول العالم النامي أو دول الجنوب – بلغة الأمس –، وأصبحت “العولمة” هي الأيدي الوحيدة التي تشكل لنا مجتمعنا الوطني بمقوماته الحضارية والتأريخية حتى ذائقته الفنية وتذوقه للمأكل والمشرب.. ورغم مئات الدراسات والأبحاث التي كتبت ومازالت تُدرس لفهم وفحص تأثيرات موج “العولمة” الكاسح لنا في دوماته وأعاصيره، أرتأت (كتابات) فتح ملف “مكافحة العولمة”.. وهو مجموعة من الحوارات مع زمرة من المتخصصيين والمثقفين، يدور النقاش خلالها على محورين أساسيين؛ أولهما “هل نستطيع ؟”، أما الثاني فسوف يبحث في: “كيف نستطيع ؟”..
المفكر التونسي، “رضا خالد”، المهموم بحركات الإسلام السياسي وإستاتيكيات تفكيرها الميداني والثقافي مع ديناميكيات التراث الإسلامي؛ وجداليات الدين والدولة.. يقيم ببلجيكا بعد أن حصل على دبلوم هندسة وليسانس إدارة وتسيير مؤسسات؛ وشهادة أهلية لتدريس الدين الإسلامي. في الفترة الواقعة بين 1985 و1992، كان عضواً بفريق البحث الدولي الإسلامي المسيحي، والذي كان يضم أساتذة؛ مثل الكاتبين الراحلين: “محمد أركون” و”سعد غراب”؛ مدير بيت الحكمة بتونس، بالإضافة إلى الأستاذ “عبدالمجيد الشرفي”. يحاضر الأستاذ “خالد” حالياً لدى العديد من المنظمات الأهلية في بلجيكا، صدرت له ثلاث كتب بالفرنسية؛ رشحت منها “أكاديمية العلوم لما وراء البحار” بفرنسا كتابه: (رسول الإسلام وخلفاؤه) لنيل “جائزة أفضل كتاب للعام 2012”. كما صدر له أيضاً كتاب: (نحو أفق إسلامي جديد: الرسالة – الشريعة – المجتمع) 2012، وكتاب: (الإسلام بين الرأسمالية والاشتراكية: الاقتصاد والمجتمع في عيون الإسلاميين) 2015؛ عن دار “الجنوب للنشر” بتونس. فضلاً عن عدة مقالات وحوارات بالصحف التونسية والبلجيكية.
ومع المحور الأول: “هل نستطيع ؟”.. يبدأ النقاش مع الأستاذ: “رضا خالد”..
(كتابات) : بداية.. ما مدى إرتباط ظاهرة إتساع رقعة خريطة الإسلام السياسي بأزمة الهوية لدى الدول العربية خاصة ودول العالم الثالث عموماً بعد الطوفان العولمي الحالي ؟
- العولمة هي الإتجاه الدؤوب نحو تخطي الحدود المادية والعوائق السياسية والقانونية والإختلافات الثقافية واللغوية من أجل التواصل والتبادل، وهي من زاوية رأس المال الحركة الحرة للأموال والبضائع والخدمات وأدواتها السياسية والمؤسسية؛ تتمثل في “المنظمة العالمية للتجارة” و”صندوق النقد الدولي” و”البنك العالمي”، وتجسد ثورة الاتصالات أبرز مظاهر العولمة بالإنتقال الفوري للمعلومة والتبادل الفوري للأفكار والآراء.
وفي ظل عالم لا متكافيء تخدم العولمة مصالح الذين يسيطرون على المال والصناعة وإنتاج المعلومة، وكما في كل حالة من حالات المجتمعات البشرية، فكل فعل ينتج عنه رد فعل وتختلف ردود الأفعال في مواءمتها للتحدي المفروض وفي نجاعتها في التصدي له؛ وفي الأثر المترتب عن جدلية الفعل ورد الفعل فالعولمة بقدر ما تفتح من آفاق جديدة وواعدة أمام البشر بكسر التمايز وتيسير التواصل وتعميق التعارف؛ فإنها تشعر كثيراً من الناس بفقدان هويتهم الثقافية والدينية وضعفهم الكبير أمام عمالقة رأس المال والمتحكمين في تسويق المعلومة، وهو ما يفسر التنامي المتسارع في كثير من دول أوروبا وفي الولايات المتحدة للنزعات الوطنية والعنصرية والمعادية لكل ما هو أجنبي وكذلك تنامي الحركات الانفصالية لدى الأقليات اللغوية والدينية.. من هنا المفارقة بقدر تنامي العولمة بقدر تزايد عدد الدول الجديدة والمناطق الطامحة إلى التحول إلى دول جديدة، بحيث إنه بدلاً من كسر الحدود يحدث العكس في الواقع؛ إذ هي تتزايد.. بل إن من المظاهر الجديدة والباعثة على القلق تكاثر الجدران الفاصلة بين دولة وأخرى.
ذلك أن العولمة هي في جوهرها ثنائية الطابع، فهي تدعو إلى رفع القيود أمام حركة السلع ورؤوس الأموال، ولكنها لا تفعل ذلك بالنسبة لحركة البشر.. من هنا كانت أزمة اللاجئين الفارين من مواطن الحروب والأزمات وهجرة موجات بشرية من إفريقيا عبر المتوسط تحدياً حقيقياً لدعاة العولمة وكاشفاً فعلياً لحدود الخطاب الرسمي المتبجح بالديمقراطية وحقوق الإنسان في حالة أوروبا والولايات المتحدة؛ أو ذاك المتبجح بالأخوة الإسلامية في حالة “إندونيسيا وليبيا” ودول الخليج.
بالنسبة للعالم الإسلامي يختلف الوضع باختلاف درجة نمو الاقتصاد وإندماجه في الرباعية المهيمنة أي؛ “الولايات المتحدة والصين وأوروبا الغربية واليابان”، فالدول الأكثر إندماجاً مثل “تركيا وإندونيسيا وماليزيا” تعاني هزات أقل من تلك المندمجة جزئياً مثل معظم الدول العربية أو تلك المهمشة أو السائرة في طريق التهميش مثل “اليمن والسودان وموريتانيا” ومعظم دول إفريقيا السوداء.
(كتابات) : هل يمثل ظهور الدولة الإسلامية، (داعش)، ذروة ذلك الحاضر العولمي في وجهه الوحشي ؟
- لا شك أن تشابك أزمات كثير من دول العالم الإسلامي، وأعني بذلك مأزق الحريات السياسية والنمو الاقتصادي والهزائم العسكرية؛ ساهم في انتشار الخطاب الرافض للعصر ولمنجزات الحداثة والعداوة للغرب، ذلك الخطاب الداعي إلى التشبث بالموروث والعودة إلى أنماط الحكم والعلاقات السابقة على التدخل الغربي في البلدان الإسلامية، وذلك كنوع من الدفاع عن النفس والصراع من أجل البقاء؛ خاصة بعد إفلاس الدولة القومية في تحقيق وعودها في “الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية”، وبعد الطفرة النفطية التي ساهمت في الترويج لفكر سلفي منغلق على ذاته متماه تماهياً مطلقاً مع ماضٍ أسطوري مرفوع إلى مرتبة مثال لا يدانيه مثال.
لكن الواقع هو دوماً واقع متحرك.. وهو ما يفسر إنزياح طرفين في تيار حركات الإسلام السياسي إلى مواقف لم تكن في حسبان الحكومات القطرية؛ ولا في حسبان القائمين على السلفية الوهابية، وأعني بذلك انتقال جماعة “الإخوان المسلمون” والأحزاب المتفرعة عنها من مقاطعة للغرب الرأسمالي وتحميله جميع مصائب العالم الإسلامي إلى حوار مع دوائره المتنفذة ثم إنخراط كامل في توجهه “النيوليبرالي” واستعداد تام للحفاظ على مصالحه في المنطقة مقابل الاعتراف بالجماعة وفروعها وتسهيل وصولها إلى الحكم، أو على الأقل عدم عرقلة عملية إستلام الحكم من قبل الجماعة وفروعها.. وقد كنت بينت في كتابي (الإسلام بين الرأسمالية والاشتراكية – الاقتصاد والمجتمع في عيون الإسلاميين)؛ كيف لعب “حزب العدالة والتنمية” التركي دور “الكشاف” في هذا التحول من معاداة الغرب الرأسمالي إلى خدمته.
على الجانب الآخر ظهرت “السلفية الجهادية” كإمتداد، ونقيض، في الوقت نفسه للسلفية التقليدية، وكان ديدنها القطع العنيف ليس مع الغرب فحسب؛ بل مع جميع المجتمعات المسلمة القائمة، وانتقل عنفها الوحشي من قُطر إلى آخر؛ حتى بلغ ذروته بظهور (داعش) وسيطرتها على مناطق واسعة من “العراق وسوريا”.
إن هزيمتها العسكرية الأخيرة لا تعني إطلاقاً القضاء عليها فكراً وممارسة؛ فلا يمكن تحقيق نتائج فعلية وإنتصار نهائي على الهمجية والعنف الوحشي، إلا بإيجاد حلول لأزمة عطالة الشباب ولمشكلة النزوح المتواصل من الأرياف ولمشاكل الرشوة والمحسوبية والفساد وتوسيع مجال الحريات والمشاركة السياسية وتطوير مناهج التعليم والبدء فعلياً بإصلاح للفكر الديني وتحديد واضح لعلاقة الدين بالسياسة.
(كتابات) : ما هي الأوجه الحقيقية للعولمة الثقافية عموماً التي إستفادت بها حركات الإسلام السياسي ؟
- لقد إستفادت حركات الإسلام السياسي من العولمة بطرق مختلفة.. فجماعة “الإخوان”، ومن يدور في فلكها، قبلوا مظهرين بارزين منها؛ “النهج النيوليبرالي” في الاقتصاد والديمقراطية – على الأقل على مستوى الخطاب – في السياسة، في حين إستفادت “السلفية الجهادية” من العولمة في جانبها التقني المعلوماتي؛ حيث أظهرت (داعش) قدرة هائلة على توظيف التقنيات الحديثة في الدعاية وجذب الأنصار.. ولكن في الحالتين، وهذا هو المهم برأيي، لم يقع تحيين للبنية الفكرية لتتلاءم مع الواقع الحديث، ولا رفع للتناقض بين تصور منغلق ومتخلف للعالم من جهة واستعمال مكثف لأحدث منتجات التكنولوجيا من جهة أخرى، فلا يزال الفكر المرجعي ساكناً ما بين القرن السابع والقرن الرابع عشر الميلادي.
(كتابات) : هل ألغت العولمة الثقافية ما يسمى “الدولة الوطنية” بكل قيمها وخصوصيتها ؟
- يمكن القول إن إتجاه العولمة يمثل تهديداً حقيقياً لسلطة وسيادة الدولة الوطنية، فالحركة المتسارعة للأموال والسلع والتنقل المكثف والفوري للأفكار والمعلومات؛ يحد من دائرة تأثير الدولة الوطنية ويجعلها غير قادرة على التحكم في جميع المعطيات المتعلقة باقتصادها وماليتها وهموم وتطلعات مواطنيها.
وبقدر ضعف حجمها بشرياً واقتصادياً بقدر عجزها عن مواجهة متطلبات العولمة، ذلك أنه إذا كانت تكتلات كبرى على غرار “الاتحاد الأوروبي” غير قادرة على فرض قوانينها وقراراتها على عمالقة الاقتصاد العالمي؛ فما بالك بدول لا وزن لها في ميزان العلاقات الاقتصادية الدولية.
ولا محيص للدول الضعيفة في مثل هذه الظروف التي ستزداد خطورة مستقبلاً؛ من التعاون والتكتل للحد من آثار العولمة على قرارها السيادي وعلى مصيرها الاقتصادي والمالي، خاصة في ظل تبادل لا متكافيء يحكم اليوم العلاقات بين الدول المصنعة وبقية دول العالم غير الصناعي.
(كتابات) : لماذا اعتمدت العولمة في تصدير قيمها الخاصة على مدارس التفكيكية والفوضوية فلسفياً إلى مجتمعات العالم الثالث ؟
- في المجال الثقافي يختلف الوضع من دولة إلى أخرى، فمن الناحية اللغوية الدول المنتمية إلى إحدى اللغات الكبرى قادرة على المحافظة نسبياً على استقلالها اللغوي؛ وليس ذلك حال دول “إفريقيا السوداء” مثلاً المهددة بإنقراض لهجاتها المحلية والقبلية.. أما من الناحية الثقافية الواسعة فلا شك إن الثقافة الغالبة حالياً وأعني بذلك تحديداً “الثقافة الأميركية”، وبدرجة أقل “الثقافة الأوروبية”، تكتسب كل يوم مزيداً من التأثير، خاصة في البلدان غير المصنعة – درجة تأثيرها على “الصين” و”اليابان” لا تزال نسبياً ضعيفة – والدليل انتشار الاحتفالات برأس السنة الميلادية و”عيد الحب” و”هالوين” وانتشار الأنماط الموسيقية الغربية والملابس والمأكولات السريعة والمشروبات.. أما من ناحية المعتقدات فتمتلك الأديان ذات الحيوية الفائقة قدرة على التأقلم والانتشار وكسب أتباع جدد، وهذا ينطبق خاصة على “المسيحية الإنجيلية” و”الإسلام”، كما تنتشر ظاهرة لم يعرفها العالم من قبل وهي ظاهرة التنقل السريع من دين إلى دين؛ وإنتقاء المعتقد ونوع من التلفيقية بين أديان مختلفة، وكذلك وخاصة في أوروبا إكتساح “اللادينية”، والمقصود بذلك التوقف في مسألة الإيمان والإلحاد…

وتفرض العولمة على الأديان الكبرى تحديات تدفعها إلى مراجعة كثير من المسلمات وإلى تساؤل مستمر حول وظيفتها ودورها، من ذلك مناقشة الكنائس المسيحية لمسائل الإجهاض وزواج المثليين والكهنة المثليين وكهانة المرأة وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والبيئة والأخلاق.. وفي العلم الإسلامي تطرح مسائل تتعلق بوضعية المرأة وحقوقها وإمامتها للصلاة وترشحها للحكم وقضايا تتعلق بما يسمى بالردة أي تغيير الدين ومكان الملحدين في مجتمع إسلامي وقضايا الميراث…
وتجد الدولة الوطنية نفسها، في العالم الإسلامي، بين ضغطين ضغط المتأثرين بالعولمة والحداثة من جهة؛ وضغط الأصوليين والمحافظين من جهة أخرى والممثلين في حركات الإسلام السياسي والمؤسسات الرسمية.
من هنا اختلفت ردود الفعل من دولة إلى أخرى؛ مما عمق الاختلاف بين دول العالم الإسلامي، وهذا يعود في جزء منه لغياب كنيسة في الإسلام وفي جزء لإرتباط الدولة بالدين وإن بدرجات مختلفة، وهذا المعطى يجعل من بلدان العالم الإسلامي فسيفساء (سياسية – دينية)، وربما كان من وراء أسباب زيادة انتشار حركات الإسلام السياسي التي تجعل من توحيد العالم الإسلامي أولويتها الكبرى؛ وهذا التوحيد يتناقض طبعاً مع وجود وخصوصية الدولة الوطنية ذاتها، ولعل هذا صورة معكوسة لما تشهده أوروبا؛ حيث تجيء حركات الاحتجاج وتنمو دفاعاً عن الخصوصية ضد الإتجاه الوحدوي.
.. والآن.. ننتقل إلى المحور الثاني من نقاشنا: “كيف نستطيع ؟”..
(كتابات) : هل تعتبر “صراع الحضارات”؛ وما تمخض عنه مما نحياه الآن من تضخم النعرات السلفية والتراجع الفكري لقيم ثيوقراطية أو شوفينية، يمثل نتاج لتسارع حركة تلك العولمة الاخطبوطية ؟.. وإن كان الأمر كذلك فهل يمثل هذا الصراع الحضاري أول مسمار في نعش العولمة ؟
- لا أؤمن شخصياً بمقولة “صراع الحضارات”.. ولا وجود في الواقع لصراع حضارات إلا لمن لديهم رؤية سكونية للعالم ومغلقة للمجتمعات، والحال أن العولمة هي على الضد من ذلك؛ حركة متجهة قدماً نحو تحطيم الحواجز وفتح المجتمعات بإتجاه التعدد الثقافي والإثني والديني، وكل المتشبثين بهوية مغلقة وحضارات متصارعة يخوضون معارك خلفية تذكر بصرعات “الديك المذبوح”، فلا وجود في الفعل إلا لحضارة إنسانية واحدة؛ كما لا وجود إلا لجنس بشري واحد، ووحدة الجنس البشري لا تمنع من تنوعه، وكذلك وحدة الحضارة البشرية لا تمنع من تنوعها لغة وثقافة ومعتقداً وعادات وتقاليد.
إن تضخم النعرات السلفية والإتجاهات العنصرية؛ ليس سوى رد فعل على حركة العولمة المتصاعدة، حيث تنهار القيم والمثل القديمة لتفسح المجال لقيم ومثل جديدة أكثر تلاؤماً مع الواقع الفعلي، ورد الفعل هذا يعبر عن مزيج من الخوف ومن القلق من تغيرات متسارعة يعجز الفرد عن التحم فيها، وتبدو فيها الجماعات مهددة بالذوبان وبفقدان خصوصيتها اللغوية والثقافية والدينية، وهو ما يفسر تعاظم حركات الأقليات والطوائف الدينية؛ خاصة في المناطق الطرفية الموجودة في تماس مباشر مع مراكز العولمة، التي تمثلها اليوم الرباعية المكونة من “أميركا الشمالية وأوروبا والصين واليابان”.
لذا فلا أعتقد شخصياً إن مثل هذه الحركات وطفرتها الحالية تمثل مسماراً في نعش العولمة، لأنها حسب رأيي هي جزء من جدلية الفعل ورد الفعل، ولكن ليس بمقدورها وقف حركة موضوعية تتجاوز في مداها وقوتها ليس الدول فحسب؛ بل وحتى التجمعات الكبرى مثل “الاتحاد الأوروبي”.
وإنه لمن الدلالة أن يعمل المركز الممثل بالرباعية على التكيف مع العولمة بتوسيع ومضاعفة اتفاقيات “التبادل الحر” بين مناطقه وبين المركز والمناطق الدائرة في فلكه، في حين يجيء رد الأطراف في شكل تقوقع على الهوية وتمسك بوهم “النقاء الإثني” أو “الصفاء الديني”، بحيث يحاول مقاومة الصواريخ العابرة للقارات بالفروسية والسهام الطائشة !
(كتابات) : تُرى هل غياب أي مشروع فكري تقدمي وطني حقيقي عن الساحة العربية خاصة؛ وساحة مجتمعات دول الأطراف عامة؛ الآن، هو الدافع الرئيس وراء لجوء العقول الجمعية إلى الأفكار السلفية واستدعاء صراعاتها القديمة – أو حتى نكران السلف المتمثل في الإلحاد على الجانب الآخر ؟
- مثلما يقول المثل: “الطبيعة تكره الفراغ”، لذا فمن الطبيعي أن تنكفيء المجتمعات العربية والإسلامية على نفسها بعد فشل الدولة الحديثة – مع بعض الاستثناءات القليلة – في تحقيق التنمية والتحرر من التبعية واحترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات، خاصة في ظل غياب بدائل واقعية متناغمة مع المطالب الشعبية ومالكة لرؤية إستراتيجية وخطاب قادر على الحشد حول مشروع محرر وتقدمي.
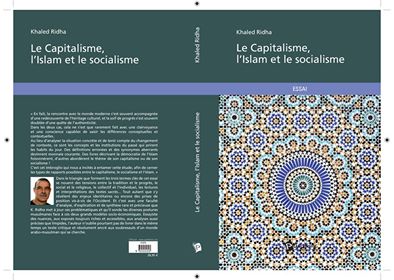
إن القطع مع الخطابات الرنانة والشعارات الجوفاء وأوهام الثأر والهيمنة والمراجعة النقدية لتجارب التنمية وتجارب الحركات والأحزاب التقدمية؛ هما شرطان ضروريان لبناء بدائل قادرة على مواجهة التحديات على المستوى السياسي، ولكن لا بد أن يصاحب ذلك ويهيئ له قيام حركة تنوير ثقافي وإصلاح للفكر الديني يخرجان عقول الناس من الزمن الغابر، زمن التكرار والتقليد والجمود على الموروث، إلى زمن الإبتكار والتجديد والتحرر من القوالب الجاهزة ومن الأحكام المعلبة.
وكما ذكرت ذلك، في أكثر من مناسبة، فان السلفية تشكل جواباً خاطئاً على سؤال صحيح؛ وهو لِم نحن بهذا الضعف والتخلف والتبعية على جميع الأصعدة ؟.. وهذا السؤال من العبث البحث عن جواب له في الماضي، أي في ظروف تختلف اختلافاً كلياً عن ظروفنا، بل الواجب هو فهم واقعنا ووضع حلول ملائمة له متجذرة في حاضر الناس وواقعهم المعيش، وليس باستيراد حلول جاهزة من الماضي أو من بلدان تختلف ظروفها عن ظروفنا.
إن مشكلة السلفية أنها تضيف إلى مشاكلنا مشاكل أخرى موروثة وصراعات قديمة؛ فتزداد الأمور تعقيداً، ولكن ذلك ليس سوى مؤشراً على أن ملفاتنا لا تزال مفتوحة وأننا لم نحل مشاكل الحاضر، لأن كثيراً من مشاكل الماضي لا تزال تلاحقنا وتقف خلف الستار لتظهر على الركح كلما سنحت الفرصة، وهذا يؤكد مرة أخرى ضرورة وأهمية إصلاح الفكر الديني من أجل تصور يتجاوز الصراعات القديمة والتفسيرات الموروثة إلى تصور منفتح على الواقع الحي وثري بثراء تنوع مكوناته.
(كتابات) : كيف يمكننا السيطرة أو تقليل سرعة هذه الخطوات المتسارعة للعولمة الثقافية ونقلل تأثيراتها على مجتمعاتنا ؟
- بادئ ذي بدء.. لا بد أن نسلم بأن حركة العولمة هي حركة لا يمكن إيقافها؛ ولا بد أن ندرك كذلك أنها بحكم سيطرة رأس المال العالمي عليها؛ حركة لا تخدم ضرورة مصالح الشعوب وخاصة مصالح الطبقات الفقيرة في البلدان غير المصنعة، وهي ككل ظاهرة إنسانية شاملة خاضعة لجدلية الفعل ورد الفعل، ويتجلى رد الفعل في ما يعرف بـ”الحركة من أجل عولمة بديلة”؛ والتي تجمع جمعيات ومنظمات وشخصيات تسعى إلى مقاومة الآثار السلبية للعولمة وتحض على تضامن أكبر بين ضحايا العولمة، وكان من أثرها ظهور المنتديات العالمية الاجتماعية وشبكات “التجارة العادلة” وعديد من المبادرات المواطنية القاعدية، التي تحاول إيجاد بدائل محلية إنتاجاً واستهلاكاً لكسر هيمنة الشركات الكبرى على الأسواق.
بموازاة مع هذه الحركات والمبادرات يمكن للدول غير المصنعة أن تتكتل حول منتوج مشترك مثل “تكتل منتجي الفوسفات” و”تكتل منتجي النحاس” و”تكتل منتجي القهوة”.. وغير ذلك من التكتلات؛ لفرض شروط أفضل على السوق العالمية وللحد من هيمنة الشركات الاحتكارية على عديد المنتجات.. كما يمكن للدول المتجاورة ضمن إقليم جغرافي تنسيق سياساتها التنموية وتطوير شبكات الطرق والمواصلات لتسهيل التبادل بينها وإنشاء شركات مشتركة قادرة على منافسة الشركات العالمية؛ على الأقل فيما يتعلق بالمنطقة الإقليمية، (الطيران مثلاً)… ولكن كل هذا يتوقف على إرادة سياسية وعلى وعي وإدراك بأهمية ذلك ليس للأجيال الحالية فقط بل وللأجيال القادمة أيضاً.
إن التخفيف من آثار التبعية والحد من التداين الخارجي والاعتماد على النفس والتعاون الواسع والعميق مع من هم في نفس الوضع ومع من لديهم نفس المصلحة؛ كلها وسائل بإمكانها الحد من آثار العولمة الزاحفة، بل أكثر من ذلك المساهمة فيها مساهمة إيجابية، بحيث يخرج الضحايا من دائرة رد الفعل إلى دائرة الفعل.
وعلى مستوى المجتمعات لا خيار إلا بفسح المجال للمبادرات الفردية والجماعية وتشجيع عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، التي بالتعاون مع نظيراتها في البلدان الأخرى، يمكنها القيام بأعمال وأنشطة تكون أكثر نجاعة وأكثر تأثيراً على مسار العولمة من الخطب الرسمية وبيانات الشجب والتنديد.
(كتابات) : المكون الثقافي لأي مجتمع هو المردود الموازي لقيمه ونظامه الاقتصادي؛ بمعنى أن المجتمع المرتكز على القيم الإستهلاكية اقتصادياً يتوازي مع مرادف ثقافي إستهلاكي، فكيف لنا الخروج من هذه الدائرة ؟
- لا شك أن هناك علاقة بين الثقافة والاقتصاد، ولكنها ليست ميكانيكية ولا في إتجاه واحد، ومع ذلك يظل تأثير الاقتصاد، منذ الثورة الصناعية، تأثيراً عظيماً؛ ولكن لا يخرج هذا التأثير أيضاً عن قانون الجدلية.. فكل فعل يستتبع رد فعل وإذا كانت الحركة العمالية والاشتراكية رد فعل على الثورة الصناعية في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين؛ فان رد الفعل منذ نصف قرن تقريباً تركز في دول المركز المتقدمة على البيئة والدفاع عن التنوع البيئي ومقاومة مظاهر التلوث والإنحباس الحراري، وكان من نتائجه تزايد الوعي لدى المستهلكين مما أثر بدوره على المنتجين في البحث عن وسائل بديلة للطاقة والنقل ومع انتشار الثقافة البيئية تزايدت المبادرات القاعدية والمحلية من أجل إستهلاك يحترم البيئة وأغذية بيولوجية، ونتج عن ذلك ظهور مزارع بيولوجية ومتاجر بيولوجية وأدوية بيولوجية، ولا زال الصراع مستمراً بين شركات الطاقة والكيمياء والأدوية وشركات صناعة الأغذية والملابس من جهة؛ وحماة البيئة والمستهلكين من جهة أخرى وكان من أثر ذلك تراجع عقلية الإستهلاك من أجل الإستهلاك؛ وإن كانت شركات التسويق لا تزال تحاول توجيه أذواق الناس والحث على الإستهلاك المستمر والمتزايد مع ما يستتبع ذلك من تبذير وتبديد للخيرات الطبيعية وتكاثر للنفايات وتلويث للبحار والأنهار، ولكن الوعي بالمخاطر ساهم في ظهور وتنامي ظاهرة “الرسكلة” أو إعادة استعمال المنتجات التالفة وإعادة استعمال المياه المستعملة واستعمال النفايات في إنتاج الطاقة وغير ذلك من مظاهر مقاومة النمط الصناعي القديم.
ومن الضروري أن ينتقل ذلك الوعي إلى المجتمعات غير المصنعة، حيث لا تزال مظاهر التبذير والتبديد فاشية في استعمال الأكياس البلاستيكية وحرق النفايات بدل إعادة استخدامها وتلوث الشواطئ واستعمال المواد الكيماوية في الزراعة مع المخاطر التي تحملها على الصحة وعلى المياه الجوفية، كما من الضروري ان يترافق ذلك الوعي مع إبتكار أنماط إنتاج بديلة وتشجيع للمبادرات المحلية والقاعدية من أجل تنمية تحترم البيئة ومتمحورة حول الحاجات الفعلية للسكان المحليين والبحث عن سبل أخرى للتكييف بدل انتشار المكيفات التقليدية المضرة بالبيئة والصحة والمستهلكة للطاقة.
إن مشكلة المستهلك في البلدان غير المصنعة؛ أنه لا زال أسير صورة المستهلك الغربي للسبعينيات، ذلك المستهلك الذي لم يكن يولي البيئة والصحة والإنسان المنتج والمستهلك أي قيمة بل يتمحور اهتمامه حول ذاته دون النظر إلى عواقب سلوكه على محيطه وعلى صحته وعلى الأجيال القادمة.
(كتابات) : لماذا إقترنت دائماً العولمة بقيم الحرية الاجتماعية/السياسية والديمقرطية ؟.. وإن كان ذلك مجرد خداع – كما أرى – فما السبيل إلى هدم تلك الخزعبلات مجتمعياً وسياسياً ؟
- في بداية الثورة الصناعية كان شعار البرجوازية الصاعدة الدفاع عن الحرية، ولكن ليس أي حرية بل حرية التعاقد مع عمال محرومين من أبسط حقوقهم؛ أي حرية فرض مصالح رأس المال بحيث لا ضمانة للعمال ولا حق للدولة في التدخل في شؤون رأس المال، وبما إن العولمة هي بالأساس عولمة رأس المال؛ فالحرية التي هي مقدمة على جميع الحريات وجميع القيم إنما هي حرية تنقل السلع والأموال، ومن هنا نشأت “منظمة التجارة العالمية” ومن هنا تسعى الشركات العالمية إلى فرض قواعدها على الجميع دولاً وشعوباً، بل إن النزاعات التي وضعت وجهاً لوجه عدداً من الحكومات وعدداً من الشركات العالمية انتهت بهزيمة الحكومات رغم إن كل الحجج وكل الحقوق كانت إلى جانبها، ذلك أن محاكم التحكيم تخضع في تركيبتها وطريقة عملها لإرادة رأس المال العالمي، لذا فلا يجب أن ينخدع الناس بشعار الحرية الذي تسوقه الشركات العالمية، فهو لا يعني الديمقراطية؛ إذ تتعايش هذه الشركات بكل طمأنينة مع أعتى الدكتاتوريات ما دامت الأرباح مضمونة، ولذلك قلما توجه إنتقادات للصين على إنتهاكاتها لحقوق الإنسان وحدها من الحريات الفردية والجماعية.
إن النضال من أجل مجتمع حر وعادل لا يهم في شيء رأس المال العالمي، وإنما ذلك شأن الأفراد والجماعات الخاضعة لنظم مستبدة وظالمة، وعليها وحدها مسؤولية العمل والكفاح من أجل رفع نير الاستبداد والاستغلال، وضمان الحريات والحقوق والكرامة الإنسانية، وكل “ديمقراطية” مفروضة ليست في الواقع سوى صورة مشوهة للديمقراطية وتنفيراً للناس من النضال من أجل الديمقراطية، وأبلغ مثال على ذلك ما حدث في العراق، حيث تحولت الديمقراطية إلى مهزلة “محاصصة طائفية” وقطيعة بين النخبة الحاكمة وعامة الشعب.. إن الديمقراطية لا تنجح في غياب المواطنة، أي إحساس الإنتماء إلى وطن قبل الإنتماء إلى طائفة أو مذهب، ولا يمكن أن تنجح في ظل تمييز عرقي أو طائفي، فالديمقراطية ليست انتخابات حرة فحسب؛ بل جملة من القيم والممارسات قائمة على الحرية والمساواة واحترام الحقوق والقبول بالتعدد السياسي والثقافي واحترام المعارضة والإيمان بضرورة التعايش والتعاون.


