خاص: قراءة- سماح عادل
رواية “آخر الملائكة” للكاتب العراقي “فاضل العزاوي” رواية بارعة حيث تحكي عن الشعب العراقي منذ ما قبل فترة الخمسينات، بأسلوب سلس يتميز بحس سخرية عال وبإطار من الفانتازيا.
الشخصيات..
حميد نايلون: رجل كان يعمل في الشركة البريطانية التي تستخرج النفط، وقد فصل من عمله مما سبب حدوث اعتراض من قبل أهله وذويه، ثم تحول إلى قائد للثورة المسلحة وسجن وعذب.
برهان عبد الله: فتى يافع، أحب كتابة الشعر، كان يرى ملائكة ثلاث ويستعين بهم، ثم هاجر من بلاده وعاد بعد 64 عاما.
خضر موسى: وهو تاجر أغنام، كان كل ما يهمه هو جمع المال، ثم تحول إلى قائد في محلته، وله مكانة كبيرة بينهم.
وشخصيات أخرى ثرية في تفاصيلها.
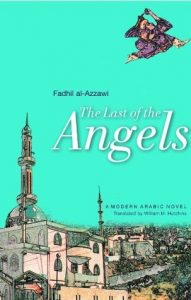
الراوي..
الراوي عليم، ساخر، يحكي بأسلوبه المرح والسلس عن الشخصيات، وعن تطور الأحداث، يميل إلى الحكي عن الشخصيات من الخارج وفي تفاعلاتها مع الأحداث ومع الشخصيات الأخرى، ولا يميل إلى كشف انفعالاتهم الداخلية ومشاعرهم، باستثناء “برهان عبد الله” الذي رصد انفعالاته تجاه ما يحدث في محلته التي تعد رمزا مصغرا للوطن.
السرد..
الرواية تقع في حوالي 374 صفحة من القطع المتوسط، تنقسم إلى 12 فصل، من دون عناوين لها، يركز السرد على الشخصيات وعلى الأحداث التي تمر بها في “محلة جقور” التي اختارها الكاتب كمكان للسرد، وهي في مدينة “كركوك”، والفترة الزمنية تمتد منذ الخمسينات ثم تقفز قفزة زمنية حوالي 64 عاما عندما يعود البطل “برهان عبد الله” إلى وطنه بعد أن تركه طوال تلك السنوات، ويرى التغيرات التي حدثت به، لكنها تغيرات أقرب إلى الفانتازيا منها إلى الحقائق الواقعية. وتنتهي الرواية نهاية سعيدة حيث يتوقع “برهان عبد الله” أن يسود السلام والمحبة في بلاده.
حس السخرية..
الرواية بارعة في أسلوب الحكي الذي يمتلئ بحس السخرية والمبالغة، كما يعتمد على ظواهر عجائبية ويحكي عنها وكأنها من المسلمات، حيث يختلط الخيال بالواقع، فيتخيل القارئ أن الكاتب يتعامل مع الغيبيات على أنها حقائق مسلم بها، لكن في الواقع إنه يرصد نفسية البسطاء وتصوراتهم وأفكارهم حول تلك الغيبيات، وكيف يؤمنون بها ويقدسونها إلى حد كبير.
تدور أحداث الرواية في “محلة جقور” التابعة لمدينة “كركوك” والتي تعد بمثابة نموذج مصغر للوطن العراق، حيث وقت الاحتلال البريطاني وحكم الملك الذي لم يكن له دورا حقيقا في الحكم لأن من يدير دفة الحكم الوصي والمسئولون حوله الذي يتبعون الاحتلال البريطاني ويوالونه، وتتمثل قوة الاحتلال في الرواية في شركة النفط التي تنهب نفط البلاد، ويعمل لديها عدد كبير من العراقيين، ورغم أن الشركة تعطي رواتب للعمال أفضل من الرواتب في مؤسسات أخرى مما جعل للشركة مكانة خاصة في نفوس الناس، لأنها وفق رؤيتهم تعامل عمالها برفق أكثر مما تعاملهم حكومتهم.
الإضراب..
لكن ذلك لم يمنع العمال من الإضراب والتمرد على الشركة، وقد قوبل هذا الإضراب بالشدة والقسوة من قبل الحكومة العراقية آنذاك، رغم ميل المسئولين في الشركة للتعامل مع العمال باللين، أولا لأن بعض المسئولين هم من الاشتراكيين وثانيا لأنهم خافوا من تأثير ذلك التمرد خاصة وأن الحركة الشيوعية في ذلك الوقت كانت في أوج ازدهارها، وكان تأثيرها على البلدان المحيطة أشبه بالسحر بسبب أفكار المساواة والعدالة الاجتماعية والانبهار بقوة الاتحاد السوفيتي.
لذا نجد حركات تمرد كثيرة تنتاب أهل “محلة جقور” وتقابلها الحكومة بقسوة وشدة، ويحاول الاحتلال البريطاني التعامل معها بمرونة ولين.
الإيمان بالغيبيات..
كما يسود الإيمان بالغيبيات وتقديس الأولياء حتى أنه حين قتل أحد الأفارقة يدعى “قرة قول” الذي كان يعمل كحلاق ومعروف بأخلاقه السيئة في أحد حركات التمرد التي قام بها أهل المحلة، رفع الناس من قيمة هذا الرجل الذي اعتبروه شهيدا ثم رفعوه إلى مرتبه ولي، ثم أصبح الناس يتوافدون من جميع الأنحاء لزيارة ضريحه، وقد تسبب ذلك في وجود مكان يجلب أموالا طائلة وبالتالي تكاثر الطامعون في نهب تلك الأموال التي تتساقط على الضريح ممن يطلبون أشياء من الولي لتحقيقها.
نجد “الملا زين العابدين القادري” وهو أحد شيوخ المحلة المعروف بورعه يطمع في هذه الأموال، ويقرر أن يكون هو من يدير شؤون الضريح، وبالفعل يتسنى له ذلك ويقوم بنهب الأموال الخاصة بالضريح لنفسه ويغضب حين تطالبه زوجة “قرة قول” بنصيب في تلك الأموال ويرفض إعطاءها، مدعيا أنها أموال المسلمين وهو يحافظ عليها، وهو نموذج لرجل الدين الذي يستغل مكانته للنهب والاستيلاء على الأموال مدعيا أنه يخدم الدين ومصالح الناس.
الثورة الفلاحية..
كما كان “حميد نايلون” نموذجا للرجل العادي الذي يشعر بقهر النظام له ويرفض الاحتلال الذي ينهب بلاده فيقرر التمرد وأن يحرك الثورة ويسعى إلى عمل نموذج للثورة الفلاحية، على غرار تجربة “ماوتسي تونغ” الصينية ويغري المتمردين من الفلاحين على إتباعه ومقاومة الحكومة وينجح بالفعل لكن بتوفير مرتبات وأموال لهؤلاء لكي يتبعونه، وليس على أساس المبادئ والأفكار، لكن الحكومة تقمع حركته وتقبض عليه وتحبسه لسنوات عدة في سجن قاس.
وتصور الرواية كيف كان الشيوعيين جماعة من الناس الذين يتبعون الفكر الشيوعي بتزمت ودون فهم أو وعي حقيقي، فهم يتبعون الاتحاد السوفيتي دون محاولة منهم لعمل تجربة تخص بلادهم وخصوصياتها، وإنما هم أتباع لا عقول لهم ولا فهم ولا محاولة للتغيير. ويتجلى ذلك حين لجأ إليهم “حميد نايلون” لكي يستعين بهم في تحقيق حلمه الأثير وهو قيام الثورة الشعبية، لكنهم أحبطوه وقالوا له أن ذلك لا ينفع لأنه سيضر بالاتحاد السوفيتي ومصالحه، وكأن مصلحة الاتحاد السوفيتي لديهم أهم من مصلحة وطنهم مما يشي بمدى جمودهم.
بذور العنف الشعبي..
ترصد الرواية أيضا بذور العنف الشعبي الذي يدور، والذي يتغذى على الاختلاف العرقي بين الناس الذين يعيشون في “محلة جقور” والتي تعد نموذجا مصغرا عن العراق، فما بين التركمان والعرب والكرد وفئات أخرى، رغم استطاعة هؤلاء التعايش السلمي أيام حكم الملك والاحتلال البريطاني إلا أن أقل حدث كان يشعل الفتنة بين تلك الفئات. لكن الرواية أيضا أكدت على إمكانية التعايش السلمي رغم اختلاف العرق والدين.
وقد تناولت أيضا الرواية أحداث تموز بسرد يعتمد على الفانتازيا كما هو معتاد في باقي السرد، حيث صورت الحاكم العسكري بمبالغة لترصد كيف كان يتم تقديسه والتعامل معه كديكتاتور، وكيف كانت تدور الصراعات على الحكم منذ قتل الملك وترسيخ الحكم الذي أتت به أحداث تموز، وكيف ساهم ذلك الحكم في تكريس الفرقة والاختلاف بين فئات الشعب، فقد كان هذا الحكم أحد أهم الأسباب في تغذية الفرقة، كما لم يخدم هذا الحكم الوطن وإنما غرق في صراعاته وفي تفريخ الحكام المتسلطين الذين كانوا يمسكون السلطة بعد التخلص من السابقين.
يمكن القول أن الرواية رصدت نفسية البسطاء الذين يقدسون الغيبيات لكنهم يتمردون على الظلم ويسعون إلى إثبات قوتهم في وجه السلطة الغاشمة، ويستطيعون في لحظات التمرد التوحد على كلمة واحدة وفعل واحد رغم اختلافاتهم وتنوعاتهم الكثيرة. حيث كان يتمرد الناس على الحكومة والشرطة بصلابة وحس جماعي عميق. لكن كثرة الصراعات وتوالي الحكام القساة أفقدهم حلاوة حياتهم وجعلهم يعيشون أزمان طويلة من البؤس والشقاء.
اعتمدت الرواية على لغة ساخرة وأسلوب سلس في الحكي، وكانت الشخصيات أشبه بنماذج لأنواع من البشر، كما أكدت الرواية على التعايش السلمي وعلى التسامح بين الأديان.

الكاتب..
“فاضل كلو العزاوي” شاعر وروائي ومترجم عراقي. ولد في مدينة كركوك 1940. تخرّج في جامعة بغداد مجازًا في الأدب الإنكليزي عام 1966 ثم حصل على الدكتوراه من جامعة لايبزيغ في ألمانيا عام 1983. عمل في الصحافة. ساهم في إصدار مجلّة “الشعر 69” في بغداد، وهو واحد من أربعة شعراء أصدر ما عرف بـالبيان الشعري الذي أثار ضجّه في حينه. يعتبر من مؤسسي “جماعة كركوك” التي تضم (سركون بولص وجان دمو ومؤيد الراوي وصلاح فائق) والتي اهتمت بقصيدة النثر.
من دواوينه الشعرية:
- “سلاماً أيتها الموجة، سلاماً أيها البحر” عام 1974.
- “الأسفار” 1976.
- “صاعداً حتى الينبوع” 1993.
من رواياته:
رواية “مخلوقات فاضل العزاوي العجيبة” التي صدرت سنة 1969 ثم أعيد نشرها عن دار الجمل عام 2002.
رواية “القلعة الخامسة” التي صدرت عام 1969 ثم نُشِرَتْ عن منشورات الجمل عام 2002 وتم تحويلها إلى فيلم.
رواية الأسلاف.
رواية “آخر الملائكة” التي صدرت عام 1992 والتي ترجمت إلى اللغة الإنكليزية تحت عنوان The Last of the Angels عام 2007.
الرائي في العتمة، منشورات الجمل، كولونيا، ألمانيا، 2016.

