خاص: قراءة – سماح عادل
يرى المخرج الفرنسي “هنري جورج كلوزو” أن السينما تخاطب الجمهور، وأن السينما تشيخ سريعا، وأن فشل الفيلم جماهيريا ليس ذنب المتفرجين. وعن أفلام الرعب والتشويق التي يحب إخراجها يقول أنه يركز على أن يجعل الجمهور يتعاطف مع الضحية، ويضع نفسه مكانها حين تتوقع الخطر. ويقول “جان ديلانوا” أنه يفضل أن يجره إلى أمور لم يعتدها ومناقشة مشكلات جديدة، ويهاجم الأفلام التي تعتمد على الجنس والعنف، ويرفض الأفلام التي تغذي قناعات زائفة لدى الشباب.
نواصل قراءة الكتاب المميز (قرن من السينما الفرنسية.. من خلال اعترافات مخرجيها)، تأليف “إيريك لوغيب”، ترجمة “محمد علي اليوسفي”، حيث يحتوي على عرض حوارات أبرز المخرجين في السينما الفرنسية. لنتعرف من خلال تلك الحوارات على السينما الفرنسية ورموزها واتجاهاتها.
هنري جورج كلوزو CLOUZOT Georges –Henri
“هنري جورج كلوزو” مخرج فرنسي، ولد سنة 1907 و توفي في باريس 1977. عمل مساعداً ل”أناتول ليتفاك”. وضع سيناريو وحوار” المتمرد” 1938 و”غرباء في البيت ” 1941. من أبرز الأفلام التي أخرجها:
(القاتل يسكن في الرقم 21، 1942؛ الغراب 1943، ” كي ديزورفيفر 1947 ؛ مانون 1948؛ ميكات وأمها 1949، جزاء الخوف 1952 ؛ الشياطين 1945؛ لغز بيكاسو 1955؛ الجواسيس 1957؛ الحقيقة 1960 ؛ السجينة 1969)وللتلفزيون: (مسلسل حول هربرت فان كاراجان).

الغراب..
يقول “هنري جورج كلوزو” عن كيف ظهرت موهبته السينمائية: “تلقيت فتنة السينما في مرحلة سبقت 1914. كانت أفلام شابلن الأولى تصيبني بالخوف. وكنت أبكي أكثر مما أضحك. كان يترك فيّ الأثر نفسه الذي سوف يتركه مهرّجو فلليني. ولم يمنعني ذلك من كتابة أول مسرحية عرائس وأنا في سن السادسة. لكن ميولي الفنية لم تكن ترضي أهلي مع أن أحد أخوالي كان ناقداً سينمائياً. ولقد شغفت بالسفر. وقبل الانطلاق في المغامرات، درست العلوم السياسية”.
وعن تسلسل صدور أفلامه يقول: “بعد تعاوني مع رونيه دوران، كذلك مع جونسون الذي خرب فكرتنا حول السيناريو، غامرت بإخراج فيلم عن “مفيستو” آنذاك!.
بدأ الفيلم صامتاً وانتهى ناطقاً. وبذلك أكون مخرجاً مخضرماً. بعد ذلك أنجزت فيلم “ابنة عمي الفرصوفية”. وفي ذلك الوقت كان مجرد الانطلاق كفيلاً بالاستمرار. وهكذا عملت مساعداً لأناتول ليتفاك. وعلى رغم أسبقية “القاتل يسكن في الرقم 21” يظل أول فيلم بالنسبة لي هو “الغراب” وهو عبارة عن تصفية حساب لازمتني منذ طفولتي؛ تصفية حساب بين حياتي وبيني”.
وعن تعامله مع الممثلين يقول: “تسأل عن الممثلين؟ أول ما أسعى إليه هو استغلال سلبياتهم وعيوبهم. ذلك أن تلك العيوب التي يستحيل محوها يمكن جعلها ذات قيمة على الشاشة. أما محاسنهم فيتوجب علينا، نحن السينمائيين، أن نطورها. بشكل عام، أفكر في الممثلين منذ كتابة السيناريو وخاصة الرئيسيين منهم. أراعي بنيتهم الجسدية، وأسعى على اكتساب ثقتهم.
أما طريقة إدارتهم فهي مختلفة ومتنوعة وفق المشاهد وشخصية الممثلين. أحرص كثيراً على إيقاع النص. عندما يتنفس المرء جيداً، يمثل جيداً. ولكي يتمكن الممثل من تمثيل حالة الغضب لابد من جعله يعيشها. وما عدا ذلك لا أتعامل مع الممثلين كقطيع. يمكننا أن نسوق سيارة معطلة، لكننا لا نتمكن من فعل ذلك مع سيارة تفتقر إلى محرك. ويمكن للممثلين أن يكونوا مرتبكين، لكن لا ينبغي أن تكون رؤوسهم خالية. ولكي نعود إلى العبارة التي تنسب إلى هيتشكوك، حول الممثلين كقطيع من الماشية، ألاحظ بأنه لم يختر ممثلين فاشلين قط. ولم يكن أنطوني بركنز في دور أجمل من دوره في شريط “سايكو”.
السينما تهرم بسرعة..
وعن معنى السينما بالنسبة له يقول: “ليست السينما فناً فقط، بل هي تحكيم للمستقبل. السينما تهرم بسرعة, وعندما لا يتمكن شريط من النجاح لدى عرضه الأول فإنه لن يحقق أي نجاح بعد عشرة أعوام. السينما تخاطب الجمهور. وما ننجزه ينبغي أن ينال إعجاب الجمهور. وإذا لم يتحقق ذلك فالذنب ليس ذنب الجمهور.
ويجيب عن سؤال ما هي المعايير التي تجعلك تقرر البدء بإخراج فيلم:”إن الاختيار، أو الشرارة الأولى، يأتيان من صورة خيالية، وهي صورة لا تبقى كما كانت في بداية الفيلم، رغم أنها شكلت شرارته. لو أخذت فيلم “مانون” كمثال، فإن صورة معينة رأيتها في السابق هي التي دفعتني إلى إنجاز هذا الشريط الطويل. وكذلك كان الشأن في شريط “جزاء الخوف” كان ديكور أمريكا الجنوبية جاهزاً في ذهني قبل لقائي مع جورج آرنو، وقس على ذلك بالنسبة إلى أفلامي الأخرى.
وعن المخرجين الآخرين الذين سبقوه يقول: “كثيراً ما جرى الحديث عن ايريك فون ستروهم باعتباري متأثراً به في شريطي الأول. لكنني لا أخفي إعجابي الكبير بفريتز لانغ، ومورنو، وشابلن، وايزنشتاين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أحب هيتشكوك أيضاً، كما أحب مخرجاً آخر أقرب مني هو فرد زينمان. ذلك إن شريطه “رجل من أجل الأبدية” ترك في نفسي تأثيراً عميقاً”.
وعن أهمية التقنية يقول: “كل شيء يتوقف على ما تعنيه بالتقنية. أنا لا أؤمن بقواعد تقنية صارمة. التقنية الوحيدة التي أؤمن بها هي الشجاعة التي تحول دون إضاعة الوقت وتتيح وضع الكاميرا في المكان المناسب أي حيث يتوقع المشاهد، دون أن يدري، رؤية الصورة… لا يزعجني غياب التقنية ما دمت لا أرى الكاميرا، الأمر الذي لا يتطلب سوى حدّ أدنى من تورط المتفرّج في الحكاية المرويّة”.
التعاطف مع الضحية..
وعن تعريفه للتشويق والتوتّر والرعب على الشاشة يقول: “للتوتر والخوف تعريفات كثيرة. وليس هناك إجماع بين أهل الاختصاص. لابد في البداية، من جعل المتفرّج متعاطفاً مع الشخصية التي ستتحول إلى ضحية، فيشاطرها القلق وكلما واجهتها عقبة ازداد تعاطفه، خاصة إذا كان المتفرج عارفاً، مسبقاً، بما ينتظر الضحية. القلق والتوتر تمديد للانتظار، سيف دمقليس المعلّق فوق رؤوس الشخصيات، بينما يشعر المتفرجون أن رؤوسهم هي المهدَّدَة بالقطع”.
وعن كيف يتم الإيحاء بالتوتر والقلق ثم فرضه يقول: “يتم ذلك عبر تفاصيل صغيرة متسلسلة، ولمسات تعطي مصداقية للشخصيات ولأبعادها. وهكذا فقد لجأت في فيلم “الشياطين” إلى إعادة كتابة السيناريو أربع مرات، مع تغيير جنس الشخصيات في كلّ مرة. والخوف هو اللازمة، أو النتيجة الطبيعية للخطر. ومن أجل الإيحاء به في السينما، توجد عدّة وسائل تم الإفراط في استخدامها مثل: الانعكاسات، الظلال، المرايا. أنا شخصياً أرفض هذا النسق، وأفضّل الإيحاء والتلميح”.
ويجيب عن سؤال هل صدّقت الخوف في أفلامك، أو في أفلام غيرك يقول: “شاهدت شريط رومان بولانسكي “روزماري بايبي” ولم أشعر بالخوف ولو للحظة. أنا لا أخاف الشيطان. ما إن يظهر حتّى انفصل عن المشاركة أو التورّط. قاومت الرغبة في إخراج فيلم عجائبي لأنه نوع لا يستهويني كمتفرج لمدة ساعة ونصف، إلا إذا تم السقوط في التقاليد المعروفة ضمن أسلوب دراكولا وفولكلور مصّاصي الدماء. أنا أميل إلى ذلك النوع من التداخل الذي ينزل شيئاً غريباً، أو غير مألوف، في سياق ما هو يومي. لا أظن أن الشيطان يلعب مثل تلك الأدوار الصبيانية الساذجة إذا كان موجوداً. ونظراً لكوني إنساناً مؤمناً بالله، فأنا مؤمن بكون الشيطان تجسيداً أو تخيّلاً للشر. الشيطان موجود، في رأيي، وهو يسكن المتاجر الكبرى والأحياء السكنية المكتظة أكثر من وجوده في القصور المهجورة والأماكن الخالية”.

– وعن إعجابه بكُتّاب الأدب العجائبي يقول: “قرأتهم كلهم. تريد أسماء؟ هوفمان، خورخي لويس بورخيس، هنري جيمس… وفي مجال الخيال العلمي اذكر راي براد بوري. أما في مجال الفلسفة فلم أعجب بأحد. كل المنظومات الفلسفية يلغي بعضها بعضاً. ويمكنني ذكر أولئك الذين ساعدوني في الحياة مثل نيتشه وهيغل وأفلاطون… اهتممت كذلك بالوجودية والبنيوية؛ غير أن كل هذه المنظومات تتبادل عملية المحو. لِمَ يسمح الإله بموت طفل أو حيوان؟ هذه كارثة. والإيمان الصادق يرفض ذلك.
أرفض أيضاً كل حكايات السحر. عمليات الإفلاس في متاجر اليوم أفظع من تمظهرات الأشباح. لا يمكننا اليوم أن ننجز أفلاماً كما كنا نفعل قبل أيار/مايو 1968. لقد حدث انفجار كبير وبرزت معطيات جديدة. فهل تظهر هذه المعطيات في السينما؟ لهذا السبب أيضاً أرفض إخراج أي فيلم “تاريخي””.
ويجيب عن سؤال هل تعتبر نفسك مخرج أفلام سيكولوجية: “لم يعد لعلم النفس من معنى مهم، هذه الأيام, في السينما. وضمن المصطلحات السينمائية الدقيقة لا يمكن فرض الشخصيات ذات الأطوار الشاذة، بل ينبغي الانطلاق من سلوك الشخصية وتصرّفها للتوصل إلى فرضها سينمائياً. وليس من المهم، عند البطل، مواقفه، بل حركته وأفعاله. يضاف إلى ذلك أن الوعي الجمعي خاضع للحِراك والتحول، بحيث يغدو التحليل النفسي غير كافٍ. كما أن الزمن يقضي على الشخصيات بسرعة متزايدة”.
وعن واستلهامه للرسامين يقول: “عندما أنجزت شريطي حول بيكاسو، كنّا قد أعددنا له مطوّلاً. بيكاسو أعظم مبدع للأشكال منذ شاردن وبراك. كان هدفنا جعل الرسام يعيش حياته من دون إظهار أعماله. هناك رغبة في ترك صورة قريبة من الواقع، لفنانين كبار أحببناهم”.
وعن الموسيقى أيضاً، من خلال فيلمه “حول هربرت فون كاراجان”، للتلفزيون يقول: “تلفزيون، سينما… لا فرق في وسيلتيْ التّعبير ما دام الأمر يتعلق بشخصيتيْ بيكاسو وكاراجان. وعلى ذكر الموسيقى يتوجب عليّ القول إن هناك مبالغة في استخدامها كحشو للصورة – وهذا ما سعيت دوماً إلى تحاشيه”.
وعن فيلمه غير المكتمل “الجحيم” يقول: “آمل أن أعود إليه لاستكماله، أو الانطلاق به من نقطة الصفر. كيف؟ متى؟ هذا سرّ”.
ويجيب عن سؤال أين أنت سينمائياً يقول: “بعد خيبات كثيرة ما زلت أبحث يائساً عن موضوع، عن سيناريو، عن رواية يمكنني اقتباسها. يصعب، أمام هذه الأحداث المتسارعة، إيجاد حكاية لا ينتهي مفعولها قبل الانتهاء من تحويلها إلى صُوَر”.
جان ديلانْوَا Jean DELANNOY
“جان ديلانْوَا” مخرج سينمائي ولد سنة 1908، من أبرز أفلامه التي أخرجها: (باريس، دوفيل (1935)؛ العودة الأبدية (1943)؛ السمفونية الرعوية (1946)؛ تمت اللعبة (1947)؛ بعيون الذكرى (1948)؛ الرب يحتاج إلى البشر (1950)؛ دقيقة الحقيقة (1952)؛ طريق نابليون (1953)؛ وسواس (1954)؛ كلاب ضائعة بلا أطواق (1955)؛ ماري أنطوانيت (1955)؛ نوتردام دو باريس (1956)؛ ميغريه ينصب فخّاً (1957)؛ أميرة كليف (1961)؛ صداقات خاصة (1964)؛ شمس الرّعاع (1967)؛ هذه النحيلة ليست مجنونة (1972)؛ برناديت (1988).
وللتلفزيون: (شارلمان ورولان؛ المؤامرة الكبرى (1978)؛ الشاب والأسد؛ مانون؛ الصيف الهندي؛ انقلاب 2 ديسمبر العسكري؛ الأخ مارتان؛ جريمة بيار لاكاز).
تنوع في الإلهام..
يقول “جان ديلانوَا”، عن نظرته إلى السينما يقول: “لا شك، مبدئياً، أن تجربتنا، كسينمائيين، ينبغي أن تيسّر لنا تطوراً مستمرّاً، سواء على المستوى الداخلي أم في ما يخص الصورة. لقد عالجت كلّ الأنواع ويمكنني القول إنني لم أكرر نفسي. وبما أنني أنجزت أربعين شريطاً فهذا يتضمن تنوعاً كبيراً في الإلهام. علينا كسينمائيين أن نظلّ تلاميذ أبديين حتى نتمكن من ممارسة مهنتنا. لا أعتقد أن ثمة علاقة بين “أميرة كليف” و”ميغريه ينصب فخّاً” على سبيل المثال. أحب تنويع مصادر الإلهام. وهذا ما يجبرني على العمل مع متعاونين جدد. فالتجديد المستمرّ هو أحد شواغلي في كلّ الميادين. وهو ما يجعلني أقول إنني من المخرجين النادرين الذين لم يكلفوا جان غابان بأداء الدور نفسه أكثر من مرة.

وعن طريقة إدارته للممثلين يقول: “تتعدد الحالات بتعدد الممثلين. هناك من يستجيبون كليّاً للمخرج، وربما بالغوا في ذلك، وهناك من يرغبون في التفرّد. ثمة من يتوجب على المخرج أن يبتكر لهم شخصيات، ومن يتصرفون كالأطفال المقلدّين لكل ما يرضي المخرج. والحقيقة أن مهنة السينما في منتهى الصعوبة بالنسبة للممثلين. ويعتبر تدخّل المخرج في أدائهم بالغ الحساسية. إذْ تتوجب عليه قيادتهم من دون شك، لكن من دون إخضاعهم إلى صورته. المهم هو ترسيخ استمرارية أدوارهم ضمن المراحل المتقطعة للتصوير. والممثل الجيد بالنسبة للمخرج، هو الذي يستجيب لموقعه على السكة ثم يتمكن من الحصول على استقلاليته ضمن هذا المحور.
أجد أن إدارة الممثلين هي المرحلة الأكثر شغفاً في عملية الإخراج، في نطاق أن ما يهمني في البداية هو الشخصيات، ومن ثم تأتي مرحلة إدارتهم. من الضروري أن يقدم كلّ ممثل مساهمته الحيّة في الحكاية. ولقد لاحظت أنه من الصعب على الممثل أن يتقمص دوره مباشرة ويحافظ على كثافته وقوته خلال اللقطات والمشاهد المتعاقبة، مع ما سيأتي به المونتاج لاحقاً. وعلى سبيل المثال، كان جان غابان على النقيض تماماً من الممثلين المستجيبين لكلّ شيء. كان يحتاج إلى من يطمئنه ويؤكد له أنه لم يخطئ. وهذا يستدعي من واضعي الحوار أن يكونوا ملمّين بشخصيته، وبالكلمات التي يمكنه أن ينطقها بشكل طبيعي، وتلك التي قد تجعله يتعثر في أدائها. إن كلمة واحدة لا تناسبه يمكن أن تعطل العمل كله”.
مشاكل جديدة..
وعن شعوره بالمسؤولية إزاء المتفرجين يقول: “هناك مسؤولية مطلقة إزاء الزمن المسرع، والمال المنفق، والنتيجة الفنية المنشودة. وهذا لا يعني إهمال رأي الجمهور. لكن من دون الخضوع لذوقه. لقد كنت دائم الوثوق به. غير أنني أفضل جرّه إلى أمور لم يعتدها، ومشاكل جديدة تطرح أمامه”.
وعن الافتتان باقتباس أعمالاً أدبية كبيرة ونقلها إلى الشاشة يقول: “لقد انجذبت دائماً إلى الكُتَّاب الذين وجدت لديهم انسجاماً في الرؤية، على غرار جيد وكوكتو. وينبغي التذكير بأن أحد أهداف السينما هو ترغيب المتفرّج في قراءة العمل الذي شاهده على الشاشة لتوّه. غير أن الكتب الجيدة لا تصنع أفضل الأفلام. ويتوقف ذلك على الفترة الزمنية أيضاً. وفي هذا المجال فكرت مع كوكتو في إمكانية نقل قصة “تريستان وايزولت” إلى السينما. لكننا أدركنا أنه لا يمكن تقديم حكاية يموت فيها الناس حبّاً، بينما تحصد الحرب أرواح البشر. ولا شك أن الأساطير الكبرى، وكذلك التراجيديات الكبرى، صالحة لكل الأزمان، غير أنه يتوجب اختيار الوقت المناسب لتقديمها.
وبالنسبة لفيلم “بونكارال، كولونيل الإمبراطورية” فقد أخرجناه في وقت كان يستوجب بعث الإحساس بنوع من العظمة، أي إحساس البطولة على صعيد حركة المقاومة، في مرحلة حرجة. وهكذا قدمنا شريطا عن الكفاح والأحداث الجارية رغم رقابة المحتلّ.
أما بالنسبة إلى شريط “أميرة كليف” فقد كان من المثير أن يتم التعرض إلى حب مستحيل في فترة عرفت بالعلاقات السطحية. كذلك عندما أخرجت “هذه النحيلة ليست مجنونة” أردت تقديم شريط مسلٍّ. وذلك رداً على المبالغة في إرهاب الجمهور بأفلام فظيعة. كان اهتمامي الخاص هو أن أتسلى وأن أسلّي الناس من دون ابتذال. وهذا لا يمنع أن تأتي بعض الأفلام غير مواتية لزمنها. لكنني أصرّ على تقديمها بعد الانتهاء من إخراج فيلمين أو ثلاثة.
وعن الاستمرار بهذه الطريقة يقول: “آه! نعم. لقد عالجت هذه المشكلة كثيراً، في الأعوام الأخيرة، وذلك بكتابة مواضيع رغبت في تصويرها، لكنني أعرف أنه يتعذّر إخراجها. وحتى إذا تم ذلك، فإنها سوف تكون سابقة لعصرها. عندما نقدّم عملاً ونظنّه يتحدث عن الراهن، فيأتي بعكس التيار، يكون معنى ذلك أنه سابق لأوانه. لقد أدركت ذلك عندما صوّرت “الرب يحتاج إلى البشر”. ولا أستطيع الامتناع عن الضحك الآن عندما أتذكر بأن هذا الفيلم آثار استنكار الكنيسة التي وجدت فيه مثاراً للفضيحة. كذلك الشأن بالنسبة لشريط “صداقات خاصة” الذي مُنع على من هم دون الثامنة عشرة.
مازلت أؤجل بعض الأفلام التي تثير اهتمامي، مدركاً أنها سوف تكون سابقة لأوانها. لكنني أتسلّى بإعدادها وكتابتها”.
وعن شعوره بنوع من القربى مع سينمائيين آخرين يقول: “في الحقيقة، لو كانت هناك ألفة صادقة بين المخرجين لكانوا يلتقون ويتزاورون. والحال أننا لا نعرف بعضنا بعضاً. كل مخرج يعيش عزلته بطريقته الخاصة.
في ما يخص الإعجاب أعترف بذلك تجاه وليم ويلر الذي أخرج العديد من الأفلام الجميلة، وكذلك أندريه كايات. تعجبني أيضاً بعض أعمال رينيه كليمون. وقد يعجبني شريط واحد مثل “بوني وكلايد” بسبب آفاقه الملحمية وتسامي موضوعه.
لكنني أنكر أي شعور، إلا إذا كان سلبياً، إزاء أولئك الذين يريدون البرهنة أو الدفاع عن موقف أو قناعة سياسية حتى وإنْ كانت عميقة. ما يهمني هو ما يجري في الداخل، في أعماق الكائن، وليس الأمواج المضطربة بفعل المدّعين، وليسوا في الواقع سوى سدّادات فلّين تحملها تلك الأمواج.
سوف يأتي يوم أكون فيه أكثر جرأة وأقدّم عملاً أفضل مما يُعرض اليوم. أطرح فيه مشكلة الإنسان الخارق. أشعر أنني أكثر انجذاباً إلى نيتشه من أي وقت سابق. وإن نيتشه هو المفكر الأخير بالنسبة للزمن الذي نعيش”.
وعن موقفه إزاء العنف والجنس اللذين يغزوان الشاشة يقول: “لم يعد الأمر يتعلق بالجنس بل بالبورنوغرافيا التي لم تعد تخضع حتى للرقابة. وهذه الأخيرة باتت تستشر ضدنا نحن، بحجة أننا نقدم أفلاماً ذات جمهور واسع. يسمحون بعرض المؤخرات ويقمعون الأفكار. ينتقمون من الذين لديهم أفكار يريدون إبلاغها. يشجعون المبتدئين، غير أن 70% من الأفلام التي يشجعونهم على إخراجها لا ترى النور.
لقد ذكرت إعجابي بنيتشه؛ وفي هذا المجال أود الإشارة إلى حبه القوي للمسيح، وهو ما جعله يقول إن المسيحية ماتت على الصليب”.
أفلام الموضة..
وعن تعريفه للسينما يقول: “أسوأ ما هنالك هو محاولة إنجاز أفلام متماشية مع الموضة. إذْ، كما يقول كوكتو: “أن تكون متطابقاً مع الرائج يعني أنك متأخر”. أنا أدافع عن المقدس، عما من شأنه أن يجعل الشباب يبتعدون عن المحرقة، عن المخدرات. كما إنني أستنكر أفلاماً مثل More و”دروب كاتمندو” التي تغذي قناعات زائفة لدى الشباب.
ثمة اكتفاء بإخراج شهادات، والابتعاد عن الجوهري. وفي هذا مخاطر حقيقية. وفي مواجهة الأزمة يجري اتخاذ قرارات دكتاتورية، مع كل ما فيها من مخاطر في مجالات الحياة، الأخرى. والمشكلة هي ذاتها على صعيد الدين. فلا تتم إلا معالجة التفاصيل مع ترك ما هو أساسي. إنها إحدى آفات عصرنا. وهذا ما يفسر الانهيارات المتتالية”.
وعن تعريفه للمخرج يقول: “دور المخرج هو الربط بين كل الشخصيات وخلق جو مناسب بين الممثلين. وكل فيلم يتضمن مواجهة بين طبائع مختلفة. ومهنة المخرج أن يشجع الاختلاف. وهذا أمر صعب لأن بعض الممثلين لا يطيقون غيرهم. اذكر مثلاً أنني أخرجت شريطاً مع غابان وروبير ستاك، وهما شخصيتان متناقضتان. ومن المعروف أن جان غابان لا يذهب بانتظام إلى قاعات السينما، ولكنه يشاهد التلفزيون، فقال لي بودّ: “تعرف، أنه ليس ممثلاً كبيراً. ولا يستطيع تنويع تعبيراته” غير أنني مهدت له المناخ المناسب مع روبير ستاك. وهكذا اكتشف غابان قدرات ستاك الحقيقة”.
وعن التعاون مع كتّاب السيناريو يقول: “في شريط “هذه النحيلة ليست مجنونة” تعاملت مع السيناريست دانيال بولانجيه. غير أن العمل بهذه الطريقة لا يكون متوافراً دائماً. كثيراً ما أضع السيناريو وحدي في صياغة أولية، ثم أعود إليه بمشاركة أحدهم. عملت مع بولانجيه، كما عملت مع كوكتو. أعطي فكرة عن الحوار بينما يعطيان فكرة عن الصورة. أما مع أوديار فقد كان الأمر مختلفاً. كان ينجز كل شيء وحده. لأنه يجيد الرؤية والسماع في آن؛ فيضع الحوار ويرى الصورة. وبوجه عام يعمل كتّاب السيناريو وواضعو الحوار وفق طريقة المخرج وأسلوبه. أنا شخصياً أفضل ترك الحرية والمسؤولية لكل واحد على حدة”.
ويجيب عن سؤال منذ انطلاق فكرة الشريط وصولاً إلى النسخة النهائية منه، هل توجد لحظات نشاط إبداعي خلاق أفضل من غيرها:”أعتقد أن أصعب مرحلة هي وقت كتابة الموضوع، إذْ ينبغي، طبعاً أن يتم إخراجه كما جرت كتابته. شخصياً أعتبر الإخراج تجربة قاسية تتطلب الكثير من الاستعداد، ولاسيما جسدياً. أما الأهوال الداخلية فيمكن للمرء أن يعرفها جيداً، خصوصاً وقت الإبداع، والكتابة، وصناعة الفيلم. أما ما يلي ذلك فهو سهل مهما كانت التحويرات”.
وعن وجود محبة خاصة للبعض من أفلامه دون غيرها يقول: “تحديداً تلك الأفلام التي سمحت لي بالذهاب إلى نقطة أبعد، وتلك التي أعطتني رضاً داخلياً أكثر من غيرها. لا شك أن عملية التفضيل تتم انطلاقاً من موضوعات الأفلام. ويصعب على المخرج أن ينكر بعض أفلامه. يبقى أن أفضل أفلامي هي تلك التي حددت تطوري. ذكرت “الرب يحتاج إلى البشر”، ويمكنني ذكر “كلاب ضائعة بلا أطواق” وربما بعض أفلامي المتمحورة حول الجمال الشكلي مثل “أميرة كليف”. غير أنني استمتعت كثيراً أثناء إخراج “ميغريه ينصب فخاً” وهو واحد من خمسين شريطاً حول شخصية “ميغريه”.
يمكنني أيضاً ذكر “السمفونية الرعوية” طبعاً، و”العودة الأبدية”. أما الآن وقد انتهيت منهما، ولم يحققا النجاح المنشود، فيمكنني الاعتراف بأن “ثقلهما” قد تجاوز جدواهما. ويبقى دائماً شريط “الرب يحتاج إلى البشر”. وأكرر الآن أنني أقرب إلى نيتشة مني إلى أي فيلم من أفلامي. أجمل أفلامي هي تلك التي أرغب في إخراجها، وآمل أن أخرجها”.
شهادة السينما..
وعن ارتياده السينما كمتفرج يقول: “أرتادها كثيراً. أختار الأفلام وفق الأصداء التي تثيرها. اذهب لمشاهدة أفلام تعلمني شيئاً جديداً. إنها أفلام يمكن أن تتضمن العنف والجنس. أنا شديد الوعي بهذه الظواهر. ولابد أن يكون لها مجال في السينما بوصفها عملاً فنياً، لا باعتبارها شهادة على العصر. كثيراً ما يقال “على السينما أن تقدم شهادة” ولكن، إذا كانت السينما شهادة فهي عمل فني أيضاً. في شريط “بوني وكلايد” وجدت الأساطير القديمة. وما لست أفهمه هو ذلك الاستعراض المجاني للعنف من أجل العنف، وللجنس المبتذل، والجريمة، والدم المسكوب في كل مناسبة.
كل ذلك يخيفني. ما دام المتفرج يخاطب ملايين الناس فهو يتحمل مسؤولية كبيرة. فلماذا يجري إحباط الناس منهجياً دون ترك بارقة أمل؟ الناس يقبلون على الفيلم انطلاقاً من الإشهار والنقد. أنا لا أدعو إلى الحؤول دون كل أشكال التعبير، غير أن هناك أعمالاً مخزية. وتوجد كذلك أفلام تدل على رهافة الذوق مثل “السمندل” و” قيصر وروزالي”. لا بد من جذب الجمهور إلى مثل هذه الأفلام. وهو جمهور نحتاج إليه. نحن نحتاج إلى النجاح. وعلاقتنا تشبه علاقة سيزيف بصخرته”.
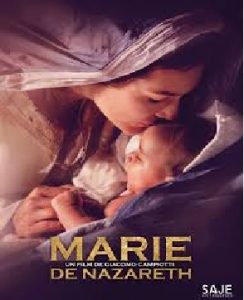
وعن السينما الفرنسية الشابة: “لم يعد الفرق واضحاً. ولا يمكن اعتبار أفلام إيريك روهمر تنتمي إلى السينما الشابة. ولا شك أن هناك ما يميز بعض الأفلام مثل “ركبة كلير” و”الحب في الظهيرة” لكن ما هي السينما الشابة حالياً؟ الموجة القديمة التي دامت؟ إن شريط “ماكدّام كاوبوي” من إخراج إنسان عمره اليوم خمسون عاماً!
ما أود قوله هو أن نجاح أول شريط لمخرج شاب يتطلب انتظار ما سيقدمه لاحقاً. المهم هو السياق. وهذا السياق لا يظهر إلا انطلاقاً من الشريط الثاني. في أغلب الأحيان يعود المخرج الشاب، الذي تميز في فيلمه الأول، إلى التقليد أو يسقط في النزعات الجمالية. إنه مهرب يتكون من الصور الجميلة. غير أن الجمال ليس الهدف الجوهري للفيلم.
الصناديق ملأى بأفلام لن ترى النور. وهي أفلام تمولها الدولة في معظم الحالات. هذا وضع مأساوي، لان أصحاب تلك الأفلام توقفوا منذ الشريط الأول.
وعن النصائح التي يقدّمها للسينمائي الشاب يقول: “أسأله أولاً، عما يرغب، وما الحكاية التي يريد تقديمها، وكذلك، إن كان ملمّاً بالمهنة التي ينبغي تعلّمها باستمرار لأنها تتطور باستمرار. أسأله إن كان يدرك التقنية والتصوير والأفلام الموجبة والديكور والسيناريو. غير أن الشباب يشبهون مراهقين متسرعين في فَقْءِ حَبّ الشباب.
أجد لهم عذراً في مجال الروح العدوانية. لا يملكون إلا هذه الوسيلة لإثبات الذات والموهبة قبل البرهنة عليهما. الكاتب لا يحتاج إلى ذلك. إنه يجلس إلى أوراقه، يحبّرها، ثم يقدمها إلى ناشر. أما الفيلم فهو كيان، إنه شيء ما متطاير في الفضاء، ولا يدوم إلا فترة استغلاله، أي لمدة عام أو عام ونصف. في هذه الفترة الوجيزة يتمكن الفيلم من استرجاع الأموال التي استثمرها، أو يخسرها. وهذا ما يدفع بالشباب إلى تولي مهمة الإنتاج أيضاً.
كل من يُسمّون بـ “الموجة الجديدة” بدأوا بأموالهم الخاصة. وفي هذا المجال لا يمكن للمخرجين القدامى إلا أن يزعجوهم”.

