لا تزال العديد من الأوساط في الغرب تذعِن لكنيسة روما، رغم ما دبّ في نسيجها الاجتماعي من “انسلاخ مسيحي” مرفوقٍ بفتور ديني تحت وطأة موجات العلمَنة المتعددة. فالحجّ إلى روما، وتحديدا إلى حاضرة الفاتيكان، مازال دأبَ ساسة ومتنفذين كثيرين، رغم مزاعم العلمَنة والفصل بين السلطتين الدنيوية والدينية. ولم يسلم من التودد للكنيسة حتى عتاة العلمانية والشيوعية. فمنذ فترة، انسحب رئيس “حزب إعادة التأسيس الشيوعي” الإيطالي ورئيس مجلس الشيوخ الأسبق، فاوستو برتينوتي، في خلوة روحية مع رهبان بشبه جزيرة مونتي آثوس باليونان، المخصّصة للذّكور حصرا والمحرّمة على الإناث، بشرا وطيرا وحيوانا، تعبيرا عن ولائه لضمير أوروبا الديني.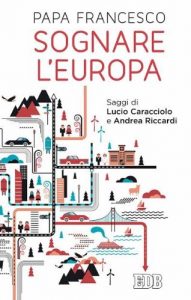
وفي هذا السياق تقتضي طبيعة العلاقة الوثيقة التي تربط الكنيسة الكاثوليكية بأوروبا، على وجه التحديد، متابعةً خاصة. نحاول من خلالها تناول فحوى كتاب “البابا فرنسيس والحلم الأوروبي” (120ص)، الذي صدر عن منشورات ديهونيان بمدينة بولونيا خلال العام الجاري، عبر ترجمة مقتطفات من أقوال مؤلّفَيْ الكتاب وعرضها. يجمع الكتاب في الأصل ثلاثة خطابات للبابا فرنسيس تتعلق بالشأن الأوروبي. أُلقي اثنان منهما على التوالي، في 25 نوفمبر 2014 في ستراسبورغ، في مقرّي البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، والخطاب الثالث أُلقي في السادس من مايو 2016 بمناسبة تلقّي البابا جائزة شارلمان العالمية. تولّى تلك الخطابات بالتعليق والشرح الخبيرُ السياسي لوتشو كاراتشولو، مؤسس ومدير مجلة “ليمس” الجيوسياسية، الذي يُعدّ من كبار المحللين للشأن السياسي؛ والمؤرخ الإيطالي المعاصر الأستاذ أندريا ريكاردي، رئيس جمعية سانت إيجيديو بروما أقوى المنظمات الدينية تأثيرا، والدائرة في فلك الكنيسة الكاثوليكية.
في تناوله لشخص فرنسيس برغوليو في الكتاب المذكور، يقول لوتشو كاراتشولو: ينظر البابا إلى أوروبا بعينيْ الرحالة البرتغالي فرناندو ماجلان، أو بالأحرى بعينيْ المطلِّ من الأطراف المتشوّف إلى المركز. ولا شك أن تلك النظرة مفيدة، لأنها تلتقط ما لا يمكن أن يراه الماكث بالداخل. ذلك ما شرحه برغوليو في إحدى حواراته قائلا: “في الواقع نحن لا نتحرك في فضاءات نسيطر عليها بالكامل. ففي الوقت الذي ننأى فيه عن المركز ونبتعد قليلا نكتشف أمورا مغايرة، وحين ننظر إلى المركز، إلى المعطيات الجديدة التي اكتشفناها، من مواقع جديدة، من الأطراف، نرى الواقع بشكل مغاير. وعلى سبيل المثال: كان النظر إلى أوروبا من مدريد خلال القرن السادس عشر أمرا مغايرا، لكن ماجلان حين انتهى به المطاف إلى أقاصي القارة الأمريكية، شاهدَ أوروبا من نقطة نائية بلغها، أدرك حينها شيئا آخر. فالواقع نراه بشكل أفضل من الأطراف لا من المركز”. مع ذلك لم يتسنّ لماجلان الدخول مجددا إلى أوروبا، فقد قضى نحبه في الفلبين. ولولا الرحالة أنطونيو بيغافيتا لفاتنا كثير من أخباره. في حين دُعي البابا برغوليو للالتحاق بأوروبا من أطراف العالم، من الأرجنتين خدمةً للكنيسة في المركز، في روما. هذا المركز الواقع في وسط إيطاليا، الواقعة بدورها في جنوب أوروبا، إيطاليا التي تصل أوروبا بالمتوسط والتي تنفي ذلك الارتباط في الآن.
وتبعا للسياق الأورومتوسطي الحالي، تلوح موجات الهجرة المتدفقة عبر المتوسط اليوم مصيريةً في تشكيل رؤية أوروبية للبابا فرنسيس. وبوصفه أرجنتينيا، فهو يفتقر، كما نقدّر، إلى ارتباط عاطفي بالقارة العتيقة على غرار أسلافه من البابوات. ونقصد هنا البافاري، البابا الأسبق بندكتوس السادس عشر وكذلك البولندي البابا يوحنا بولس الثاني الذي عاش لحظات حرجة من حياته جراء انقسام أوروبا بين معسكرين، ما دفعه إلى الحرص ضمن استراتيجياته لإعادة أوروبا إلى “وضع التنفس برئتين” -الشرق والغرب، ليس بمعناه الروحي فحسب، بل بمعناه الجيوسياسي أيضا-، وهو هدف واقعي وجدير بالمتابعة. وعلى خلاف البابا فرنسيس، جاء راتسينغر و وُوجتيلا من داخل البيت الأوروبي، وَفدَ كلاهما من المركز، من وسط أوروبا فعلاً بعد أن أنهكتها حربان عالميتان ونخرتها ثالثة باردة لاحقا. وليست مشكلة البابا برغوليو في توحيد أوروبا ضمن مشروع سلام، بل في إيقاظ الروح فيها. إذ يتابع حضورُ الكنيسة في أوروبا من منظور البابا فرنسيس هذا المفهومَ بالضبط، ألا وهو نفخ الروح في مشروع فقدتْه أوروبا، أو لعلها لم تملكه البتة.
وسواء وُجد ذلك المشروع أو انتفى، فإن أوروبا من منظور البابا فرنسيس ليست شيئاً بل صيرورة. فيها زمن وليس فضاء، لأن الفضاء يقتضي سيطرة. والسؤال المطروح: ما الذي كانت عليه أوروبا تاريخيا، إن لم تكن فضاء، انطلقت منه قوى كبرى وأخرى أقلّ بأسا في غزو العالم؟ ها هي أوروبا تجد نفسها تجابه موجةً ارتداديةً لتلك الأعمال الاستعمارية -في شكل لاجئين ومهجَّرين وافدين من أراضٍ تمزقها الحروب وقد سبق للقوات الأوروبية أن احتلتها- التي لا تجد بالتأكيد ترحيبا من قِبل بابا أرجنتيني، وافد من مستعمَرة سابقة. تتلخص في هذا المأزق مأساتنا الجيوسياسية والروحية كأوروبيين اليوم. وبالفعل من مزايا أن يكون المرء من الأطراف، أن يعي بشكل أفضل من مواليد أوروبا الجذورَ الديمغرافية والبيولوجية لعوامل تصحّر ما كان يمثّل الحديقة الكبرى للكنيسة.
وبالفعل نحن قارةٌ من الطاعنين في السن، أطفالنا قلّة. قارة بلغ بها المطاف حدّ التساؤل: هل بوسعنا، حفاظا على رفاهنا، إعلاء الحواجز في وجوه المهاجرين؟ هل لنا أن نرفض احتضان القوى الشابة -بالطبع غرباء ليس من الهيّن دمجهم- خشية العدوى وخشية أن نفقد مزايا كثيرة؟ لكن بالخصوص: هل بإمكان قارة يعمرها الشيوخ أن تتجاسر على طرح أفكار جديدة؟ وفي خلاصة مقتضبة، وحدهم الشباب بوسعهم إنقاذ أوروبا بالنسبة إلى البابا برغوليو. ولن يتيسر ذلك إلا بعودة أوروبا إلى ألق الشباب وخلق مجتمع جديد متنوع. يتلخص الدرس الذي يقدّمه البابا فرنسيس في طرح مفاده أن هذا القسم من العالم لن يجد حيويته سوى بالانفتاح على باقي العالم. ولا سيما على العالم المتوسطي المجاور له. إنه الاحتواء أو الاندثار، لذلك ثمة حاجة إلى نظرة ماجلان حتى نعي على بيّنة الورطةَ التي وقعت فيها أوروبا والممتدّة إلى الأجيال اللاحقة.
***
من جانبه يقول أندريا ريكاردي في المؤلف المشترك: فرنسيس برغوليو هو أول بابا ليس أوروبيا، على امتداد ألفية بأكملها من تاريخ الكنيسة. فقد جاء العديد من البابوات، ولا سيما في القرون العشرة الأولى من العصر المسيحي، من المتوسط. في حين فرنسيس برغوليو فهو أول بابا وُلد وعاش خارج أوروبا، بعيدا عن المتوسط، برغم جذوره الأسرية -غير البعيدة- التي تجعله قريبا من إقليم بيمونته ومن إيطاليا. لم يتغاض فرنسيس برغوليو عن أوروبا، ولم ينظر إليها بوصفه أوروبيا: ذلك أن نظرته نظرة وافد، ولكن في الآن نفسه ليس غريبا عن القارة العتيقة. إذ يملك البابا فرنسيس نظرة سامية لأوروبا، تلك الشائعة في الثقافة الأرجنتينية. ولا يخفي البابا حسرته بشأن القارة التي ما عادت في مستوى تاريخها. إنه انشغال مبدئي. فقد فاقمت نهاية الإيديولوجيات، مع عدم توفر القدرة على الفكر والعمل، من حدّة الضياع.
وعلى النقيض من ذلك مثّلت الماركسية نظرة كبرى للعالم، تبلورت في الأوساط الأوروبية وجرى تصديرها إلى الخارج. ومنذ العام 1989 بدأنا نسير باتجاه حالة كمون لأوروبا داخل العالم، جراء تدهور دول كبرى على غرار فرنسا وبريطانيا، علاوة على الأزمة الإيطالية المتفاقمة؛ بل وبموجب أثر دول شرق أوروبا أيضا، التي افتقرت إلى نظرة استعمارية وعازها التطلع خارج المجال الأوروبي، عبر التاريخ، ناهيك عن غياب نظرة متركزة لديها في المجال الأوروبي. لقد أمست أوروبا عجوزا. تبدو وكأنها فقدت الرغبة في التواصل مع العالم، ولا تجد حافزا في المساهمة في تغييره. لقد انهارت الرؤى الكبرى، وبقي “التكنوقراط البيروقراطيون الموكلون بتسيير أمر مؤسساتها”. يقول البابا (وهو لا يغفل عن الاشتغال الآلي للمجموعة الأوروبية): يقود هذا الموقف الذي يمكن أن يبدو صائبا، إلى “عولمة اللامبالاة”. وهو المفهوم الذي أطلقه برغوليو من جزيرة لمبيدوزا في لقائه بالمهاجرين الوافدين. إذ يربط خطٌّ متناسقٌ الخيارات السياسية الأوروبية بالسلوكات الفردية لمواطني ذلك المجال (الشخص-المونادا بمفهوم لايبنتز “دائما أكثر لامبالاة بالمونادات الأخرى الدائرة حوله”). بهذا المعنى ثمة مسافة جلية بين المعطى الأوروبي ورؤية بابا روما. وعبر القرن الماضي، وقد غادرنا منذ أمد قريب، لم تعدم الصراعات بين البلدان الأوروبية والكنيسة الكاثوليكية.
ينبغي الحديث اليوم عن التنوع، بما يفوق التطرّق إلى الصراعات. وبالفعل، في الوقت الذي تنكمش فيه أوروبا، يواصل الكرسي الرسولي طرق مسار كوني، ليس من خلال إضفاء طابع عالمي على أجهزته فحسب، ولكن بالانفتاح على مجالات عدة في العالم. وقد ترافق الدفع العالمي للبابا في القرن العشرين ليس بالانبساط الأوروبي فحسب؛ بل بانضمام العديد من الأوروبيين إلى جحافل المبشِّرين عبر العالم، دعماً لعمل الكنيسة على جميع الأصعدة، مشاركة لأفعالها وتقاسما لرؤاها. فقد عزّز الكرسي الرسولي انفتاحه، لكن الأوروبيين وجدوا أنفسهم أقل بكثير أو لا شيء في هذا السياق. فالبابا يحثّ القارة لترتقي إلى مستوى تاريخها. ويملك فرنسيس رؤية مهمة بشأن الدور والإمكانيات الأوروبية، وبشأن الحاجة إلى أوروبا في العالم أيضا. فهو يدفع باتجاه انفتاح جديد. وبالنسبة إلى البابا فرنسيس ليست الجذور شيئا مفارقا أو أمرا لاتاريخيا، “فالجذور” تعني الذاكرة. وليس بوسع أوروبا أن تعي ذاتها وهي رهينة الحاضر، أو عرضة لسلسلة من العواطف.
ثمة ضرورة ملحّة “لبناء ذاكرة”، ولقراءة التاريخ بعمق. وبهذا المعنى لا يمكن اتخاذ خيارات كبرى، وانتهاج سياسات واقعية عبر القارة، دون العودة للثقافة التاريخية. مع ذلك أدارت السياسة الأوروبية ظهرَها، خلال العقود الأخيرة، لعلاقتها بالثقافة التاريخية؛ بل بالأحرى كشفت العديد من الخيارات الحديثة عن تنصل من ذاكرتها، وهو ما ولّد سلوكات اجتماعية منافية لعمقها الإنساني. نرى ذلك في أزمة الأطراف وفي وهن التصدي للإرهاب: أناس يتملّكهم الضياع، بدون ذاكرة، ليس فحسب يرتهنون للعواطف، بل ينقادون نحو أشكال مختلفة من الراديكاليات. والأمر ذاته ينطبق على بلدان بأسرها، فهي بدون ذاكرة، وأحيانا رهينة الشعبويات التي تستصرخ الجذورَ بشكل حماسي، وتطالب بإعلاء “الجدران”. ينبغي على المسيحيين أن يقفوا حائلا دون انطواء الضمير الغربي.


