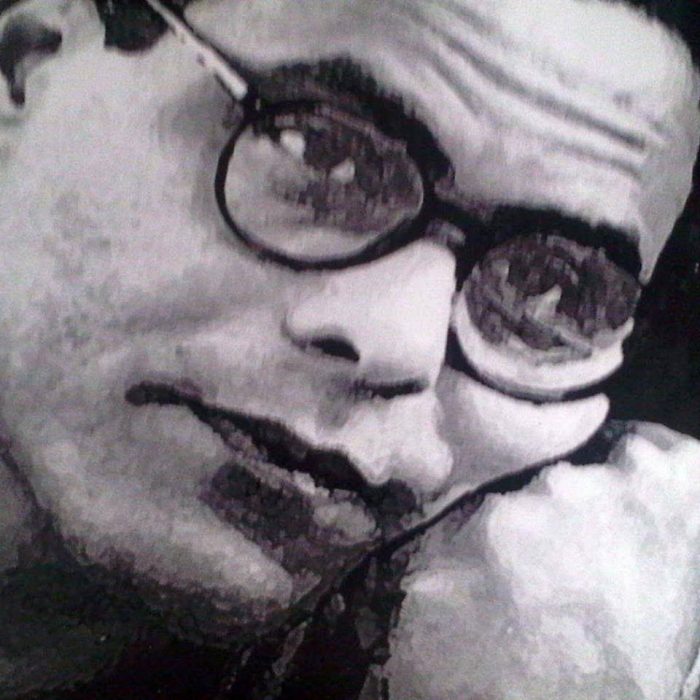خاص : كتب – محمد البسفي :
“العولمة”.. ذلك الاخطبوط الهلامي الواثق الذي بات يحوطنا بأذرعه الثقافية والاقتصادية وغيرها من عشرات الأذرع التي باتت تسيطر بنعومة وتتغلغل بإصرار قوي على كافة مناحي حياتنا اليومية كأبناء دول العالم النامي أو دول الجنوب – بلغة الأمس –، وأصبحت “العولمة” هي الأيدي الوحيدة التي تشكل لنا مجتمعنا الوطني بمقوماته الحضارية والتأريخية حتى ذائقته الفنية وتذوقه للمأكل والمشرب.. ورغم مئات الدراسات والأبحاث التي كتبت ومازالت تُدرس لفهم وفحص تأثيرات موج “العولمة” الكاسح لنا في دوماته وأعاصيره، أرتأت (كتابات) فتح ملف “مكافحة العولمة”.. وهو مجموعة من الحوارات مع زمرة من المتخصصيين والمثقفين، يدور النقاش خلالها على محورين أساسيين؛ أولهما “هل نستطيع ؟”، أما الثاني فسوف يبحث في: “كيف نستطيع ؟”..
قبل أن يلفظ القرن العشرين أنفاسه بعامين كاملين، أوردا الكاتبين “هانس بيترمارتين” و”هارالد شومان”، في مؤلفهما الهام (فخ العولمة.. الإعتداء على الديمقراطية والرفاهية)، الوصف الموحي الذي جاء به عملاق صناعة الإعلام ورئيس مجلس إدارة شركة والت دزني، “مايكل آيزنر” Michael Eisner، حينما قال: “تتميز وسائل التسلية الأميركية بالتنوع، وهي بهذا تتلاءم مع الإمكانات والخيارات وطرق التعبير الفردية المختلفة. وهذا هو في الواقع ما يرغب به الأفراد في كل مكان”. ويضيف تاجر هوليوود دونما إكتراث قائلاً: “وكنتيجة للحرية الواسعة المتاحة أمام كل من يريد الإبتكار، تتصف صناعة التسلية الأميركية بأصالة لا مثيل لها في العالم أبداً”.
ويرفض “بنجامين ر. باربير” Banjam R. Barber، مدير مركز والت وايتمان (Walt Whitman Center) في جامعة روتغيرز (Rutgers University) في ولاية نيو جيرسي، تفسير “آيزنر”، ويصف نظريته بتنوع ما تقدمه وسائل التسلية الأميركية؛ بـ”الكذب والبهتان”. فهذه الأسطورة تتناسى أمرين حاسمين: طريقة الإختيار وحرية الإنسان في تحديد ما هو بحاجة إليه فعلاً. …. وكيف يستطيع المرء أن يأخذ مأخذ الجد المقولة القائلة بأن السوق لا تقدم إلا ما يرغب به الأفراد، إذا ما أخذ بعين الإعتبار أن ميزانية صناعة الدعاية والإعلان قد بلغت 250 مليار دولار ؟.. وهل محطة البث التليفزيوني MTV أكثر من وسيلة دعاية وإعلان على مستوى العالم، وعلى مدار السنة للصناعة المهيمنة على سوق الموسيقى ؟”.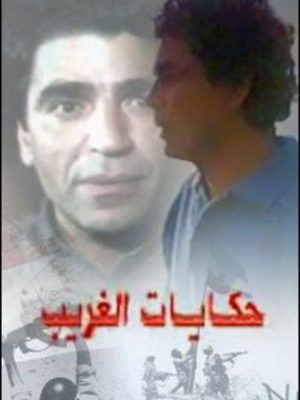
ربما لهذه الآليات التنفيذية التي تُسير عليها الولايات المتحدة – زعيمة عالم القطب الواحد – أسواق وقنوات التواصل الفكري والفني المعولم، صبغت ذائقتنا الفنية وبالتالي الثقافية بكل ألوان قيم الإستهلاك الباهتة والتي سرعت من حركة ترديها المتهاوية في فجوات التغريب والتجزر والطائفية بالتوازي مع تهميش التأصيل والبحث عن الذات الوطنية.. ذلك “التشريح” التحليلي الذي يقدمه لنا السيناريست والروائي والكاتب المصري المرموق، “محمد حلمي هلال”، الذي يتنوع إنتاجه الفكري والسينمائي بين الأعمال الوطنية الملحمية، فيلم (حكايات الغريب)، والمنتج الاجتماعي شبه الفلسفي السينمائي، أفلام (هيستريا) و(يا دنيا يا غرامي)، وغيرها من المنتجات التي مازالت تمثل الشخصية المصرية والعربية السينمائية المميزة…
ومع المحور الأول: “هل نستطيع ؟”.. يبدأ النقاش مع “حلمي هلال”:
(كتابات) : هل فرضت العولمة، سينمائياً، أنماط الصورة – فنياً – والشخصية – روائياً – التي تريدها الدول المتقدمة على مجتمعات الدول النامية ؟
- بالنسبة لنا نحن المصريين، أو العرب عموماً، فربما لضعف الإنتاج السينمائي المصري والعربي بشكل حاد، تسلم التليفزيون الراية فيما يتعلق بتلك القضية، بكامله في محاكاة لما يحدث في الغرب بصورة حرفية.. وبرز في الأعوام العشرين الماضية دور “أغنية الفيديو كليب” ودور الإعلان التجاري، واستطاعا عبر التكرار والإلحاح تغيير ما يمكن أن نسمية “الذائقة البصرية” للإنسان العربي.. “الفيديو كليب”، في طبعته العربية، يحيل كل شيء إلى سلعة معروضة للبيع، وتبقى المرأة أهم أدواته الإشهارية وأهم سلعة في الوقت ذاته، فالمرأة كجسد، وسيلة ناجعة لـ”جر” المشاهد لمشاهدة آخر “تخريجة” (سلعية) أو غنائية مصحوبة أو تمزج عن قصد بين الأغنية والإعلان، فترى الإعلانات المشحونة شحناً في خلفية الفيديو كليب، الفضاء المفضل لتأثير الإعلانات والتأثير على “ذائقة المشاهد”، أيضاً راح مخرج الفيديو كليب العربي يحاكي الغرب (أميركا) في استخدام “العري الجسدي” في اشكاله المجانية وغير المبررة لجلب أكبر عدد من العيون للصورة، والنتيجة اختزال المرأة إلى مجرد جسدٍ مغر، فضلاً عن فرض شكل معين للجسد باعتباره هو المقياس للجمال، حتى في ثقافات لم تكن تعتبر النحافة على سبيل المثال من مقومات الجمال، وهذا بدوره أدى إلى انتشار منتجات التخسيس وخفض الوزن وتفتيح البشرة وتغيير لون الجسم والشعر والعيون، “فشكلة” الناس، (تعبير مصري دارج يؤدي معنى تغيير هيئة الجسم واعادة تشكيله)، إن جاز التعبير، وإعادة صياغتهم عبر صور مدروسة بدقة. حتى في نوعية الأغاني تثير نتاجات أغنية الفيديو كليب العربية، تساؤلات عدة، تحتاح إلى الإجابة والتعليق عليها كونها تؤثر وبعمق في تشكيل ذائقة مغايرة وبديلة، فهل هذه النتاجات هي بشكل أو بآخر، مرآة حقيقية وواقعية للمجتمعات العربية ؟.. أم أنها مجرد وسيلة لإيصال مضامين فنية ورسائل مؤدلجة، توحي للوهلة الأولى، بمواصلة السفر والإرتحال في ايقاعات ومحيطات عصر العولمة، التي لا تحدها حدود، بغية مسخ تقاليد هذا الفن، وتخصيبها بروح جديدة تعبر عن عصر مختلف تماماً، بات فيه الصوت الإنساني مصنوعاً ومكملاً وثانوياً في صناعة الأغنية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.
تغيير “الذائقة البصرية” للمشاهد في الدول المتخلفة، (يقال عنها النامية)، أدى إلى تغيرات أخرى جذرية في صناعة الصورة، والحبكات في الدراما قد لا يتسع المجال لمناقشتها بالتفصيل.
(كتابات) : لماذا اعتمدت العولمة في تصدير قيمها الخاصة على مدارس التفكيكية والفوضوية فلسفياً.. وهل افادت تلك المدارس فنون الدولة الوطنية في مجتمعات العالم الثالث ؟
- أنهت الفلسفة المعاصرة بكل مدارسها، ليس فقط التفكيكية والفوضوية، وضع النسيان وحالة الحصار التي كانت تعاني منهما الصورة؛ وأعادت لها الاعتبار على الصعيد المعرفي والوجودي، أي من جهة القيمة والمعنى (قد يجوز السؤال هنا أي قيمة وأي معنى لدى مدارس واتجاهات بعينها).. المهم أن الصورة أصبحت تمثل أداة اتصال بين الإنسان ونفسه والعالم والآخر ومركز الثقل في الحياة اليومية، بحيث وسمت العصر الذي تعيش فيه بالكامل، فصار يسمى عصر الصورة.
وهذا ما أدركه منظرو العولمة باقتدار، فقد فهموا جيداً ما المقصود بالصورة، وما هي أنواعها والعناصر التي تتكون منها، وكيف تتم صناعة الصور، وما هي المواد والمسافات والفضائيات والأرضيات التي تستعملها، وكم من وظيفة تقوم بها في حياتنا المعاصرة، وما معنى “مجتمع المشهد” ؟.. وكيف يتراوح وجود الصورة بين الإيديولوجيا واليوتوبيا ؟.. وأي معنى تطلقه الصورة ؟.. هل تقول الحقيقة أم الكذب ؟.. ولماذا تعتبر الصورة ركناً أساسياً في الدعاية والإشهار ؟.. وهل تقرب بين الناس أم تعزل بينهم ؟.. وإلى أي مدى يمكن أن نثق في الصور ؟.. وما هي النظريات الفلسفية القديمة حول الصورة ؟.. ولماذا تأخرت دراسة الصورة على دراسة اللغة بهذا الشكل الملفت ؟.. وأي استعمال للصور في نظرية المعرفة ؟.. وبماذا يتميز الاستعمال التقني المعاصر للصور بعد الثورة الرقمية وتطور وسائل الإتصال ؟.. وما المقصود بالوسائطية ؟.. وأي سلطة للصورة ؟.. وما هي الأطراف التي توجد بينها ؟.. ومن يراقبها وما هي وجهتها ؟.. وهل تقدر الصورة على تغيير الواقع الذي تعكسه أو تسلط الضوء عليه ؟
(كتابات) : هل ألغت العولمة الثقافية عموماً والفنية خصوصاً ما يسمى الدولة الوطنية بكل قيمها وخصوصيتها ؟
- لا أتصور أنها نجحت في ذلك، ربما كانت تهدف إلى ما تقول، لكن الحاصل أن البلدان ذات الحضارات والثقافات العتيقة، هضمت العولمة وصهرتها في بوتقتها.. لم تتمكن العولمة مثلاً من القضاء على أنواع كثيرة من الأطعمة التي تحظى بموروث تاريخي وثقافي، وتدخل في صلب ثقافة بعض المجتمعات، كالمجتمع الياباني مثلاً، أو حتى المجتمع المصري.. يمكنك اليوم أن تجد محلات “كنتاكي” تغلق أبوابها وتفتح مشروعات لبيع الكشري والفول والطعمية، تلك الأطعمة لم تستطع شركات العولمة العملاقة القضاء عليها، لكنها تملك وتهيمن بشكل مطلق على ما يسمى بالفضاء الإليكتروني أو تملك بصورة إحتكارية شبكة الإنترنت، التي لازالت تسمح لها بفرض هيمنتها الإقتصادية والفنية، لكن هذا الوضع أشك كثيراً في استمراره مستقبلاً.. “الصين” تسعى اليوم إلى إنشاء شبكة إنترنت كاملة، وها هو المفكر الروسي “إليكسندر يوغين”، المعروف بعقل “بوتين” أو “بوتين راسبوتين”، يناقش في كتابه الهام (النظرية السياسية الرابعة) “بالإنكليزية”، ضرورة تفكيك شبكة الإنترنت الحالية وكسر إحتكارها، والقضاء على “محاكر” العولمة في هوليوود عن طريق فضحها وكشف فسادها من الداخل، ولعل الفضائح الجنسية للمنتج الهوليوودي الدائرة تلك الأيام، وإنتشار تأثيرها عبر العالم هو البدايات التي يجب الإلتفات إليها، فهي مجرد إرهاصات أولى لتحقيق كسر إحتكار العولمة وإعادة الإعتبار للثقافات الوطنية، وإنهاء خضوع العالم لقطب واحد يسعى لتسييد ثقافته على العالم كله.
وننتقل إلى المحور الثاني من نقاشنا: “كيف نستطيع ؟”..
(كتابات) : هل يعتبر “صراع الحضارات” وما تمخض عنه مما نحياه الآن من تضخم النعرات السلفية والتراجع الفكري إلى قيم ثيوقراطية أو شوفينية يمثل نتاج لتسارع حركة تلك العولمة الاخطبوطية ؟.. وإن كان الأمر كذلك فهل يمثل هذا الصراع الحضاري أول مسمار في نعش العولمة ؟
- اتفق مع هذا التصور.. وإن كنت لم أستوعب جيداً فكرة “تضخم النعرات السلفية وفي نفس الوقت التراجع لقيم ثيوقراطية أو شوفينية”، لم يحدث تراجع للقيم الثيوقراطية ولا الشوفينية بالعكس، تفاقم الأمر بعد 11 (أيلول) سبتمبر في أميركا، ولازال في طور التفاقم مع الحوادث التي تقع في أنحاء مختلفة من أوروبا، بات المشتبه الأول فيها (الإسلاميين كما نقول نحن)؛ والإسلام برمته كما يقولون هم.. مع ملاحظة التضخم الفكري للقيم الثيوقراطية أو الشوفينية، وليس تراجعها، أرى العالم يتجة يميناً بسرعة شديدة.. المزاج العام للمواطن الغربي أصبح ميالاً للمحافظة، متنازلاً عن أركان أساسية في المنجز الديموقراطي الذي ناضل المواطن الغربي طويلاً من أجل الحصول عليه.. لقد قبل الغربيون أو الأميركيون تحديداً بمراقبة تليفوناتهم بعد أحداث 11 (أيلول) سبتمبر، وقبلوا كل الإجراءات التعسفية التي تمارس ضدهم بحجة الإشتباه أو بحجة التأمين في المطارات وغيره، أما في أوروبا فإن معاداة المهاجرين من ثقافات أخرى، واستفحال حروب الكلام الدينية، وتبني فكرة “الإرهاب الإسلامي” أو فى صيغته المهذبة “الإسلاموفوبيا” وأرتفاع حدة النبرة العنصرية والعرقية، هو ما يعتبر ضرباً للعولمة في مقتل.. أرى احتداماً وتوتراً دينياً وعنصرياً وعرقياً وثقافياً ربما سيطيح بفكرة العولمة تماماً، خصوصاً بعد اتجاه روسيا إلى إنشاء مايسمى “اسيان يورو”، لإعادة جمهوريات الاتحاد السوفياتي القديم من حضانة ووصاية الحلف الأطلنطي والاتحاد الأوروبي إلى كيان جديد تقوده وتسيطر عليه روسيا تحت اسم الـ”اسيان يورو”.
العالم يتغير في إعتقادي !
(كتابات) : كيف يمكننا السيطرة أو تقليل سرعة هذه الخطوات المتسارعة للعولمة الثقافية وكذا نقلل من تأثيراتها على مجتمعاتنا ؟
- هذا السؤال ربما يدفعني إلى القول أنني أعترض على تسمية بلداننا بـ”النامية”، أفضل تسميتها بالدول “المتخلفة”.. فرغم الثراء الفاحش لبعض البلدان العربية إلا أنها لا تنمو أبداً، الثروات التي وقعت في يد الخليج كانت كافية جداً لتجعله أكبر وأكثر أهمية من اليابان (اقتصادياً) ـ أنا اقتربت من الستين عاماً ومنذ ولدت وأنا أسمع وأدرس في كتب التربية الوطنية أننا من الدول النامية، ورغم هذا فنحن لا ننمو أبداً، غياب التنمية هذا كارثة كبرى، لأن المطلوب هو الحفاظ علينا عند هذه الحالة، اعتماد اقتصادي مطلق على الغرب، عدم القدرة أو الشلل التنموي وبالتالي يظل التعليم متدنياً وسيئاً، وتبقى الثقافة على طول الخط تابعة وحركة الترجمة في أدنى مستوياتها، هل تعلم أن الكتب التي تترجمها إسبانيا كل عام تفوق ما قام العرب بترجمته عبر ثمانية قرون، إن بقينا على هذا الحل – وهو الغالب للاسف، فسوف نصبح ربما الكائنات الوحيدة التي نجحت العولمة في استهدافها واخضاعها.. باختصار نحن لا نملك أي مقومات أو خطط أو حتى نوايا لتقليل الخطوات المتسارعة للعولمة الثقافية وتقليل تأثيراتها على مجتمعاتنا، نحن لازلنا نقتدي بالموروثات القديمة فقط أو بالتراث الديني المحافظ الذي يبدو متهافتاً أمام العلم والتقدم المتسارع للغرب.
(كتابات) : المكون الثقافي لأي مجتمع هو المردود الموازي لقيمه ونظامه الاقتصادي.. بمعنى أن المجتمع المرتكز على القيم الإستهلاكية اقتصادياً يتوازى مع مرادف ثقافي إستهلاكي.. فكيف لنا الخروج من هذه الدائرة ؟
- ربما لا يسير الأمر بتلك الآلية فقط أو على نحو حتمي.. علينا أن نرصد أولاً أن الثقافة نفسها قد تغيرت أصلاً في كل المجتمعات، إستهلاكية وغير إستهلاكية، وربما في حوار آخر سأبدي أعتراضي على كوننا مجتمع إستهلاكي، إلى وصفنا بـ”مجتمع إحتياجي”، فنحن ننتمي إلى مجتمعات لا تستهلك ولكنها عاجزة عن أن تلبي حاجة نفسها، بمعنى أن الإحتياج لرغيف العيش هو إحتياج وجودي، وليس مجرد إستهلاك، ورغم هذا لا نعمل على توفيره، رغم منطقية هذ الأمر.. على كل الأحوال، يجب أن يهتم المرء اليوم في مجتمع المشهد أو “مجتمع الفرجة” بالتغيرات التي طرأت على ما هو ثقافي وما هو غير ذلك، وهل تراجع أهمية الكتاب بسبب قيم مجتمع إستهلاكي أم بفعالية ثقافة الصور، التي تحوز على المتلقي/المستهلك للثقافة، وذلك لقدرتها على النفاذ إلى رحم الواقع والإلمام بالتفاصيل والتقاط الجزئيات، ويجدر به أيضاً أن يؤمن بأن الرؤية بالعين، باتت تمنح الناس إمكانية الانتقال إلى الفعل ببراعة وسحر عجيبين وتساعدهم على الهبوط من العالم الافتراضي الرقمي إلى العالم الحقيقي والمتعين.

إن “الميكانزيم” الذي يشتغل وفقه تأثير الصور في عمليتي الإستهلاك والثقافة معاً، هو النماذج المتخيلة للتماهي، كما أن الصور الإعلانية المبثوثة في الفضائيات تتدخل في اختيار الجمهور لطريقته في اللباس والغذاء ونوعية المسكن الذي يقطنه والسيارة التي يستعملها، ومن ثم وجهة نظره في العالم وفي المعرفة بل والعلم أيضاً.
أن تطور تقنيات التصوير قد أدى إلى تطوير نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى العالم، “فكل تقنية جديدة تخلق ذاتاً جديدة عبر تحديد مواضيعها. فالصورة الفوتوغرافية غيرت من إدراكنا للفضاء، والسينما قد غيرت إدراكنا للزمن (عبر المونتاج ولصق الأزمنة في الصور البلور العزيزة على جيل دولوز)”. لكن إذا كانت الصورة هي مجرد وسيط رمزي يكتفي بالإشارة إلى الشيء المراد عرضه للفرجة، فإن ما يحدث هو أن الإنسان عموماً، حتى في المجتمعات المنتجة، قد بات هو ذلك الأبله الذي حين يشار له إلى القمر يحدق في الأصبع المشير. فكيف تمحو تقنية الشاشة كل شاعرية إنسانية وتضع مكانها ردود أفعال مبرمجة ؟
(كتابات) : لماذا اقترنت دائماً العولمة بقيم الحرية الاجتماعية/السياسية والديمقرطية ؟.. وإن كان ذلك مجرد خداع – كما أرى – فما السبيل إلى هدم تلك الخزعبلات مجتمعياً وسياسياً ؟
- اتفق معك تماماً.. قيم الحرية الاجتماعية/السياسية والديمقرطية انهارت في الغرب كله خلال أيام قليلة من أحداث 11 (أيلول) سبتمبر، مما يعني أنها قيم تعلي فقط من حرية الفرد في نفسه وجسده وليست فيما تتعلق بقيم الحرية الاجتماعية السياسية والديمقرطية.. فساد أنظمة الشرطة في مجتمع الغرب المتحضر ربما هي أكثر فظاعة من فسادها في دول العالم المتخلف، ربما حافظوا فقط على عدم المساس بالفرد من حيث كونه فرداً، ورغم هذا فإن حوادث قتل السود (الأفراد) الأميركيين على يد الشرطة الأميركية في أزدياد مثير للدهشة.. أفكر منذ فترة في أننا اصبحنا نعيش في عالم متهالك وقديم وفاسد إلى أبعد مدى، كل مؤسسات المجتمع الإنساني الدولية باتت فاسدة وعديمة النفع، وأقول هنا كلها دون إستثناء، ربما يحدث ما يجبر العالم قريباً على النظر من جديد في أمر نفسه، فعالم اليوم يرفض بإصرار على عدم رؤية صورته.
(كتابات) : ما هي مكونات الشخصية الوطنية الآن في خضم هذا البحر الهائج من منظومة العولمة ؟
- في السرديات القومية للتاريخ تعالج الأمم على أنها كيانات تأريخية لها هوية قومية واضحة، تقوم على اللغة والعادات والذاكرة التأريخية. وللأمة أرض”قومية” محددة بجلاء ولها بحكم “قوميتها” حق في اقامة دولة مستقلَّة، والتخلف عن تحقيق هذا الهدف يعزى إلى معوقات منها: قيادة ينقصها التصميم أو الأمانة، أو تدني الوعي القومي لدى الشعب نفسه، ومعوقات كثيرة أخرى.
يقول “غوستاف لوبون” هناك (سنن نفسية) تتطور بواسطتها الشخصية الوطنية لكل أمة، هذه السمات ربما لا تكون، نحن نلمس المكونات، فالعناد الإنكليزي هو الذي دفعهم إلى الإنجراف وراء ميولهم في الكشف والسيطرة على العالم، والبراعة الفرنسية ظهرت في التحول التأريخي الثوري من حقبة تأريخية مظلمة إلى عصر التنوير والحداثة التي انجبت الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية، والداينامية الأميركية تظهر في التعامل المنفعي مع الظاهرات العالمية والتحول البراغماتي للقيم، والإنضباط الألماني يظهر في النمو السريع في كل المجالات والنهوض الأسرع وراء كل نكسة مرت بها ألمانيا والشعب الألماني، وهكذا دواليك.
سأتوقف عند الجزء الأول من سؤالك للتأكيد على ما جاء به، (مكونات الشخصية الوطنية)، لكني لا أعرف بالتحديد كيف سيكون كلامي مقبولاً بشأن مكونات الشخصية القومية العربية وعلى رأسها مصر.